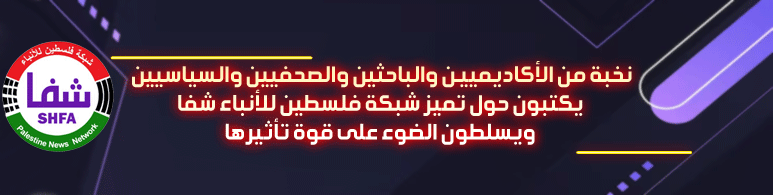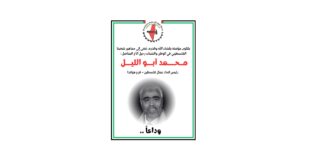من أزمة الشيكل في الخليل إلى مقاومة التبعية: بناء اقتصاد فلسطيني من القاعدة إلى القمة ، بقلم : غانية ملحيس
نحو تفكيك التبعية وبناء نموذج مقاوم
“الحل بالحل… وبعد الحل، ما الحل؟”، هكذا اختصر المهندس غسان جابر عمق الأزمة المالية التي تعصف بالخليل، والتي لم تعد محصورة في قرار إداري من سلطة النقد، بل تكشف عن اختلال أعمق في البنية الاقتصادية الفلسطينية، وتعيد تسليط الضوء على سؤال ظل مؤجلا لعقود:
ما هي طبيعة العلاقة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية؟
وكيف أصبح الاقتصاد الفلسطيني خاضعا، لا متشابكا فحسب، بل تابعا تماما لاقتصاد القوة المحتلة؟
لا يسعى هذا المقال إلى نقد القرار الإداري الخاطىء لسلطة النقد فقط، بل إلى مساءلة النموذج الاقتصادي بأسره، من جذوره السياسية إلى تجلياته اليومية.
من أوسلو إلى باريس: هندسة التبعية
لفهم أزمة السيولة الحالية المحتدمة في الخليل، لا يكفي الحديث فقط عن أخطاء بيروقراطية أو سوء إدارة من سلطة النقد – رغم خطورتها – بل لا بد من العودة إلى الجذر البنيوي الذي شق طريق هذه الأزمات: اتفاق باريس الاقتصادي، الإطار الاقتصادي والمالي والنقدي لاتفاق أوسلو.
كيف فكك الاتفاق الاقتصادي بنية الاقتصاد الفلسطيني؟
رغم أن الاتفاق السياسي/ أوسلو/ مع إسرائيل كان يفترض أن يكون مؤقتا ومحددا بخمس سنوات فقط ، وخاضعا للتفاوض بدءا من السنة الثالثة. إلا أن اتفاق باريس الاقتصادي رسخ التبعية كواقع دائم، صمم – بوعي أو تغافل – لتكريس التبعية والارتهان الاقتصادي لا الشراكة، ولإتمام فصل الاقتصاد الفلسطيني عن قاعدته الداخلية، وتعميق اندماجه في الاقتصاد الإسرائيلي، دون القدرة على التأثير أو المساومة.
هكذا تم استكمال تفكيك الروابط “الأمامية والخلفية” داخل الاقتصاد الفلسطيني وربطها عموديا بالاقتصاد الإسرائيلي:
1- الفصل بين الإنتاج والاستهلاك المحلي: تحت ذريعة الجدوى الاقتصادية. تم فك العلاقة بين الإنتاج الفلسطيني وربطه بالتصدير لإسرائيل وأسواقها التصديرية. وبين الطلب المحلي الفلسطيني وربطه بالواردات من إسرائيل والخارج عبرها. قبل أوسلو كانت الزراعة تشكل قرابة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، واليوم تقل عن 5%. بعد أوسلو تم استبدال الزراعة الفلسطينية الموجهة لتلبية الطلب المحلي الاستهلاكي والإنتاجي (القمح، البقوليات، الخضراوات، الأعلاف ومدخلات الصناعات الغذائية. وكانت هذه القطاعات قد تعززت، مع الزراعات المنزلية إبان الانتفاضة الأولى) واستبدلت بإنتاج الفراولة والورود لتصديرها للخارج عبر المنافذ التي تخضع للقرار الإسرائيلي فتحا أو إغلاقا، بدعوى القيمة المضافة الأعلى.
كما تم تجويف المناطق الصناعية الداخلية التي تنتج لتلبية الطلب المحلي، لحساب المناطق الصناعية الحدودية المشتركة مع إسرائيل،واستبدالها بالصناعات التصديرية/، وتم لاحقا تدمير المناطق الصناعية الحدودية كما في غزة، أو تعطيلها كما في جنين. وتم منح الوكالات التجارية وإغراق الأسواق الفلسطينية ببضائع إسرائيلية وصينية. في ظل عجز الصناعات الوطنية عن المنافسة بفعل الغلاف الجمركي الموحد، والمواصفات الفنية الإسرائيلية المصممة لحماية الإنتاج الإسرائيلي، والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير الفلسطيني.
2- الفصل بين المنتج والمستهلك الفلسطيني: عبر نشر الحواجز الداخلية وفرض القيود على حركة الاشخاص والسلع الفلسطينية، وإضعاف التجارة الداخلية بين القرية والمدينة، وبين الشمال والوسط والجنوب. ورفع كلفتها.
3- الفصل بين العمل وسوق العمل المحلية: مع الفروقات الكبيرة في الأجور بين سوق العمل الفلسطينية والإسرائيلية، وغياب سياسة تشغيل وطنية، واستمرار الاعتماد الواسع على العمالة الفلسطينية في الاقتصاد الإسرائيلي / إسرائيل والمستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967/ لحل مشكلة البطالة الهيكلية . وتحول السلطة إلى وسيط لتوزيع تصاريح العمل التي تمنحها إسرائيل للعمال على أساس فردي، وتتحكم بعددها ونوعها وفقا للأولويات والاحتياجات والضوابط الإسرائيلية.
في العام 1992، وقبل توقيع اتفاق أوسلو بلغ عدد العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية نحو 115,400 شخص، وتقلص بعد توقيع الاتفاق ليصل إلى 67,600 عامل عام 1995، ثم تضاعف إلى 134,700 عامل عام بنهاية العام 1999 – أي قبل اندلاع انتفاضة الأقصى – كانت العمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلية تمثل نحو 22.9% من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية. وفي نهاية الربع الأخير من عام 2000، تراجعت تلك النسبة بشكل كبير إلى 8.0% من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية، نتيجة الإغلاق الإسرائيلي والتقييدات على الحركة. هذه الإحصاءات تعكس مدى التبعية الاقتصادية الفلسطينية لسوق العمل الإسرائيلي. فالاعتماد على العمل داخل إسرائيل وفي المستوطنات لم يكن مجرد خيار فردي، بل نتاج سياسة اقتصادية متكاملة ربطت سوق العمل الفلسطينية بسوق استثنائية لا يسيطر عليه الفلسطينيون، ما زاد من حساسية الاقتصاد لأي قرارات إسرائيلية – بدءا من تصاريح العمل إلى الإغلاقات. وهذا النموذج دليل حي على كيفية تفكيك الروابط الاقتصادية المحلية وتطويع الاقتصاد الفلسطيني في سياق أوسلو واتفاق باريس. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل والمستوطنات بلغ نحو 193,000 عامل عام 2022، منهم 29,000 عامل كانوا يعملون داخل المستوطنات تحديدا. وحوالي 58.6٪ منهم يعملون بتصاريح قانونية، بينما يزاول البقية عملهم بشكل غير قانوني أو من دون تصاريح. ويمثل قطاع البناء والتشييد نحو 57.4٪ من مجموع العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات. وتظهر هذه البيانات بوضوح مدى تنامي الاعتماد الفلسطيني على سوق العمل الإسرائيلية بعد اتفاق أوسلو، وتعزيز واقع عدم التكافؤ بين “السيد” (إسرائيل) الذي يتحكم بقرارات منح أو سحب التصاريح، و” التابع” (السلطة الفلسطينية). وانعكاس ذلك سلبا على الاقتصاد المحلي، سواء من حيث الأجور أو شروط العمل أو اختلال الطلب والعرض داخل سوق العمل الفلسطينية. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (PCBS – تموز /يوليو /2025): إلى ان نحو 21,000 عامل فلسطيني قد عملوا داخل إسرائيل، إضافة إلى حوالي 15,000 عامل داخل المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية. أي حوالي 36,000 شخص بنهاية النصف الأول من عام 2025. وغالبيتهم يشغلون وظائف يومية في البناء والخدمات. ويشكل هذا الرقم تراجعا كبيرا مقارنة بما قبل طوفان الأقصى، وذلك نتيجة للسياسات الاسرائيلية باستبدال العمالة الفلسطينية بعمالة آسيوية، والإغلاقات الحدودية. ويتعرض العمال الفلسطينيون العاملون في الاقتصاد الإسرائيلي لاعتداءات في مواقع عملهم وأثناء الانتقال اليها.
وتشير بيانات الجهاز المركزي الفلسطيني الى ارتفاع نسبة البطالة الفلسطينية من 24% عام 2022 إلى 46.1% في الربع الرابع من عام 2023 وإلى أكثر من 50% في نهاية عام 2024. ويكشف ذلك هشاشة الاقتصاد الفلسطيني، الذي يعتمد بشكل كبير على الدخل المتأتي من العمل الفلسطيني في الاقتصاد الاسرائيلي. لكنه يشير في الوقت ذاته إلى الفرص المتاحة لبناء الاقتصاد الفلسطيني المقاوم – شرط توفر البدائل بتوسيع القاعدة الانتاجية والتشغيلية للاقتصاد الفلسطيني.
4 – الاعتماد على الجباية الإسرائيلية للرسوم الجمركية: بذريعة خفض تكلفة الجباية / وترتيبات المقاصة/ وفق الإقرارات التي تعتمدها اسرائيل وتسمح بالتسرب الضريبي.فضلا عن استخدام المقاصة كآلية للابتزاز والإخضاع السياسي.
5- انتهاج سياسات ضريبة تحابي الموسرين على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة: بتخفيض الضرائب المباشرة على الدخل بذريعة تشجيع الاستثمار، وزيادة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة / ضريبة القيمة المضافة / التي يتحملها المشترون بالتساوي بغض النظر عن اختلاف القدرات الشرائية للمستهلكين، ما يفاقم التفاوت الطبقي ويسهم في انتشار الفقر وزيادة حدته.
6- تشجيع تسييل الأصول الفلسطينية عبر إقرار قوانين الرهن العقاري: ليس فقط لتمويل الاستثمارات الانتاجية الزراعية والصناعية، وإنما أساسا لتسهيل تمويل الطلب على الشقق السكنية والسيارات والاستهلاك الترفي. علاوة عن ربط السداد بالرواتب ما رهن الفلسطينيين للقروض المصرفية، وحد من قدرتهم على التمرد والمعارضة عندما تتعرض مصالحهم للخطر الإسرائيلي او الاستبداد الحكومي.
7- عدم تقييد الاستثمار الخارجي للقطاع المصرفي الفلسطيني بحدود تفرضها المصلحة الوطنية واحتياجات الاقتصاد المحلي: ما سمح بتسرب جزء مهم من الموارد المالية الفلسطينية الشحيحة أصلا للخارج.
8- ترجيح الاعتماد الفلسطيني على العملة الاسرائيلية/ الشيكل/ في التداول الفلسطيني: الذي تتحكم إسرائيل بطباعته وبكمية العرض، رغم وجود عملات أخرى/ الدينار الأردني والدولار الأمريكي/.
9- انفراد السلطة الفلسطينية بالسياسات والقرارات الاقتصادية والمالية والنقدية: بمعزل عن الفاعلين الاقتصاديين الفلسطينيين/ القطاع الخاص ومؤسساته والمجتمع المدني.
إسرائيل ألغت أوسلو سياسيا وفعلته اقتصاديا
من المفارقات المرة أن إسرائيل ألغت عمليا اتفاق أوسلو السياسي منذ اجتياح مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني عام 2002 (عملية السور الواقي)، وأبقت السلطة على الفلسطينية الالتزامات الأحادية. وحافظت إسرائيل على الاتفاق الاقتصادي بالتوافق مع السلطة، رغم انها وظفته كأداة تحكم وهيمنة، تطبق منه ما يخدم مصالحها، وتجمد أو تخرق باقي البنود.
هذه ليست علاقات اقتصادية، بل علاقة استغلال بين سيد وتابع، تجعل من الاقتصاد الفلسطيني رهينة لتقلبات السياسة والمصالح الإسرائيلية، ولقرارات الحكومة والجيش وجهاز الشاباك، بل وأحيانا لمزاج ضابط عند معبر أو مستودع.
وهكذا، بات كل مسار اقتصادي – من الأرض إلى السوق – يمر عبر القنوات الإسرائيلية، الجمركية والمالية والنقدية، وفقد الفلسطينيون السيطرة على أدواتهم الاقتصادية. وتفاقم هذا الوضع بانفراد المؤسسات الرسمية الفلسطينية بالقرار الاقتصادي، وتغييب المساءلة، وتآكل النظام التمثيلي، وتغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية.
من أزمة الشيكل إلى مرآة التبعية البنيوية
في هذا السياق، لا تبدو أزمة تراكم الشيكل في الخليل سوى عرض من أعراض هذه التبعية البنيوية. فالقرار المنفرد الذي اتخذته سلطة النقد الفلسطينية بتقييد الإيداع النقدي في البنوك، بدل أن يعالج المشكلة، فاقمها، لأنه تعامل مع التجار الفلسطينيين كمتهمين، ومع السوق كتهديد، لا كركيزة من ركائز الصمود الاقتصادي. وهكذا لا تعود الأزمة المالية مجرد فشل في السيولة، بل نتيجة طبيعية لعقد سياسي-اقتصادي مزق الاقتصاد الوطني من داخله.
الحق يقال: المهندس غسان جابر قدم في مقاله المهم سلسلة من الحلول العاجلة الضرورية لتخفيف أثر القرار وإعادة بعض التوازن للدورة الاقتصادية، ومنها:
• تحسين آلية ترحيل فائض الشيكل إلى الخارج.
• تطوير أدوات دفع رقمية موثوقة بدل فرضها بالقوة.
• إشراك القطاع الخاص في صنع القرار المالي.
• ضمان سيولة عادلة تحفظ مكانة النقد ودوره.
هذه الخطوات – على أهميتها – تظلّ جزئية ومؤقتة، طالما أن النهج الفوقي في إدارة المال والاقتصاد هو السائد، وطالما أن السياسات الاقتصادية لا تبنى على رؤية وطنية للتحرر، بل على منطق إدارة الأزمة وتأجيل الانفجار.
لا يعني هذا الطرح تبرئة السلطة الفلسطينية، ولا إغفال دور القطاع الخاص في ترسيخ نموذج الاستهلاك التابع.
من المسكنات إلى استراتيجية المقاومة الاقتصادية
الخروج من أزمة الشيكل لا يكون بالعودة إلى الوضع السابق كما لو كان مثاليا، بل بكسر الحلقة المفرغة التي صنعها اتفاق أوسلو واتفاق باريس الاقتصادي الملغى في كل ما يتصل بالحقوق الفلسطينية:
- استعادة القرار الاقتصادي من يد الهيمنة الإسرائيلية.
- تحرير العلاقة بين المؤسسات المالية والمواطنين من منطق الشك والرقابة، نحو التشاركية والشفافية.
- إعادة بناء قاعدة إنتاج وطنية تستند إلى الأرض، والعمل، والانتاج والاكتفاء الذاتي ، لا إلى الاستيراد والعمل الموسمي.
- التحرر من أوهام الاقتصاد المنفصل عن السياسة، لأنه ليس هناك اقتصاد حر في ظل استعمار استيطاني إحلالي، يلتهم الأرض، والموارد، ويحاصر العقول.
نحو نموذج بديل: أدوات، أولويات، ومهام
قد يبدو الحديث عن بناء اقتصاد مقاوم في ظل الاحتلال أقرب إلى الطموح النظري، لكن الواقع الفلسطيني يؤكد أن أدوات الصمود الاقتصادي موجودة بالفعل، وقد جربت في ظروف أصعب، خصوصا في الانتفاضة الأولى. ومن هنا، فإن الخروج من أسر اتفاق باريس لا يتطلب فقط نزع التوقيع عنه، بل بناء مسارات بديلة تشكل اقتصادا تحرريا من القاعدة إلى القمة، ومن أبرز هذه المسارات:
1. إحياء الزراعة الموجهة لتلبية الاستهلاك المحلي، وإحياء الزراعات المنزلية والتكافلية: من خلال دعم الزراعة المعيشية التي تلبي الحاجات الغذائية الأساسية، خاصة في القرى والمناطق المهمشة، وتشجيع الزراعات العضوية والبذور البلدية، وتوفير الحوافز للتعاونيات الزراعية بدل شركات الاستيراد.
2. تأسيس شبكات تبادل محلية غير نقدية: تقوم على الثقة والمقايضة داخل المجتمعات المحلية، لتقليل الاعتماد على العملة والتخفيف من أثر الأزمات النقدية، خاصة في حالات التقييد كما جرى في أزمة الشيكل.
3. تعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني: عبر إنشاء تعاونيات إنتاج وخدمات محلية غير ربحية في مجالات الحرف اليدوية، وصناعة الأغذية، والنقل، والتعليم، بحيث تدار بأيدي المجتمعات ذاتها، وتخدم حاجاتها الفعلية.
4. إطلاق صناديق إقراض أهلية وتمويل جماعي محلي: تكون بديلا عن البنوك التجارية التي ترتهن الأفراد، وتوفر تمويلا صغيرا للمبادرات المجتمعية، والإنتاج المنزلي، ومشاريع النساء والشباب، وتدار بشفافية محلية.
- إعادة تشكيل الوعي الاستهلاكي الوطني: من خلال حملات تربوية وإعلامية واعية، تدفع نحو تقليل الاعتماد على المنتجات الإسرائيلية، وتشجع الشراء من المنتج المحلي، وتربط بين الاستهلاك والموقف السياسي.
- تفعيل دور البلديات والنقابات والغرف التجارية: كمؤسسات تمثيلية لها قدرة على إدارة اقتصاد محلي مستقل نسبيا عن سلطة المركز، وتستطيع بناء بدائل خلاقة من داخل المجتمع.
بهذه الأدوات، لا يعود الاقتصاد الفلسطيني مجرد رد فعل أو ضحية، بل يتحول إلى ميدان فعل يومي، وإحدى جبهات المقاومة الوطنية.
الاقتصاد كجبهة نضال: البديل يبدأ من القاعدة
مع تصاعد حرب الابادة الصهيونية المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، ومرور أكثر من 656 يوما على حرب تهدف إلى محو الجغرافيا والديموغرافيا والتاريخ والذاكرة والهوية الفلسطينية، صار التفكير في نموذج اقتصادي تحرري ضرورة وجودية، لا ترفا فكريا. الاقتصاد الفلسطيني، الذي فاقمت أوسلو وبروتوكول باريس تشوهاته البنيوية التي خلفها الاحتلال الطويل. فلم تبنى الاتفاقات السياسية والاقتصادية لتخدم قضية التحرر، بل لتبقى عاملا في تثبيط الإرادة.
وفي ظل فشل النموذج الإداري- السلطوي المرتبط بالمنح والمساعدات، يكتسب الحديث عن المقاومة الاقتصادية أهمية مضاعفة. لم تكن مقاومة الماء والكهرباء ممكنة أمس، واليوم لا تبنى الدولة من دون اقتصاد مستقل مقاوم.
- من التبعية إلى التحول الهيكلي: نموذج باريس تحت المجهر
منذ توقيع اتفاق أوسلو واتفاق باريس الاقتصادي عام 1994، أصبح الاقتصاد الفلسطيني أكثر تبعية وارتهانا للاقتصاد الإسرائيلي، يتحكم فيه الاحتلال في كل مفاصل الحياة الفلسطينية بموافقة رسمية فلسطينية في:
- المعابر والتجارة والعمل.
- الإصدار النقدي.
- فرض الهيمنة التقنية والفكرية.
- وأي محاولة للفصل بين الحقوق والاقتصاد تبددت بسرعة.
وبالتالي، فإن بديل اتفاقات أوسلو وباريس لن يكون بإعادة التفاوض حولهما ، بل ببناء تصوير تحرري جديد للاقتصاد الفلسطيني، مبني على الإنتاج، والمجتمع، والسيادة.
- الاقتصاد كأداة مواجهة، لا أداة تصدير وهمي
في نموذج أوسلو وباريس، تحول السلام من مبدأ الارض مقابل السلام إلى منطق “السلام الاقتصادي” الذي يقايض الحقوق الوطنية بالاحتياجات المعيشية، ويستبدل الحقوق السياسية بالرواتب، ويستغل القمع والابتزاز عبر السيطرة على الأجهزة المالية.
وللكسر، لا بد من:
- إحياء الاقتصاد الشعبي والتعاوني.
- الانتقال من سياسة مقاومة جزئية إلى سياسة الاستقلال الاقتصادي.
- توجيه الاقتصاد لإنتاج الخدمات الضرورية بدلا من الإنتاج للهيمنة الاستهلاكية.
3 . هل يمكن بناء اقتصاد مقاوم تحت الاحتلال؟
نعم، إن البناء لا ينتظر الدولة، بل يبدأ من المجتمع. فالانتفاضة الأولى، والتجارب المجتمعية في قطاع غزة، وشبكات التامين الاجتماعي، أظهرت أن الصمود الاقتصادي يبدأ حتى في ظروف الاحتلال والحصار. كمبادرة ‘بذار’ في الضفة، ومشاريع الاكتفاء الذاتي في غزة، وتجربة المقايضة في بعض بلدات نابلس خلال 2020.
النموذج المقاوم يبدأ من:
- الزراعة المعيشية والتعاونية.
- الحرف والإنتاج المحلي.
- التمويل الأهلي والتضامن المجتمعي.
- التبادل النقدي البديل.
- الرقمنة الوطنية للاستقلال الاقتصادي.
وهذا ليس بديلا للمقاومة، بل تابعتها الحاضنة.
4 . ملامح نموذج الاقتصاد المقاوم: من الممكنات إلى الضروريات
- السيادة الغذائية عبر دعم الزراعات المنزلية والتعاونية.
- الاقتصاد الاجتماعي التضامني بديلا عن الريع والنخب.
- التمويل المجتمعي البديل لتقليل اعتمادية الأفراد على البنوك.
- بث ثقافة الاستهلاك المقاوم تحررا من احتكار السوق.
- اقتصاد رقمي وطني يربط الشتات والمجتمع.
- البلديات والنقابات كمراكز مبادرة لا أدوات تنفيذية فقط.
- بناء البديل الاقتصادي يستدعي تفكيك اتفاق باريس، وتجديد العلاقات مع المجتمع، ووضع خطة اقتصادية مرتبطة: – بالسيادة الغذائية.
- باستقلال السياسات المالية والنقدية والتشغيلية.
- بالإنتاج المجتمعي.
- بالتوزيع العادل.
- بالشفافية والمساءلة.
هذا البرنامج ينبغي أن يكون جزءا من رؤية وطنية جديدة، تدفع باتجاه التحرر من الاحتلال، لا القبول بإدارته الميدانية كحالة دائمة.
- المقاومة الاقتصادية ليست رفاهية
قد ينظر إلى مقاومة الاقتصاد كفكر طوباوي في ظل الاحتلال، لكن الواقع الفلسطيني يثبت العكس، ففي قطاع غزة، والمدن المحتلة ومناطق ج، تقوم مبادرات زراعية وإنتاجية، كأنها محاولة لتجاوز الاحتلال من داخل الحصار.
من تحرير الأرض إلى تحرير أدوات الحياة فنحن امام خيارين :
- إما استمرار الدور التقني في خدمة وضع مختل.
- أو بداية مراجعة جادة للمفاهيم والسياسات.
الاقتصاد ليس أداة ضبط وترويض، بل خيار وطني، وساحة نضال، وأداة لتحرير الإنسان، لا لإخضاعه. وفي هذا السياق، فإن تحويل الاقتصاد الفلسطيني من أداة بيد الاحتلال إلى جبهة مقاومة، يبدأ من تفكيك التبعية، ويبنى على الوعي، والمشاركة، والإنتاج الذاتي، والعدالة الاجتماعية.
تبدأ معركة الاستقلال الاقتصادي من المجتمع، لا من قاعات التفاوض.
وفي زمن الإبادة، تصبح الزراعة، والمقاطعة، والاكتفاء الذاتي، والتضامن مقاومة. وفي زمن الانهيار، يصبح الاقتصاد المقاوم ليس وسيلة للصمود المقاوم فحسب، بل طريقة للبقاء بكرامة.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .