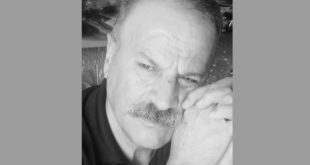طلاسم.. لست أدري: إيليا أبو ماضي وشظايا الحقيقة ، بقلم : بلقيس عثامنه
النفوس الحالمة تفقد جزءا من ذاتها في رحلاتها إلى الحرية، رحلة تحقيق الذات وكسر القيود التي تمثل، أيضًا، عقبة يغفلها الإنسان؛ لأن شرخا يوقظ شعورا داخليا لديه بالاغتراب والضياع وفقدان البوصلة، وهذا ديدن شعراء المهجر، على رأسهم فيلسوفهم إيليا أبو ماضي، وبرهان هذا قصيدة الطلاسم.
تبدأ القصيدة بالتيه والضياع الذي يعيشه الشاعر، فمنذ العتبة الأولى العنوان “الطلاسم” إشارة إلى شيء غامض غير مفهوم، قطع مركبة بغية تحقق رغبة بعينها، ضبابية ربما!؛ فالطلاسم طريقة روحانية لولوج العالم الغيبي، من هنا تبدأ رحلة البحث عن الذات المتشككة.
الحيرة تعود لتتحقق مع عتبات القصيدة الأول “جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت” ومن هذه اللحظة تبدأ التساؤلات المكثفة التي تمثل مركز روح الشاعر وأسلوبه في فهم الحياة، إنه الشك والتأمل “أأنا سائر في الدرب أم الدرب يسير
أم كلانا واقف والدهر يجري”
يظهر المقطع عمقا فلسفيا طاغيا، وحالة من التيه وعدم اليقين في الدرب المقطوع في الرحلة التي خاضها ليحقق ذاته، فالإنسان يذهب للمجهول في طريقه إلى العمق “أتراني قبلما أصبحت إنسانا سويا
أتراني كنت محوا أم تراني كنت شيئا
ألهذا اللغو حل أم سيبقى أبديا
لست أدري!”
الشاعر انتقل في رحلة نحو أمريكا الشمالية رفضا لواقع وطنه لبنان، حالة القمع والألم وفقدان القيمة، والآن في بلد يحترم إنسانية الإنسان هل أصبح سويا؟ هل تتحقق قيمة الإنسان بناءً على البلد الذي يقطن فيه؟ أم تتحقق قيمته بذاته ولذاته ولحقيقته الأزلية؟ أم أن القشور هي زخارف تعطى القيمة.
ثم ينتقل إلى فضاء مقطوعة “البحر” ليفتتحها بأسئلة وجودية فلسفية “قد سألت البحر يومًا هل أنا يا بحر منكا؟
هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنكا؟
أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟
ضحكت أمواجه مني وقالت:
لست أدري!”
وتدور المقطوعة كلها حول العلاقة الجدلية بين البحر والكون، هل للبحر فضل على الكون؟ لم يفكر أحدنا يومًا، وها هو الشاعر يلقي ظلال فلسفته على البحر، ويذكر مناقب البحر، قوته وغموضه واتساعه، خيره الجزيل وعطاءه المستمر دون حد، لكن، هل من شكر لهذا العطاء؟ أو عرفان لهذا الجميل؟
وهذا يعكس نفسية الشاعر وشعوره بنكران الجميل ونسيان المناقب، إذ قرن نفسه بالبحر “إنني، يا بحر، بحر شاطئاه شاطئاكا” وهنا يسقط الشاعر فضل البحر، وعطاءه ولؤلؤه القابع في الأعماق، على نفسه ليكون بحرًا حزينًا فاقدًا لمعرفته بمصيره “لا تسلني ما غد، ما أمس؟… إني…
لست أدري!” إنه في حالة من الضياع والتشتت؛ فشتات المنفى والابتعاد عن الأرض والأهل، ورغم كل تلك التضحيات التي قدمها، وكل ما كتبه سعيًا للتغير، وأبعاده النفسية كلها التي تشعره بأنه ما زال يسير إلى مجهول، فحالة التشظي تزداد عمقًا كلما ازدادت القصيدة عمقًا، من الجدير بالذكر أنه ذكر في هذه المقطوعة عبارة “لست أدري” اثنا عشرة مرة، وهذه دلالة سيميائية تشير بوضوح إلى حالة الضياع والتشظي التي يطرحها معبرًا عن ذاته.
وينتقل من البحر العميق إلى “الدير” ليفتتح المقطع بـ”قيل في الدير قوم أدركوا سرَّ الحياة
غير أنّي لم أجد غير عقول آسنات
وقلوب بليت فيها المنى فهي رفات
ما أنا أعمى فهل غيري أعمى؟
لست أدري!”
تحضر البصيرة الإنسان عند ارتقاء فكره عن السفاسف، عند اتساع الرؤيا وقراءة الواقع بطريقة تأملية تنأى عن التقليدية؛ فيكتشف الحقيقة، في مقطوعة تحمل دلالة اتساع الرقعة بين البصيرة ومنطق رجال الدين الذين يستغلون مواقعهم ويحاولون تزييف الفلسفة الدينية، وهذه المفارقة؛ فكل من رجل الدين والمعبد يحمل إشارة الاقتراب من سر الوجود ويستشعرون الله، لكن، أُغفِلت العقول وتم التلاعب بالقلوب فأصبح منبر الدين صدّاحًا بالتضليل والكراهية “أيها الراهب إن العار في هذا الفرار”، والناس في غفلة يسيرون، “أنت جان أي جان، قاتل في غير ثار” وضحية الجاني بريئة وهنا الضحايا مسلوبوا القوة والقدرة على الفعل، ويكمل الشاعر حيرة “فلست أدري!” التي تكررت، في هذه المقطوعة، تسع مرات تعجبًا من أمر الإنسان فأقرب الطرق إلى الله أبعدها عنه، وهم، العابدون، في غفلة، فتبرز قدرة الشاعر على كشف الستار وإظهار الزيف، فيتعمق شعور الحزن وتظهر الذات الجماعية لديه، وشعوره الإنساني بالأسى لخديعة المعبد!
في رحلة الطلاسم، رحلة البحث في الذات واكتشاف الحقيقة الكامنة خلف الأكاذيب الكبرى، ينتقل الشاعر من البحر إلى الدير ثم “بين القبور” فيقول “انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان
وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان
والتقى العاشق والقالي فما يفترقان
أفبذا منتهى العدل؟ فقالت…
لست أدري!”
نهاية كل تجبر وطغيان وكره وهيام واحدة، القبر، حيث يتساوى الناسك العابد والجاحد، وهذا بعد فلسفي ورسالة ضمنية، دعوة للتأمل في نهاية كل أمر، وكل إنسان، إنها القبر، فهل تستحق الحياة كل عناء من كذب وتزييف وكره؟ إنها رحلة قصيرة، لذا على الإنسان أن يبحث عن غاية وجوده؛ فالموت ملاحق الجميع، والفناء هو الحقيقة، وهذه النتيجة خلاصة تأملات عميقة في حال لبنان والشرق، والصراع مع أبناء الجلدة والأعداء، أيضًا، فكل هذا الصراع زائف نهايته الحتمية إلى زوال، والمفارقة اعتبار الشاعر الموت سلامًا؛ لأن السلام لا مكان له على هذه الأرض!
يرتكز الشاعر، في طلاسمه، على الأسئلة المفتوحة التي تتيح الآفاق التأملية أمام القارئ، وتحثه على السؤال، وينتهي في هذه المقطوعة على تسعة “لست أدري”، هذا التكرار السيميائي الذي يؤكد حيرته، واللافت للنظر أن اتفاق عدد “لست أدري” مع مقطوعة “الدير” يمثل غاية، قصد إليها الشاعر، فالحياة والموت وجهان لعملة واحدة، والتكرار المتوازي هنا إشارة لأن الإيمان الحقيقي وجب صدق الإيمان بالموت والجزاء، وبالتالي حالة السلام والاستقرار التي من المفترض أن تحل على الأرواح فوق الأرض؛ لأن تحتها لا يعرف فارقًا من فروقات الغشاء.
ويواصل الشاعر تجواله فينتقل من “بين المقابر” إلى مقطع “القصر والكوخ” والتي، يعتقد القارئ، بعقد مقارنة فيها بين القصر والكوخ، بين الغني والفقير، فهل القصور تُخلّد بانيها؟ وهل الكوخ ينقصه ما في القصر؟ إن السكينة سكينة الروح وبالتالي يتساوى القصر المشيد مع الكوخ الذليل، فالضجيج والصخب للروح، ولا قصر يشتري الراحة، فيظهر زهد الشاعر في الحياة ومفاتنها، فيقيس حياة الغني بالفقير، وحياة القوي بالضعيف، وإذ حياة إلا مع التساؤلات واليقين:” لم أجد في القصر شيئا ليس في الكوخ المهين
أنا في هذا وهذا عبد شك ويقين
وسجين الخالدين اللّيل والصّبح المبين
هل أنا في القصر أم في الكوخ أرقى؟
لست أدري!”
تقع مقطوعة “القصر والكوخ” القصيرة، نسبيًا، على ستة تكرارات، لـ “لست أدري!” وهي مقطوعة مكثفة تقدم الغاية منها دون عناء وتمثل العمق والكثافة، وتشير إلى حيرة الشاعر، ويواصل الرحلة منتقلًا إلى “الفكر” يعبر الشاعر، في هذه المقطوعة، عن تجربة روحية عميقة ومباغتة، تمثلت في فكرة أو تجلٍ غامض ظهر فجأة في أعماقه ثم اختفى دون إنذار، ما ولد لديه حالة من الحيرة والدهشة، إذ يتنقل بين صور متعددة: الطيف، البرق، الطير، الموجة؛ ليعبر عن زوال هذه اللحظة وتلاشيها، وكأنها لم تكن سوى لمحة عابرة يصعب الإمساك بها، تتكررت عبارة “لست أدري!” ثلاث مرات، كدلالة على التيه المعرفي والعجز الإنساني أمام الأسئلة الكبرى المتعلقة بالوجود، والذات، والمعنى.
وينتقل الشاعر في رحلة البحث عن المعنى في أعماقه وفي الوجود، إلى مرحلة أخيرة بعد عناء الـتأملات إلى مقطوعة “صراع وعراك” لكن الصراع هنا مختلف بين الشاعر ونفسه، رحلته تؤول به إلى نسفه، إلى ماضيه وحاضره؛ فالإنسان في رحلة لاكتشاف ذاته والكون من حوله، وينتهي به الأمر إلى الضياع عند اكتشاف الحقيقة، بعد مخاض التأمل وتشظي الهوية وفقدان البوصلة، يتوه الإنسان في ذاته، ويبحث عن نفسه، فيجد أن الحاضر ليس كالماضي، وأن المستقبل مجهول.
عندما يصبح الإنسان حالمًا، حقيقة شفافة، ماء نقي، يكون مرآة واضحة، غريقًا بين ثنايا روحه، وباحثًا عن معناه، يصبح في عالم من “لست أدري!” هذه التأملات الفلسفية الباحثة عن الوجود ومعنى الحياة، إنها فلسفة الإنسان، محاولة تجميع الشظايا.. ليدرك ختامًا أنه ضحية لكل ما عاشه، لتأملاته ومعرفته، ضحية كونه إنسانًا!
“أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية
أنا لا أعرف شيئا من حياتي الآتية
لي ذات غير أني لست لأدري ماهية
فمتى تعرف ذاتي كنه ذاتي؟
لست أدري!
إنّني جئت وأمضي وأنا لا أعلم
أنا لغز… وذهابي كمجيتي طلسم
والّذي أوجد هذا اللّغز لغز أعظم
لا تجادل ذا الحجا من قال إنّي…
لست أدري!”
يختتم فيلسوف المهجر قصيدته من حيث بدأت، ذات الحيرة، وذات التشظي، فرحلة الإنسان عميقة حد الغرق، لغز حد السحر، ما ورائيه حد الانتهاك لخصوصية الإنسان، ولحقيقة حضوره المتشظي الذي لا يمكن صهره وإعادة تكوينه حقيقة!
تنتهي القصيدة إلى أن الطلسم يمثل فعلا سحريًا لمحاولة تفكيك الشاعر الواقع بناء على البعد الروحاني للسحر وقدرته على تزييف الحقيقة وفتح آفاق البحث العميق والقراءة الجديدة للواقع، ومثلت “لست أدري!” التي تكررت في القصيدة واحد وسبعين مرة موقف الشاعر الفلسفي ونظرته العميقة للوجود إذ لا يوجد يقين حقيقي ماثل، وللحقيقة أبعاد وأوجه ساحرة إذ يفكك اليقين ويترك إعادة ترتيبه للقارئ المتأمل.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .