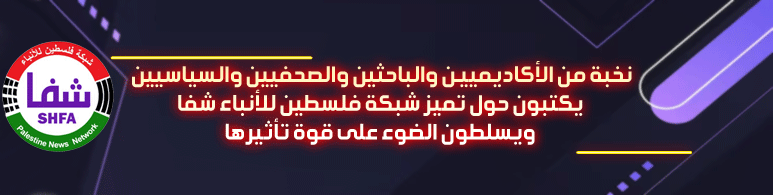نشيد الوحدة في حضرة النور ، بقلم: رانية مرجية
أيّها الآخر… أيّها الأخ الذي لم تلده أمي ولم تسكنه حارة طفولتي، ومع ذلك حين التقت عيوننا على درب الغربة شعرت أنني أعود إلى بيت قديم كان ينتظرني منذ بدء الخليقة. مددتُ لك يدي كما مدّ يسوع كفّه لبطرس الغارق في خوفه، ولم أسألك عن دينك أو شكل صلاتك، فالمعلّم الحقّ علّمني أن كل القلوب أيقونات منحوتة بيد الخالق الواحد، وأن الأرواح لا تُقاس بجهة السجود، بل بعمق المحبّة التي تحملها.
علّمتني مريم، التي احتضنت جراح العالم في قلبها، أن أفتح باب بيتي لكل تائه، كما فتحت بيت لحم مزودها للفقراء ولملك أتى بلا تاج وحمل حبًّا يكفي الأرض كلها. سمعت المزامير تنشد في قلبي: «ها ما أحلى وما أجمل أن يسكن الإخوة معًا»، ففهمت أن الأخوّة ليست دمًا ولا نسبًا، بل رغيفًا نقسمه وماءً نشربه من جرّة الرجاء. فلنكسر الخبز معًا كما فعل المعلّم مع تلاميذه، ونتعلّم أن العطاء سرّ سماوي لا يُقاس بالكفوف الممدودة بل بالقلوب المشرعة على الآخر.
وحين نمشي تحت زيتونة الجبل، حيث صلّى يسوع في جثسيماني، أتذكّر أن الحزن أيضًا صلاة، وأن الدموع التي سقطت على حجارة الهيكل هي ذاتها التي غسل بها محمد قلبه في ليلة المعراج، فهنا يتساوى الدعاء في كل اللغات وتتوحّد الأرواح تحت أغصان السلام. وعندما نبلغ القمّة، سيرتفع الصليب في الأفق ويعانقه الهلال، وسندرك أن السماء لا تعرف الانقسام، وأن الفجر والقيامة وجهان للنهار نفسه، وأن النور الذي غلب القبر هو ذاته الذي يبدّد وحشة الليل عند الأذان الأول.
فلا تقل: هذا طريقي وهذا طريقك، بل قل: هذا جسرنا الممتد من مزامير داود إلى صلاة الفاتحة، ومن دم المسيح المسكوب حبًّا إلى دماء الشهداء في حقول الزيتون، ومن صرخة «إيلي إيلي لما شبقتني» إلى همس «حسبنا الله ونعم الوكيل». وحين نسير في ساحة القيامة أو عند قبة الصخرة لن يهمّ أيّنا يصلي بأي اتجاه، فكل السجدات تصعد إلى السماء نفسها، وكل القلوب حين تحبّ تصير كنيسة وجامعًا في آن.
أيّها الآخر… لقد جئت أبحث عنك، فاكتشفت أنك كنت تسكنني منذ الأزل، وأننا حين نقبل بعضنا فإننا نقبل صورة الله فينا، ونردّ للسماء ابتسامتها الأولى
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .