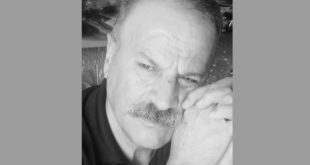قراءة نقدية حول قصيدة «ماذا لو» للشاعرة إنعام سليمان ، بقلم: رانية مرجية
مقدمة: القصيدة كاختبار لنبض الوجود
في قصيدة «ماذا لو» لا تكتب إنعام سليمان عن الشعر فحسب، بل تختبر إمكان الحياة داخله.
كل سؤال تطرحه في النص هو نبضة من قلب القصيدة، لا بحثًا عن إجابة، بل رغبة في مقاومة الصمت، في مواجهة الزمن الذي يتآكل المعنى.
هذه ليست قصيدة عن الحبر والكلمات، بل عن الخوف من انقراض الحلم، وعن كائنٍ اسمه الشعر يشيخ مثل الإنسان، ويحتاج إلى عناية، وماء، ودهشة كي يبقى حيًّا.
إنعام سليمان هنا ليست “شاعرة تسأل”، بل كاهنة لغة تُقيم طقس الحياة وسط رماد الكلمات.
أولًا: السؤال بوصفه جوهر الوعي الشعري
يتكرّر السؤال “ماذا لو” بوصفه نغمة الوجود داخل النص.
السؤال لا يعبّر عن الحيرة فقط، بل يصوغ فلسفة كاملة:
كلّ كائنٍ لغويٍّ مهددٌ بالفناء ما لم يُسقَ بالدهشة.
«ماذا لو أصاب عشب قلبها الجفاف؟
وذبلت عروق الليلك؟
ورحل سرب الفراشات؟»
تبدأ القصيدة من افتراض الغياب:
غياب العشب (الحياة)، الليلك (الأنوثة)، الفراشات (الحرية).
كأن الشاعرة تسأل: إذا ماتت الرموز التي تُنبت القصيدة، فهل يظل الشعر شعرًا؟
إنه سؤال وجوديّ عن بقاء الفن حين تموت شروطه الطبيعية.
بهذا المعنى، يتحوّل “ماذا لو” إلى تمرين على الوعي بالموت –
موت اللغة، موت الخيال، وموت الشاعرة داخل نصّها.
وهي لا تسأل لتُطمئن نفسها، بل لتواجه العدم باللغة نفسها.
ثانيًا: القصيدة ككائنٍ عضويّ – الجسد الميتافيزيقي للغة
منذ الأسطر الأولى، تُعامِل إنعام القصيدة ككائن حيٍّ له قلب وعروق، وجسد يمكن أن يمرض ويُشفى.
«هل ستكون القصائد بلون الخريف؟
أم تكتفي بكتابة وصية الليلك؟»
القصيدة هنا جسدٌ نباتيّ، يُزهر بالحب ويذبل بالخذلان.
لكنها أيضًا كائن ميتافيزيقيّ، إذ تملك وعيًا بذاتها.
فهي لا تموت بل تكتب وصيتها،
كما لو أن الشعر يمتلك وعيًا يسبق الشاعرة نفسها.
هذه الصورة تنتمي إلى ما يمكن تسميته بـ الأنسنة الماورائية للقصيدة،
حيث يُعاد تعريف النص لا بوصفه “نتاجًا لغويًا”، بل كائنًا يملك مصيره، ويتألم ويُفكّر.
وفي العمق، هذا هو وعي الشاعرة بنفسها:
هي تعرف أن الكتابة فعل فناء، وأن القصيدة لا تُولد إلا من خسارة،
ولهذا لا تخاف الجفاف بل تصفه بصفاءٍ مؤلم، كمن يلمس جرحًا مألوفًا.
ثالثًا: استعارات الخلق والأنوثة – الأمومة اللغوية
«من سيطعم صغار المعنى؟
من سيعبئ محابر الشعر؟»
هنا تبلغ إنعام سليمان ذروة الابتكار في الصورة.
القصيدة تتحول إلى أمّ كونية تخاف على أطفالها – الكلمات.
“صغار المعنى” استعارة تُعيد للشعر وظيفته الأولى: الخلق.
إنعام لا تكتب كأنثى تتزين باللغة، بل كـ أنثى تلد اللغة.
تستدعي مفردات الأمومة – الإطعام، الرعاية، السهر – لكنها تنقلها إلى مستوى رمزيّ:
الكلمة ليست مولودًا لغويًا بل كائنًا روحيًا.
هذه النزعة الأمومية في النص لا تنتمي إلى الحنان وحده، بل إلى الوعي الكونيّ للأنثى:
المرأة الشاعرة ليست مخلوقة من الكلمة، بل هي التي تخلق الكلمة وتمنحها ديمومتها.
إنها إلهة صغيرة تشعل المصابيح في ظلمة المعنى.
رابعًا: الشعر والعمى – البصيرة في مواجهة الوهم
«ويقود شاعر أعمى إلى بلاد البلاغة سيرًا على الأوهام…»
هذه الجملة من أعمق ما كتب في القصيدة الحديثة.
فهي تحوّل “العمى” إلى رمز للبصيرة المطلقة.
الشاعر الأعمى هو الذي يرى بعين القلب، لكنه يسير على أوهامٍ، أي على المجاز، على اللايقين.
تُدرك إنعام أن الشعر لا يولد من الحقيقة، بل من الخطأ الجميل.
ومن هنا يأتي جوهر رؤيتها:
أن اللغة لا تضيء إلا حين تخطئ، وأن الشاعر لا يرى إلا حين يعمى عن الظاهر.
إنها فلسفة جمالية تقوم على المفارقة:
كل وضوحٍ هو عتمة، وكل عتمةٍ هي بصيرة محتملة.
وهكذا تحوّل الشاعرة الشعر إلى رحلة عمى طوعيّ نحو النور الداخلي.
خامسًا: القصيدة المصابة – الجمال كجرحٍ مفتوح
«ماذا لو أصيبت القصيدة بشهقة مجازية؟
وتلعثم الوزن بالآيات الصوفية؟»
هنا تتخذ اللغة طابعًا وجوديًا حادًا:
القصيدة “تصاب” بالشهقة، والمجاز يتحول إلى اختناقٍ جميل.
إنعام سليمان تكتب عن لحظة انكسار الشكل أمام الفيض الروحي.
حين يتلعثم الوزن، تكون الروح قد تجاوزت الإيقاع إلى السكينة الصوفية.
هذا المشهد هو مقتل الشاعرة في دوائرها القمرية، كما تقول:
«من يدرك حينها مقتل شاعرة بارتطام حاد في دوائرها القمرية؟»
إنه ليس موتًا حقيقيًا، بل استشهادٌ في سبيل اللغة.
فالشاعرة تُصاب بنور الشعر، كما يُصاب المتصوف بنور الحقيقة.
وكلّ مجازٍ عندها هو تجربةُ عبورٍ بين الحسيّ والمطلق،
حيث تتقاطع التجربة الشعرية مع تجربة الكشف الروحي.
سادسًا: انحناءة الضوء والزمن الدائري
«ماذا لو انحنى عقرب الساعة إلى الوراء قليلاً
كأنحناءة الضوء على صدر البحيرة…»
الصورة هنا مذهلة في رهافتها ودلالتها.
فانحناءة الزمن تشبه انحناءة الضوء،
وهذا يعني أن الزمن ليس خطيًّا بل موجةٌ من انعكاس،
وأن العودة إلى الوراء ليست نكوصًا، بل إعادة ولادة للدهشة.
«ليعلن أن النهاية هي بداية لبداية، برقص الوقت على أنفاس العناق…»
هنا تتجلّى الفلسفة الجوهرية للقصيدة:
أن كل نهاية هي بداية متجددة، وأن الزمن في جوهره أنثويّ دائريّ،
ينحني ليُعيد الخلق، كما تنحني الأم على طفلها، أو كما تنحني الشاعرة على القصيدة وهي تكتبها بالحب والوجع.
بهذا التوظيف الميتافيزيقي للزمن، تُحرّر إنعام القصيدة من حدود التاريخ، لتجعلها كائنًا خالدًا في دورة الضوء.
سابعًا: المعنى المرتبك – جمالية اللايقين
«ماذا لو ارتبك المعنى في لحظة الفراق،
هل يبدو وجه القصيدة مألوفًا؟
أم أن الدهشة غادرتها مذ أول تلويحة؟»
الارتباك هنا ليس ضعفًا بل ذروة الجمال.
فالمعنى الثابت لا يعيش، والمعنى المرتبك هو الذي يتنفس.
إنعام سليمان تدرك أن الدهشة هي الأوكسجين الأول للشعر،
وحين تغادر الدهشة، يتحجر النص.
في هذا المقطع تبلغ القصيدة وعيها الكامل بذاتها:
هي تعلم أن اللغة خائنة بطبيعتها، وأن الشعر لا يكتمل إلا بنقصه.
ولذلك، يصبح الارتباك جزءًا من الجمال،
والغموض شرطًا للحقيقة،
كما يقول أدونيس: «المعنى الواضح هو موت الشعر».
ثامنًا: احتراق البداية – ولادة من الرماد
«ماذا لو تلاشى ظل القصيدة؟
هل ستحترق أناملها كلما فكرت بكتابة البداية؟»
تتأمل الشاعرة هنا لحظة الانمحاء.
حين يزول ظل القصيدة، أي حضورها المجازي،
يبقى فقط احتراق الأنامل – أي الشاعرة نفسها.
إنها تسأل: هل الكتابة بداية أم نهاية؟
والجواب يأتي صامتًا: الكتابة احتراقٌ متجدد.
كل بدايةٍ شعرية هي استمرارٌ لنارٍ قديمة،
وكل قصيدةٍ هي رماد قصيدةٍ سبقتها.
بهذا المعنى، تُعيد إنعام تعريف الفعل الإبداعي كدورة أبدية من الاحتراق والانبثاق،
تمامًا كما يفعل الفينيق حين يولد من رماده.
تاسعًا: سؤال الختام – الارتواء من الظمأ
«ماذا لو سال الحبر على غفلة منا،
هل سيرتوي النص؟»
هذا السؤال الأخير خلاصة الرؤية كلها:
النص لا يرتوي من الحبر بل من العطش ذاته.
الكتابة ليست وسيلة ارتواء بل استمرار للعطش الجميل،
ذلك الذي يُبقي القصيدة حيّة.
إنعام سليمان هنا تؤسس لفلسفة شعرية مفادها أن الشعر لا يُكتب ليُشبع،
بل ليُبقي الجوع الإبداعي يقظًا.
النصّ الحقّ لا يرتوي، لأنه نهر لا يصل إلى مصبّه أبدًا.
عاشرًا: البنية الكونية للنص – من الذات إلى الوجود
القصيدة ليست تجربة ذاتية مغلقة، بل مرآة للوعي الإنسانيّ.
في كل سؤال، نسمع صدى الإنسان الحديث في مواجهته للعالم:
خوفه من الصمت، من ضياع المعنى، من أن يصبح الكلام مجرد ضوضاء.
لكن الشاعرة لا تستسلم لهذا القلق؛ إنها تخلق من الأسئلة عزفًا صوفيًّا يعيد إلى الشعر روحه الطفولية الأولى.
إنعام سليمان تُمارس ما يمكن تسميته بـ الكتابة الوجودية الأنثوية،
حيث يتحد الجمال والقلق في نسيجٍ لغويٍّ رفيع،
وحيث تتحوّل القصيدة إلى مرآةٍ فلسفيةٍ تسائل الحياة والموت معًا.
خاتمة: الشعر بوصفه نجاةً من الفناء
«ماذا لو» ليست مجرد قصيدة تساؤل، بل وصية الشعر للغة.
إنعام سليمان لا تسأل لتتلقى جوابًا، بل لتبقي النار مشتعلة.
ففي عالمٍ يتآكل فيه المعنى، يصبح السؤال فعلَ مقاومة،
ويصبح الشعر مساحةَ نجاةٍ من العدم.
إنها قصيدة تُعيد إلينا الإيمان بأن اللغة لا تموت ما دامت تسأل،
وأن القصيدة لا تُكتب بالحبر، بل بالدهشة التي تسبق الحرف.
ختام القول:
قصيدة «ماذا لو» هي تأملٌ ميتافيزيقيٌّ نادر،
تكتب الشعر عن الشعر، والحياة عن الحياة.
فيها تتوحد إنعام سليمان مع لغتها،
فتُصبح القصيدة قلبها، والحبر دمها، والسؤال أنفاسها الأخيرة التي لا تنتهي
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .