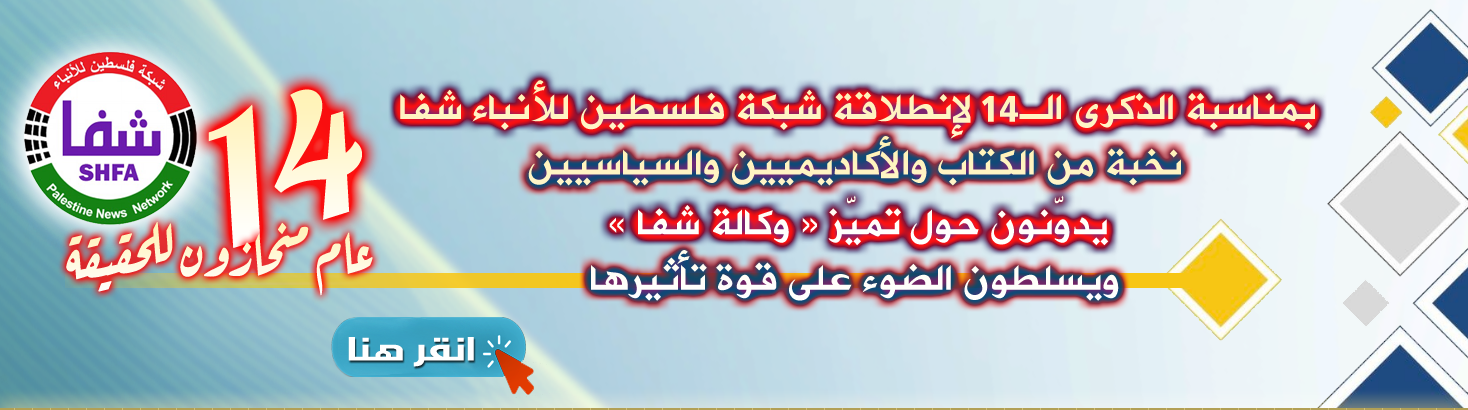الجغرافيا المعطلة : الضفة الغربية بين الحصار والتجزئة ، بقلم : سالي أبو عياش
بينما تتصدّر غزة المشهد العالمي بحرب إبادة غير مسبوقة في وحشيتها ودمويتها، يعيش الفلسطيني في الضفة الغربية مأساة موازية أقل صخباً وأكثر صمتاً، لكنها لا تقل قسوة، ففي الوقت الذي تُباد فيه غزة تحت القصف والتجويع، يجري في الضفة مشروع آخر يقوم على التقطيع الممنهج للجغرافيا والذاكرة معاً، عبر سياسة البوابات والحواجز التي تسعى إلى تحويل الضفة إلى أرخبيل من الجزر المنعزلة، فاليوم، هناك ما يقارب 1200 بوابة موزعة في أرجاء الضفة، تفصل المدن عن قراها ومخيماتها، وتحوّل حياة الناس إلى سلسلة من المعابر اليومية.
هذه السياسة الصامتة تُدار بتخطيط بارد، لكنها تترك أثراً عميقاً يجعل المكان أقرب إلى سجن كبير بلا جدران، يُدار عن بُعد، فمن الواضح أن التجربة التي عاشها اليهود في أوروبا مع الكانتونات المعزولة خلال القرن العشرين ليست بعيدة عن الأذهان الإسرائيلية، إذ يبدو أنهم يسعون لتطبيق نموذج مماثل على الفلسطينيين: أراضٍ صغيرة معزولة، طرق ملتوية، وقيود مستمرة على الحركة، بحيث تصبح السيطرة على الأرض والسيطرة على الإنسان أمراً واقعاً قبل أي إعلان رسمي.
هذا التشبيه يذكّر أيضاً بنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، حيث كانت الحدود والحواجز وسيلة لتفتيت المجتمع وتقويض قدرته على المقاومة، ما يجعل ما يجري في الضفة استمرار لتجربة تاريخية في تفكيك المجتمعات بالقوة السياسية والهندسة المكانية.
الجغرافيا غير قابلة للحياة:
لم تعد الجغرافيا في الضفة الغربية مجرد إطار مكاني يحتضن حياة الناس، بل تحولت بفعل الاحتلال إلى جغرافيا غير قابلة للحياة، فالمدن والقرى باتت مقطعة الأوصال بالبوابات والجدران، حتى أصبحت رحلة الانتقال من مكان إلى آخر مغامرة يومية مليئة بالانتظار والمهانة.
هذه الجغرافيا الممزقة لا تُثقل كاهل الفلسطيني فقط على مستوى الحركة، بل ترك بصماته على مختلف جوانب الحياة:
اجتماعياً: تفككت الروابط العائلية بفعل صعوبة التواصل بين المدن والقرى والمخيمات، وأصبحت الزيارات العائلية أو حضور المناسبات أمراً محفوفاً بالعناء.
اقتصادياً: ضعف سوق العمل الداخلي، وتراجعت فرص الاستثمار، إذ بات العامل المياوم يخسر ساعات طويلة على الحواجز بدلاً من عمله، وتتحول المسافة القصيرة التي تُقطع في دقائق إلى رحلة تمتد ساعات، ما يضاعف كلفة الوقود والمواصلات.
تعليمياً: الوصول إلى الجامعات والمدارس لم يعد أمراً بديهياً، بل معركة يومية مع الوقت والإغلاق المفاجئ.
نفسياً: يولّد الإحساس الدائم بالحصار والقهر شعوراً بالاختناق واللا جدوى.
السيطرة على الجغرافيا = السيطرة على الإنسان:
أدرك الاحتلال منذ عقود أن من يسيطر على الجغرافيا يسيطر على الإنسان، فحوّل الضفة الغربية إلى خارطة من التجزئة والعزل، حيث جعل كل مدينة وقرية محاطة بجدار أو مستوطنة أو بوابة. واليوم، بات هناك حوالي 1200 بوابة حديدية، في ازدياد مستمر، ما يعزل المدن عن قراها، ويحوّل التنقل إلى كابوس يومي.
هذه السياسة لا تقتصر على التحكم بالحركة اليومية، بل تُستخدم كوسيلة لإضعاف الترابط الاجتماعي، وتفتيت المجتمع الفلسطيني إلى وحدات صغيرة يسهل السيطرة عليها.
فعلى سبيل المثال تشكل الخليل نموذج العزل: إذ تقدّم المشهد الأكثر وضوحاً فالمدينة، التي تُعتبر من أكبر الضفة وأكثرها كثافة سكانية، باتت مفصولة عن بلداتها وقراها بالبوابات الحديدية. الدخول والخروج أصبحا مشروطين بتفتيش وإذن من الجنود، أو فتح بوابة فرحلة الوصول إلى المستشفى أو الجامعة أو حتى السوق المركزي تحولت إلى معركة مع الحواجز والبوابات، بينما يعيش المستوطنون في قلب المدينة بحرية كاملة. الخليل ليست مجرد مدينة محاصَرة، بل صورة مصغّرة للضفة كلها: سجن كبير تُدار أبوابه من أبراج المراقبة.
التهجير الناعم:
ما يحدث في الضفة لا يُشبه مشاهد التهجير القسري التي عرفتها النكبة عام 1948، لكنه يحقّق الهدف ذاته بوسائل أكثر بطئاً. فالاحتلال يطبّق ما يمكن تسميته بـالتهجير الناعم: جعل الحياة اليومية لا تُطاق، بحيث يضطر الناس للرحيل بأنفسهم.
ففي حين يُستنزف المواطن في عمله وسفره وتعليمه، وحين يشعر أن كرامته مهانة يومياً على الحواجز، يصبح التفكير بالرحيل خارج فلسطين خياراً مطروحاً. وهكذا يملأ المستوطنون الفراغ بخطى ثابتة، دون الحاجة إلى مشهد دراماتيكي من الطرد الجماعي.
خنق الجغرافيا:
إن وجود 1200 بوابة يعني 1200 قيد على الجسد الفلسطيني.
فالضفة لم تعد خريطة متصلة، بل فسيفساء مشوّهة: من نابلس إلى جنين، من رام الله إلى بيت لحم، ومن طولكرم إلى الخليل، الحركة الطبيعية تحولت إلى كابوس دائم. والهدف النهائي واضح: منع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، وتحويل فكرة الاستقلال الفلسطيني إلى مجرد وهم.
فبين غزة والضفة الاحتلال وغطرسته واحدة ففي غزة يُستخدم السلاح لإبادة الناس، وفي الضفة تُستخدم البوابات لإعدام الجغرافيا. هما وجهان لمشروع واحد: القضاء على فكرة فلسطين ككيان حيّ. لكن كما صمدت غزة رغم القصف، تُظهر الضفة قدرة على التكيّف والصمود. الناس ما زالوا يعبرون البوابات، يزرعون الأرض، ويتمسكون بالهوية، وكأنهم يقولون: لن تُمحى فلسطين بالحديد ولا بالجوع.
قد تبدو البوابات مجرد تفاصيل معدنية، لكنها في حقيقتها جدران سياسية وأدوات استعمارية. ومع ذلك، تبقى الحقيقة الأعمق أن الفلسطينيين اعتادوا تحويل كل قيد إلى حافز جديد للبقاء. الضفة اليوم مقطّعة الأوصال، لكن الروح التي تسكنها ما زالت موحّدة: روح التمسك بالأرض والهوية.
وفي ظل هذه السياسات الممنهجة، يطرح السؤال الكبير: ما مصير الضفة الغربية إذا استمرت هذه التجزئة والتحكم اليومي؟ خاصة في ظل التطورات السياسية الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان والضم وهل سيستسلم المواطن الفلسطيني لإرادة الاحتلال، أم ستبقى روح الصمود حاضرة رغم كل المعاناة؟ التحدي لا يقتصر على مواجهة البوابات والجدران، بل يمتد إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي، والاقتصاد المحلي، والهوية الوطنية أمام كل محاولات الفصل والضم. وبينما يسعى الاحتلال لتحويل الضفة إلى كانتونات ميتة، يبقى الرهان على الوعي الفلسطيني والمقاومة الشعبية، وعلى دعم دولي يعيد الاعتبار للقانون الدولي.
فالمستقبل مفتوح على كل الاحتمالات، لكن التاريخ أثبت أن الأرض لا تُنسى، وأن الشعب الذي يعيش فيها لا يختفي بسهولة، إلا قسراً أو طرداً من هذه الأرض مهما حاولت البوابات أن تخنق أنفاسه.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .