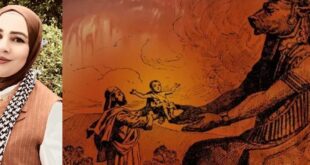تقليص دوام المعلمين يكشف الهشاشة المؤسسية ، بقلم : ثروت زيد الكيلاني
تبدو أزمة التعليم في فلسطين اليوم كواحدة من أعقد المعضلات الوطنية، فهي ليست مجرد تعديل في جداول الحصص أو إعادة توزيع لأدوار المعلمين والطلبة، بل انعكاسٌ لمأزق تاريخي متشابك تتقاطع فيه الأبعاد السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. التعليم لم يعد مجرد عملية نقل معرفة، بل أصبح فضاءً وجودياً تتجسد فيه معركة الوعي والكرامة والسيادة، وميداناً لتشكيل الإنسان الحر القادر على التفكير والمساءلة والانتماء.
إن القرار الأخير بتقليص دوام المعلمين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً وفق نظام تعاقبي لا يُقرأ كإجراء إداري عابر، بل كحلقة في سلسلة استنزاف ممتدة للمدرسة الفلسطينية، التي تعرضت عبر عقود طويلة للاحتلال، والأزمات الاقتصادية، والسياسات الارتجالية، لتصبح اليوم فضاءً هشاً، يفرغ تدريجياً من دوره التحرري، ويضعف قدرة المدرسة على احتضان نمو شمولي وبناء وعي نقدي ووطني متين.
لقد شهد الزمن التعليمي منذ عام 2006 تآكلاً مستمراً: من تقليص دقائق الحصص والاستراحة، مروراً بفقدان سنة كاملة من زمن التعلم خلال جائحة كورونا، ومن الإضرابات الجزئية التي أفقدت الطلبة بين 20 و60 يوماً سنوياً، وصولاً إلى أنظمة دوام غير مكتملة، وصياغة الدوام النصفي المتعاقب للمعلمين. هذه التراكمات لم تقتصر على نقصان ساعات التعليم، بل طالت جوهر العملية التربوية نفسها، وهددت قدرة المدرسة على أداء رسالتها كفضاء للنمو الشمولي والتفكير النقدي وبناء الإنسان القادر على مقاومة التبعية والهيمنة.
الأزمة هنا لا تتوقف عند حدود الطلبة؛ فالمعلم، قلب العملية التعليمية النابض، يعاني ضغوطاً مهنية واقتصادية مستمرة، وسط غياب حماية مؤسسية ودفع المنظومة نحو حلول تقنية سطحية تفرضها سياسات المانحين، لا تلامس جوهر الأزمة ولا تصون السيادة التعليمية أو الكرامة الوطنية. ومن هنا يظهر السؤال الفلسفي الجوهري: هل يتحول التعليم الفلسطيني إلى امتياز طبقي، مرتبط بالقدرة الاقتصادية على التعويض، أم يظل فضاءً تحررياً متاحاً لكل طفل، مؤسساً لوعي جمعي مستقل ومشروع وطني حر؟
إن حصر هذه الأزمة في بعد إداري بحت يكشف السطح فقط، بينما حقيقتها أعمق وأوسع، فهي هندسة اجتماعية وثقافية قد تؤدي إلى إنتاج أجيال ناقصة المعرفة، ضعيفة الانتماء، سهلة الانقياد لمنطق السيطرة. ومن هذا المنطلق تنبثق الحاجة الماسة إلى مقاربة استراتيجية شاملة، تُعيد للتعليم مكانته كحق وجودي ووطني، وفضاء لبناء شخصية متوازنة وواعية، قادرة على مواجهة تحديات الاحتلال والهيمنة، وحمل مشروع الحرية والكرامة في آن واحد.
المحور الأول: تشخيص واقع التعليم وفق مراحل تراكمية للفقد التعليمي
أولاً: الطلبة الذين التحقوا بالمدارس قبل عام 2019 – أجيال تحمل عبء التاريخ التعليمي: الطلبة الذين بدأوا مسيرتهم التعليمية قبل عام 2019 يواجهون تراكماً هائلاً من الضغوط التعليمية والمعرفية، التي لم تعد مجرد أرقام على جدول الدوام، بل تجربة وجودية متشابكة. منذ عام 2006، شهدت الحصص اليومية تقليص دقائقها وفترات الاستراحة، ما خلق تراكماً تدريجياً في صعوبة متابعة المقررات والمهارات الأساسية.
ثم جاءت جائحة كورونا لتضاعف هذه الضغوط، حيث فقد الطلاب استمرارية التعلم المنتظم، خصوصاً في المواد الجوهرية مثل الرياضيات والعلوم واللغة. أعقب ذلك إضرابات جزئية للمعلمين تراوحت بين عشرين وستين يوماً سنوياً، ما أضاف طبقة جديدة من التشتت على تجربة الطالب التعليمية.
مع تقليص دوام المعلمين إلى أربعة أيام أسبوعياً لمدة عامين، تقلصت فرص التفاعل المباشر بين المعلم والطالب، وازدادت ضغوط المنهج على الحصص المتبقية، مما جعل التعلم أكثر صعوبة وتعقيداً، وزاد من مستويات القلق والتوتر النفسي والمعرفي لدى الطلاب. ومع الإعلان عن تقليص دوام المعلمين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً في العام الدراسي 2025/2026، ستتصاعد هذه الضغوط بشكل ملموس، بحيث يواجه الطلبة تراكماً جديداً من التحديات، ويزداد الضغط على قدراتهم على متابعة المناهج بشكل متكامل وبناء المعرفة بشكل مستدام.
ثانياً: الطلبة الذين التحقوا بالمدارس عام 2023 – أجيال تبدأ من فجوة تراكمية: الجيل الجديد من الطلبة، الذي التحق بالمدارس عام 2023، لم يسلم من آثار الضغوط السابقة. فمع تقليص دقائق الحصص والاستراحة، ودوام المعلمين المحدود إلى أربعة أيام أسبوعياً، تقلصت فرص التفاعل اليومي والتوجيه المباشر، وارتفعت مستويات التوتر والمعاناة النفسية. ومع إعلان تقليص دوام المعلمين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً في العام الدراسي 2025/2026، ستتصاعد هذه الضغوط بشكل ملموس، بحيث يصبح الطالب في مواجهة تحديات تراكمية منذ البداية، تعيق البناء المعرفي المستمر وتضعف القدرة على التفاعل النقدي والتحليلي.
ثالثاً: أثر الفاقد التعليمي التراكمي: في كلتا المرحلتين، لا يقتصر التأثير على عدد الساعات أو الأيام، بل يمتد إلى تراجع جودة التعلم، ضعف تراكم المعرفة، وإضعاف القدرة على التفكير النقدي والتحليلي. كما تتجلى آثار اجتماعية ونفسية مباشرة على الطلبة، تشمل الإحباط، والتوتر الناتج عن صعوبة اللحاق بالمناهج، وفقدان الدافعية التعليمية، ما يحوّل المدرسة إلى فضاء محدود القدرة على أداء وظيفته الأساسية في التكوين والتحرر وبناء الوعي الوطني.
ينتج عن هذا الفاقد التراكمي تحويل المدرسة من فضاء للمعرفة والحرية والوعي النقدي إلى مجرد مساحة محدودة، حيث يصبح تعزيز الانتماء والهوية الوطنية، وتنمية التفكير المستقل، أكثر صعوبة، مع استمرار خطر إنتاج أجيال غير متكاملة المعارف، ضعيفة القدرة على مواجهة التحديات الوطنية والاجتماعية، ومعرضة للانخراط في منطق التبعية والسيطرة الاقتصادية والسياسية.
المحور الثاني: أثر تقليص دوام المعلمين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً على الطلبة – الحرمان وخسائر التعلم
في منظومة التعليم الفلسطيني، يظل الطالب الحلقة الأضعف والأكثر تأثراً بالقرارات الطارئة التي تحد من قدرة المدرسة على أداء رسالتها الشاملة. إن تقليص دوام المعلمين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً، دون المساس بدوام الطلبة، لا يُقاس بمجرد الساعات المفقودة، بل يمتد تأثيره ليطال الجوهر المعرفي والنفسي والاجتماعي والعاطفي للطالب، ويترك أثراً عميقاً على مسار أجيال كاملة، ويعيق بناء وعي وطني مستقل. ومن أبرز أبعاد هذا التأثير:
المجال الأول: الفجوة المعرفية والتراكمية
يضعف تقليص التفاعل المباشر مع المعلم قدرة الطالب على بناء المعارف وربطها بالخبرة اليومية، ما يؤثر على التفكير النقدي وحل المشكلات.
يؤدي فقدان الساعات التعليمية تدريجياً إلى تراكم فجوات معرفية يصعب سدها لاحقاً، ويحد من استيعاب المناهج بشكل متكامل.
يضعف نمو مهارات الاستقلالية الفكرية والقدرة على التقييم والتحليل المنهجي.
المجال الثاني: الأبعاد النفسية والعاطفية
يؤدي غياب التفاعل الحي مع المدرسة إلى شعور الطالب بالخذلان أو الإهمال، مع ارتفاع مستويات القلق والتوتر.
يقل اعتماد الطالب على ذاته في مواجهة التحديات التعليمية والاجتماعية، ويضعف الثقة بالنفس وبالآخرين.
يحد من قدرته على بناء علاقات اجتماعية صحية ومتوازنة، ويضعف دعم الزملاء والتوجيه التربوي.
المجال الثالث: التفاوت الاجتماعي والعدالة التربوية
الطلاب من الأسر القادرة على التعويض عبر التعليم الخاص أو الدعم الرقمي يحتفظون بميزة نسبية.
الأطفال من الأسر الفقيرة يواجهون فجوة تراكمية، ما يزيد من عدم المساواة ويضعف العدالة التربوية.
يتحول التعليم من حق شامل إلى امتياز محدود، وهو ما يقوض الهدف الاجتماعي الأساسي للمدرسة كفضاء تكافؤ فرص.
المجال الرابع: الانتماء المدرسي والتسرب
يقل الحضور المستمر من التفاعل اليومي مع المدرسة ويزيد احتمالية التسرب المبكر.
يتراجع شعور الطالب بالانتماء المدرسي والهوية الوطنية المرتبطة بالمدرسة.
يضعف الطالب أمام الضغوط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويقلل من التماسك المجتمعي.
المجال الخامس: التعرض للعنف والسلوك الاجتماعي
الانقطاع عن الفضاء المدرسي الآمن يزيد خطر التعرض للعنف الأسري أو المجتمعي.
ينعكس الحرمان المدرسي على سلوك الطالب في صورة عدوانية أو انعزال نفسي، نتيجة شعوره بعدم الدعم أو المساندة.
تتراجع قدرة المدرسة على ضبط المناخ النفسي والاجتماعي بشكل إيجابي.
المجال السادس: ضعف النمو الشمولي وبناء الشخصية
تقل القدرة على تنمية جميع أبعاد الطالب: المعرفية، النفسية، العاطفية، الاجتماعية، والمهارية.
يصعب على الطالب بناء وعي وطني مستقل وتطوير شخصية متوازنة قادرة على مواجهة التحديات الوطنية والاجتماعية.
يصبح التعليم أقل قدرة على أن يكون فضاءً للتحرر والإبداع، وأداة لتشكيل جيل قادر على المشاركة الفاعلة في المجتمع.
هذه السياسات ليست إجراءات إدارية عابرة، بل امتداد لمسار تراكمات طويلة: بدءاً من فقدان دقائق الحصص اليومية منذ عام 2006، مروراً بجائحة كورونا، والانقطاعات الجزئية، وصولاً إلى تطبيق نظام ثلاثة أيام دوام للمعلمين. كل هذه العوامل مجتمعة تهدد النمو الشمولي للطالب، وتقوّض قدرة المدرسة على أداء دورها كفضاء تنموي متكامل يعزز الكرامة، السيادة التعليمية، والوعي الوطني.
المحور الثالث: أثر تقليص دوام المعلمين إلى ثلاثة أيام اسبوعياً على المعلمين – تفكيك الوظيفة التربوية ومكانة المعلم
المعلم الفلسطيني هو حارس الوعي وصانع الحرية، والركيزة الأساسية لاستمرارية التعليم كفعل تحرري على كل المستويات. إن تقليص دوام المعلمين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً يمسهم مهنياً واجتماعياً ونفسياً، ويعكس هجوماً غير مباشر على جوهر وظيفتهم التربوية، وفق المحاور التالية:
المجال المهني: يقلص القرار مساحة المعلم للتفاعل مع الطلبة، فتصبح حصصه مضغوطة، بلا فرصة لتطبيق استراتيجيات تعليمية عميقة أو متابعة تقدم كل طالب على حدة. بهذا يتحول المعلم تدريجياً من مرشد وموجّه للفكر والوعي إلى مجرد ناقل للمعلومات، ويُفقد التعليم قيمته الجوهرية كفعل بنائي للنمو والوعي.
المجال الاقتصادي والاجتماعي: يعيش المعلم الفلسطيني اليوم في سياق اقتصادي صعب، مع راتب محدود لا يواكب كلفة الحياة، وتراجع فرص العمل في الداخل. تقليص الدوام يضاعف الضغوط المعيشية ويحدّ من فرص العمل الإضافي، ما يفرض على المعلم خيارات صعبة بين البحث عن دخل بديل، أو الانسحاب التدريجي من التعليم، أو قبول نمط عمل يقلل من كرامته المهنية ويضعف دوره الاجتماعي.
المجال النفسي والمعنوي: يرسخ القرار شعوراً بالإحباط وفقدان القيمة، إذ يرى المعلم أن جهوده اليومية لم تعد ذات أثر حقيقي، بينما تبقى الأعباء الاجتماعية والسياسية على عاتقه دون دعم فعلي من الجهات ذات العلاقة. هذا الإحساس يفتح الباب أمام خصخصة التعليم ويضعف موقف المعلم كمدافع عن التعليم العام، مما ينعكس لاحقاً على جودة التعليم وتماسك المنظومة بأكملها.
إن تقليص الدوام ليس مجرد إجراء إداري مؤقت، بل هجوماً على وظيفة المعلم وكرامته، ويكشف عن تخلّي الدولة والمجتمع الدولي عن مسؤولياتهم، فيما يُترك المعلم في مواجهة أعباء تربوية واقتصادية ثقيلة، داخل مجتمع يعاني هشاشة اقتصادية واجتماعية، ويواجه تهديدات جغرافية وسياسية متشابكة.
المحور الرابع: أثر تقليص دوام المعلمين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً على منظومة التعليم الفلسطينية – قراءة في الإبادة التربوية البطيئة
إن تقليص دوام المعلمين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً ليس مجرد قرار إداري طارئ أو إجراء تقني للتعامل مع أزمة، بل هو تحوّل بنيوي يمس جوهر المنظومة التعليمية الفلسطينية ويهدد تفكيكها من الداخل. التعليم في فلسطين لم يعد مجرد عملية تزويد بالمعرفة، بل أصبح فضاءً لترسيخ الذاكرة الوطنية وبناء الذات الجمعية. ومع ذلك، فإن تقليص دوام المعلمين يعيد إنتاج منطق الاحتلال بوسائل “محلية–بيروقراطية”، عبر انخراط الفاعلين التربويين أنفسهم في سياسات تقليص تدريجي يمكن وصفها ”الإبادة التربوية البطيئة”.
المستوى الأكاديمي: يؤدي تقليص دوام المعلمين إلى ضغط الحصص وتقليص فرص التفاعل المباشر مع الطلبة، مما يفاقم تراكم الفجوات التعليمية. ويضعف قدرة الطلبة على التفكير النقدي والتحليل المستقل، ويقلص قدرة المدرسة على بناء وعي وطني مستقل، ويحوّل التعليم تدريجياً إلى مجرد نقل معلومات بدل تكوين شخصيات واعية وقادرة على مواجهة الواقع.
المستوى الاجتماعي: يعمّق هذا التقليص الفوارق بين الطلاب، إذ يمكن للطلبة الميسورين تعويض النقص عبر الدروس الخصوصية أو التعلم الرقمي الخاص، بينما يبقى أبناء الأسر الفقيرة أمام فجوة تعليمية متنامية. هذا يعكس خصخصة ضمنية للتعليم العام وتراجعاً في العدالة الاجتماعية.
المستوى السياسي: يأتي القرار في سياق تهديدات الاحتلال بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وتقسيمها، ما يجعل التعليم الفلسطيني فضاءً هشاً أمام الهيمنة الخارجية. تدريجياً، تتحول المدرسة إلى فضاء غير قادر على صون الوعي الجمعي أو بناء وعي فكري تحرري، بل تصبح أداة لإعادة إنتاج التبعية الاقتصادية والسياسية.
المستوى المؤسسي: يسرّع تقليص دوام المعلمين من انزلاق المنظومة التعليمية نحو خصخصة مقنّعة، حيث تُترك المدارس الحكومية عاجزة عن الوفاء بدورها، بينما يفتح المجال أمام التعليم الخاص والمبادرات الفردية لتعويض العجز.
هذا يعكس تنصّلاً حكومياً ومجتمعياً ودولياً من العبء التعليمي، مع تحميل الأسر والمجتمع المدني مسؤوليات إضافية في ظل فقر وبطالة متفشية. كما تظهر هشاشة المنظومة في المقاربات السطحية للمانحين، مثل التحول الرقمي أو الفضائيات التعليمية، التي لا تعالج جوهر الأزمة المتمثل في الرواتب والتمويل وضمان العدالة للمعلم، فتتحول إلى “مسكنات تقنية” تُزيح النقاش عن جذره الحقيقي وتعيد إنتاج التبعية بصورة حلول جاهزة.
إن تقليص دوام المعلمين ليس مجرد تقليص ساعات التدريس، بل انزلاق كامل للمنظومة نحو منطق الإفقار والتفكك، وإبادة تعليمية تمارس بلا عنف مباشر لكنها تحقق الهدف ذاته: تعطيل إمكانات الأجيال القادمة لتكون أدوات تحرر وفاعلية، وتحويل المدرسة من فضاء للحرية والمعرفة إلى مؤسسة شبه معطّلة عاجزة عن الوفاء بوظيفتها التاريخية، مع استمرار إعادة إنتاج التبعية الاقتصادية والسياسية بطريقة ممنهجة.
المحور الخامس: بدائل مبتكرة واستراتيجيات تحررية لإنقاذ التعليم الفلسطيني
في ظل تقليص دوام المعلمين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً وغياب دعم الدولة والمجتمع الدولي، يصبح التفكير في بدائل تعليمية أمراً حتمياً للحفاظ على التعليم الفلسطيني كحق وطني تحرري، لا كامتياز طبقي أو سلعة زمنية. الحلول لا تقتصر على إعادة توزيع الحصص أو التعليم الرقمي، بل تتطلب إعادة بناء الفضاء التربوي ذاته: تمكين الطالب في نموه الشمولي، صون كرامة المعلم وسيادته المهنية، وضمان قدرة المنظومة على تشكيل وعي وطني متماسك ومستدام.
التحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية: بناء استراتيجية تعليمية فلسطينية مستقلة ومستدامة ليس خياراً، بل ضرورة وطنية عاجلة، تتطلب تمويلاً وطنياً مستقلاً يضمن استمرارية رواتب المعلمين بعيداً عن المقاصة، ودعم البنية التحتية المحلية. يجب أن يشارك رأس المال الوطني والشركات الفلسطينية في هذا الجهد، ليظل التعليم متاحاً لجميع الطلاب، ويشكل فضاءً للتحرر الفكري وبناء الهوية الوطنية، بدل أن يتحول إلى امتياز محدود أو أداة لإدامة التبعية الاقتصادية والسياسية.
إعادة هندسة زمن التعلم وممارسات الفصول: لمواجهة الفاقد التعليمي التراكمي، يجب إعادة توزيع الحصص اليومية بما يضمن تعلماً مركّزاً وعميقاً. يمكن دمج أساليب التعليم النشط، التعلم القائم على المشاريع، والتجارب العملية الميدانية، بحيث تصبح كل ساعة تعليمية غنية بالمعرفة والمهارة، وليست مجرد وقت مضاعف لعدد أيام محددة. كما يمكن إنشاء برامج تعلم مدمج خارج الصفوف التقليدية، تشمل أنشطة جماعية، مختبرات متنقلة، ودروس تفاعلية وطنية، لتتحول المدرسة إلى فضاء إنتاج معرفي حقيقي.
صون كرامة المعلم وتعزيز دوره السيادي: المعلم هو فاعل تحرري وباني وعي. لذلك يجب دعم المعلمين مالياً ومهنياً، مع ضمان استمرارية الرواتب وحماية الحقوق التربوية. ينبغي أيضاً توفير برامج تدريبية تمنحهم المرونة في تصميم المناهج بما يعكس السياق الوطني واحتياجات الطلاب، ليظل المعلم حارساً للهوية والمعرفة، لا ضحية لضغوط اقتصادية أو تبعية خارجية.
تطوير منصات وطنية تعليمية مقاومة للتبعية: إنشاء منصات رقمية فلسطينية مفتوحة المصدر، تحت سيطرة مؤسسات محلية، تقدم محتوى تعليمياً محلياً يعزز الهوية الوطنية ويقوي التفكير النقدي. يجب أن تكون هذه المنصات متاحة لجميع الطلاب، دون اعتبار للطبقة الاقتصادية، لتصبح أداة تحرر معرفية تحمي التعليم من احتكار قوى خارجية أو تعليم خاص محدود للفئات الميسورة.
تعزيز الشراكة المجتمعية والفضاءات التكميلية: يجب استثمار المجتمع المدني والجمعيات المحلية لخلق فضاءات تعليمية إضافية، مثل النوادي العلمية والفنية، المختبرات المجتمعية، وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي. هذه المبادرات تكوّن شبكة أمان تربوية محلية، تكمل النقص الناتج عن قلة أيام الدوام، وتحمي حق الطالب في التعلم الشامل، مع تعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني.
بناء استراتيجية معرفية تحررية مستقبلية: تطوير مناهج مرنة وقابلة للتكيف مع الأزمات، تشمل التعلم التفاعلي والتعاوني، تعزيز التفكير النقدي وربط المعرفة بالواقع الاجتماعي والسياسي. كما يجب تطوير برامج وطنية للمعلمين والطلاب تعزز إعادة بناء المعرفة المفقودة، مهارات الإبداع، وصون الهوية الوطنية. هذا التحرك الاستراتيجي يضمن أن يكون التعليم الفلسطيني أداة تحرر وبناء مستقبل متكامل، لا مجرد ملحق للتبعية الاقتصادية والسياسية.
التعليم الفلسطيني في مواجهة تقليص دوام المعلمين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً ليس مجرد مسألة إدارية، بل اختبار لقدرة المجتمع الفلسطيني على صون حق التعلم كأداة تحرر وطني. البدائل الممكنة تعتمد على إعادة تنظيم زمن التعلم، حماية المعلم، تمكين الطلاب، وتعزيز السيادة التعليمية الوطنية بعيداً عن التبعية الاقتصادية والسياسية، ليظل التعليم الفضاء الأكثر قدرة على تشكيل وعي مستقل وبناء أجيال واعية.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .