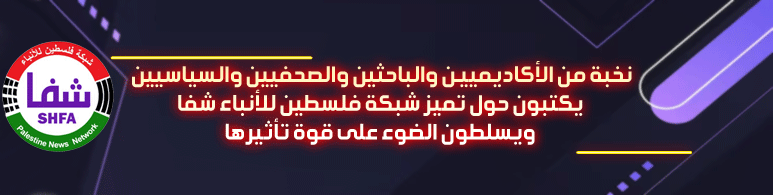نصٌّ قصصيٌّ بعنوان: قُبّعةُ الإخاء ، بقلم : غدير حميدان الزبون
كانت تلكَ الليلةُ تفيضُ بركةً ونورًا بعد يوم شِتويٍّ سقى الأرضَ حتى الثّمالة، انتهى بتشكّلٍ جميلٍ لألوان قوس قزح في صحن السماء.
في صباح اليوم التّالي ورغم تباشير السّماء بنزول الأمطار إلّا أنّ الرجلَ الخمسيني ذا الشاربين المعقوفين والملامح الجميلة بقسماتها الحادّة أصرّ بحزم على ذهاب أبنائه إلى المدرسة مشيًا على الأقدام ككلّ يوم.
يقفُ الرجلُ ممشوقَ القوام ثابتَ الأقدام يعقدُ حاجبيه وينفثُ حمما بركانيّة تنصهر غضبًا فتذيب ما حولها من رحمة في صورة توحي بالغضب المشوب بالقسوة والحزم وامتناع تداول أي مفاوضات مع الجدة حول غياب الأطفال عن المدرسة.
لم يكنْ يعلم بأنّهم يسيرون في طريق جهنمي محفوفٍ بالمخاطر، أمّا زوجته المسكينة فلا حول لها ولا قوة، ولم تكن تنبس ببنت شفة، فكلّ ما عليها أنْ ترمقَ أبناءها بشفقة فتسقط على وجنتيها دمعة ساخنة، وتزمّلهم بنصف المخزون الشتوي من الملابس الصوفيّة في الدولاب العجوز، وتستودعهم ببركة سيّدنا الخضر.
يسيرون والربّ يرعاهم.
وصلوا متأخرين وهم يعتصرون مطرًا، نظرت مديرة المدرسة إليهم، وصرخت في وجوههم: أنتم مجانين، مَن أرسلكم في هذا اليوم العصيب؟
تصرخ مجدّدا: في المرة القادمة إياكم أن تحضروا في مثل هذا الجو، وإلّا ستكون أكوام المساطر الخشبية من نصيبكم.
اقتربت إحدى المعلمات منهم وأحضرت مدفأة من كاز، ونزعت عنهم جبال الصوف، في محاولة منها أن تساعد على بثّ الحرارة في أجسادهم الهزيلة، يقفون وهم يرتجفون، وأنوفهم تستوطنها دوائرُ حمراء، والرشح يغزوها دون رحمة فتسيل وديانًا وأنهارًا.
لا زالت السماء تمطر والرياح تعوي وتضرب النوافذ بقوة.
تجتمع المديرة على عجل بالمعلمات وتخبرهن بضرورة إحصاء العدد ووضع الطلاب في صفوف تجميعية إلى حين انقطاع المطر.
تصرخ المديرة مجدّدا: ها هو المطر يتوقف، ارتدوا معاطفكم، وغادروا إلى منازلكم بسرعة، ولا تلتفتوا خلفكم فيصيبكم ما يصيبكم من لعنة الشتاء.
هرع الطلاب مسرعين من كل حدب وصوب، وهم يصرخون فرحًا، ويتراكضون نحو مستنقعات صغيرة تركتها الأمطار الغزيرة.
هاهم يتدافعون عند الباب الرئيسي حتى يسقط بعضهم، وينجو البعض الآخر، منهم من جاورت منازلهم مبنى المدرسة، فتلاقفتهم أيدي الأمهات قبل أن يتلطخوا بالوحل، ومنهم من سار مسافة قصرت أو طالت عن مركز المدرسة، لكنّ الإخوة المساكين لا زالت خطواتهم بعيدة عن بيتهم الذي يستوطن رأس الجبل البعيد في الناحية الأخرى.
هاهم يمشون ويمشون والريح تنفخ ثيابهم حتى يتراءون لمن يشاهدهم أكياسًا منفوشة تلهو بها الريح يمنة ويسرة في مشهد يثير الضحك.
أخيرا وصلنا: صاح أصغرهم وهو يرنو إلى الأفق البعيد ويرتفع على رؤوس قدميه في محاولة منه لسرقة ألوان قوس قزح ووضعها في جيبه ليرسم وجهًا ملوّنًا لعامورة الليل البيضاء على جدار الغرفة، يحاول ويحاول لكنّه يفقد الأمل ويدلف نحو الغرفة الخارجية، فينزع ثيابه عنه ويراقب من جديد تلوّن جسده من البرد فيكون الأحمر المزرق هو سيّد الألوان على بدنه.
الجدة تقف مع أمهم في المطبخ الخشبي الذي تتسايل جنباته ويتعرّق سقفه، تحرّك قدرًا يتصاعد الدخان منه بكثافة.
يسألهم الأخ الأكبر والحروف تخرج من شفتيه بصعوبة: يا ترى ماذا سنأكل اليوم؟ لا بدّ وأنّه طبق يليق بهذه البركة الربانية.
يجيبه الأخ الأوسط: لا تتفاءل كثيرًا فقد رأيت جدتي تنتقي حبات العدس في الصباح وتفصل عنها القش والشوائب.
الأخ الأصغر: العدس، هو بركة كذلك، لا تنكروا أنّ العدس من يد أمي يضاهي اللحم في مذاقه الطيب، هو عدس يرمّ عظامنا التي سمعنا صريرها في طريقنا إلى المدرسة اليوم.
الأخ الأكبر: خير وبركة المهم أن نملأ هذه الأمعاء الخاوية التي تزقزق منذ ساعات الصباح.
تتحلّق العائلة حول مائدة تزدان بالبصل الأخضر والفجل والزيتون الرصيص الأسود على شرف العدس المبارك، ولا زال الأخ الأصغر ينسج خيالات في ذهنه، في محاولة منه لنزع الألوان من أطباق المائدة حتى يلهو بها ليلًا.
يأكلون ويحمدون الله، في انتظار الشاي بالمريمية.
بدأت المصابيح تتراقص بظلالها فتبدو كالعامورة، يرتسم المشهد في المخيلة، ليتحوّل إلى واقع مقيت مع هبوط الظلام، هاهم يتشاكسون ويتدافعون على الفراش الأرضي يترافسون بأرجلهم ويتعاركون على مساحات النوم الضيّقة، لم يكن بيد الجدّة أي حيلة لفض النزاع إلّا باستحضار حكاية العامورة ذات الثوب الأبيض والتي نهضت من مقبرة قريبة لتحلّ ضيفة بغيضة على سكان الحارة وأهل البيت.
-أنت تعرف ما أعرف وتدفنه في مكان سحيق من ذكريات طفولتك..
-الآن أخبرك.
-هل تقصد أنّهم كذبوا علينا؟
-لنسميه خدعة، يبدو أنّ جدتي وجدتك كانت تتسلّى بنا يا صديق.. كانت تخدعنا.
-لتكنْ ولدا مهذّبًا.
-لو أنها قصة رومانسية لقلت لك أنّ كلّ الرجال في ذلك الوقت هاموا بها، ولو أنّها قصة أطفال لقلت لك أنّ كلّ الورود التي داستها أقدامك وأنت تركض في حقول الجيران منحتها جمالها.. لكنْ والحال هكذا مع ذاكرة مرتعبة، أقول: أنّ مصيرًا أسود ينتظر من يسمعها ونحن منهم.
-لكنّك ستسمعها، حتى لو صممت أذنيك، ستسمعها لا محالة، وهي تناجيك وتسحبك نحوها من قدميك النحيلتين.
غرف الأخ الأصغر بيديه من ماء تجمّع في جوف النافذة ومزجه بطلاء حائط الغرفة على جانب فرشته، وصبّه على سطح غطائه، ثم أدخل جسده تحت الفراش ونزل برأسه كذلك.. استمتع بملمس الماء المُنوِّم على جسد الفرشة.. قبل أن تصطدم ساقه بشيء، وتتبيّن هاتان العينان المحدّقتان به من تحت الغطاء!
أطلق صرخة رعب هائلة.. التف إخوته حوله.. وحوّطته جدّته بذراعيها.. قال كلمات متهدّجة عن شيء يحدّق به من العمق.. تبرّع الأخ الأكبر باستكشاف الأمر.. هو معروف بموت قلبه وربما يعود هذا لاضطراره بأنْ يرافق إخوته في الظلام الدامس لقضاء حاجاتهم في قلب الليل في العراء خلف سور الحديقة.
أخرج الأخ الأكبر رأسه من النافذة وأدخله بعد ثانية ممسكًا بقماش أبيض، لوّح به في وجه جدّته وقال لإخوته:
– اضحكوا يا أصحاب! صديقنا الحلو الفنان المتدلّل يخاف من قطعة قماش أبيض!
كان الأخ الأصغر لايزال يرتجف، وصدره يعلو ويهبط.. لكنه حمد الله أن جعل العامورة قطعة قماش أبيض لا أكثر.. قالت الجدة:
– لا تخف! لا تخف! بركاتك يا سيدنا الخضر، بركاتك.
هنا اختلجت شفاه الأخ الأصغر في ربع ضحكة ما لبثت أن تلاشت ثم فتح كفيه عن قناع ملوّن.. اتسعت عينا الجدّة وأمسكت كفّيه لتخفي القناع بسرعة، وقالت خافضة صوتها:
– يا للمصيبة.. أسرقته من العامورة؟ لو علمت العامورة فلن تغفر لك ذلك.
صرخت الجدّة لكن قبضة العامورة على فمها منعت أي صوت، كانت لها من القوى أضعاف ما تبدو عليه، حتى وهي على هذه الحال من الضخامة..
كان الألم يمزق قلب الجدّة، وللحظة شعرت أنّ قلبها سيقفز من صدرها، وذلك قبل أنْ ينطفئ نور المصباح ويصرخ كل من في الغرفة وتظهر لهم العامورة بالفعل!
وفي اليوم التالي تسلّل نور الشمس إلى أطراف الصغير فنهض على الفور من نومه مسرعًا بعد أن تحسس وجه جدّته الدافئ، مشى بخطوات ثابتة، وركل إخوته بقدميه النحيلتين، ثمّ قفز من فراشه إلى النافذة، كان المشهد ينطق بالحياة، والألوان تملأ المكان، ابتسم ولكنْ هذه المرة في ضحكة كاملة، نظر إلى السماء وقال: يا بركة سيّدنا الخضر حلّي.
نهضت الجدّة من نومها لتصنع يومًا استثنائيّا للطفل الصغير، فقد جمعت خيوطًا ملوّنة بألوان الطيف نزعتها من كنزات بالية كان قد ارتداها الإخوة في عيد الفطر قبل عدّة أعوامٍ لتغزل قبّعة من الصوف الملوّن تشفي غليله وتعالج شغفه بالألوان، وما يثير ذهول الصغير انتقاء الجدّة للألوان ببصيرتها بعد أنْ كفّ بصرها، فكانت قبّعة منسوجة بعناية بابتهالات الجدّات وحكمتهن، وضحكات مطبوعة على خيوطها للإخوة عندما ارتدوها في ذلك العيد ببهجة وسرور.
التمعت خيوط الشمس في عينيه فمدّ يديه ليسرق قبسًا من نور في محاولة لإعادة البصر إلى جدّته.
مرّت الأيام والسّنون مسرعة بحلوها ومرّها، كانت الجدّة الحكيمة قد فارقت الحياة بعد أنْ صنعت من الطفل الصغير رجلًا مثقّفًا شغوفًا لم تمهله الحياة حظًّا سعيدًا ليضحي فيلسوفًا باحثًا عن الفضيلة والتسامح.
كانَ ذلك المثقف يضيق ذرعا كلّما تذكّر شريط الطفولة بصحبة إخوته في ذلك المنزل القديم، نهض من سريره بعد أنْ شعر بصخور صلبة تجثم على صدره حتى أوشكت أنْ تنتزع أنفاسه، لا شيء يقوى على حمله وهو في هذه الحالة من الضعف الروحاني، ارتدى معطفه الجلدي ووضع قبّعته الأثيرة النجيبة على رأسه واستقبل الباب على الفور.
أوقفته زوجته متسائلة: إلى أين تذهب في هذا الوقت المتأخّر، الجوّ بارد هذه الليلة، والمدينة تخلو إلّا من الغرباء والمتسكعين؟
رمقها بعينيه دون أن يجيبها حتى بحرف، وخرج ينوي قلب مدينة الله النائمة.
يمشي ويتنفّس بملء رئتيه، بدأت الصخور تتفتّت عن صدره مع كل خطوة يتبعها شهيق فزفير، يمرّ الآن من أمام محالّ السوق القديمة كانت البضائع مغطاة بالنايلون السميك، لكنّ رائحة الحمضيات تعبق في المكان وتدغدغ أنفه، إنّها بركات يافا وبحرها، تبادر إلى ذهنه تناول بعض حبات البرتقال التي دلّلها البائع في نهار اليوم بقوله: يافاوي يا برتقال…شهدٌ مُصفّى يا يافا.
ضحك بعمقٍ متذكّرًا شقاوته مع إخوته في مثل هذا الموسم، والتقاطهم لحبات برتقال تظهر من أعلى سور مسيّج في طريق عودتهم من المدرسة.
مدّ يده فالتقطها كانت حبّة كبيرة تُغني عن غيرها من الحبات، حبّة مباركة، أمسكها بيديه وأدارها برضا وهو يقول: ما شاء الله، ما شاء الله، بركاتك يا سيّدنا الخضر.
اتّكأ على جدار مظلّل بالقرميد، يقوم الآن بنزع القشور عن الحبّة، كانت أطيب برتقالة تناولها في حياته، ربّما لأنّها صافحت شمس النهار وتشرّبت ببرد المساء ودفء الذكريات.
ما هي إلّا لحظات حتى غطّته مياه عطريّة سقطت عليه من السماء، قال في نفسه: حمدًا لله أنّني أرتدي قبعة على رأسي، لو لم تكن تلك الجميلة الوفيّة على دماغي لكانت رأسي مبللة الآن وربّما لفقدت عقلي، لقد حلّت علينا البركة مجدّدًا، نزع القبّعة واشتمّها بأنفه فكانت مشبّعة بالخمر، يتمتم مجدّدا: لعنكم الله أيها الأنجاس المتسكّعون تلهون وتمرحون ولا تعتقون من التجأ لمدينة الله ليلا بعد أنْ ضاقت أنفاسه، لو تخرجون الآن على الفور لألقنكم درسًا لن تنسَوه طيلة حياتكم.
تردّد صدى صوته وكأنّه يصرخ من جوف بئر، ولم تدمْ سعادته بمذاق حبة البرتقال الطيّبة حتى اختلطت أنفاسه وأفكاره بالخمر، عدّل مساره ينوي البيت مجدّدًا، دخل من الباب، وقصد المغسلة ليتطهّر من الأذى الذي أصابه، فاصطدم بوجه زوجته التي بادرته بالسؤال عن الرائحة التي تملأ المكان، هو الآن في موقف لا يُحسَد عليه، لقد انعقد لسانه مجدّدا.
تلحّ زوجته بالسؤال وصوتها يعلو فتنهض الجمادات من نومها: هل خرجت لتشرب الخمر؟ أنت لا تليق بهذه القبعة، ولا تليق بزوجة مثلي.
تركها ودخل إلى مكتبه، وضع القبّعة وسط أكوام من الملفات والأوراق النقديّة، وأمعن النظر إليها، بينما يحاول تجاوز الصمت والدوار الذي يلتف حوله ويغرق فيه كلّ ليلة.
كان ناقدًا بارعًا، معروفًا بسدادة رأيه وتحليله العميق منذ صغره على رأي إخوته.
لكنْ، ورغم نجاحاته المهنية، كان يفتقد إلى شيءٍ ما لا يستطيع التعبير عنه، كأنه يتنفس في عالمٍ خاصّ لا يشترك فيه أحد معه سوى القبّعة وفنجان القهوة.
رتابة الهدوء الليلي تصنع قَدْرًا من الضجيج لا بأسَ به! والله، لولا صوت القبّعة الذي يهمس في أذنيه صباح مساء، ولولا عهده بالكتابة، وامتزاجه بالقهوة، وقدرته على الطيران والشرود بفكره إلى أرض العامورة ومشاكسات إخوته ما كان ليحتمل سماجة دهره وظله الثقيل.
لكنّه استطاع حديثًا أن يلتقي بروح جديدة تقاسمه سكناته وحركاته يسرح مع نفسه الآن، ويناجي النجوم الهاربة من قلب السماء والمتربّعة على مكتبه، يتسامر معها، ويبتسم قائلًا: شَيِّقةٌ كاخضرار العشب وأحاديث الصباح.
طيبةُ الوجود مُحبَّبةٌ كأنفاس البحر وعِطر الجدات؛ لكنّها -وكَكُلِّ “لكنَّها” يفرضها علينا الدهر قسرًا- متأخرةٌ كتذكرة القطار الذي رحل، ذهبية الأوراق في الخريف، أو مُتأخرةٌ كالوعود بعد فقدان الأمل.
بدت القبّعة المشبّعة بالخمر تتغلغل بين خلايا الخشب كَسَرَيانِ المعجزات بين أصابع (النَّاصريِّ) يُمرِّرُها شفاءً على شَعر (المجدلية)، كان الخشبُ يطيعُ كفَّ القبّعة ويعلمُ ما يريد منها، ويتشكل بناءً عليها!
تخضع الأوراق ويهدأ سُعارُها الشَّبِقُ البغيضُ تحت سطوة القبّعة الشاعريّة الحالمة.
نهض فجأة من مقعده وأمسك القبعة ورماها بأعلى يده من فتحة النافذة.
كان وداعًا سخيفًا بغيرِ داعٍ وبغيرِ معنى، كأي وداعٍ بغيرِ داعٍ وبغير معنىً، ولا يعطي وعودًا أو يُغيِّرُ في الخطط… ثلاث دقائق لا أكثر، فصَلَت بين دخول الرجل المنزل وخروج القبّعة منه هاربة من رأسه بعد عناق طويل.
على كلٍّ لقد تصالحا في اليوم التالي، بعد أنْ وعد الرجل -وأظنه ناكثًا ما وعَد- ألا يعود للمشي ليلًا مجددًا أبدا… سيكونُ رحيلًا طويلًا خطّط لتمديده ما استطاع أنْ يتمدد. كتذكرة القطار الذي رحل… يلاعبنا الدهر.
إنّ روحه خُلِقَت لتطير، وهنا الأرضُ لا السماء، ثم إنّه جرب البقاء على الأرض مرة -في غيرِ اتجاه- وعادَ بخيبة أملٍ، وأملٍ يُثقِلُ كاهله!
كان الرجل المثقف يجد نفسه عاجزًا عن التعبير، كلّ شيء كان يُختزل في هذا الصمت، حتى المشاعر والأفكار التي لم يجرؤ على البوح بها.
كان يحمل عبء البقاء وهموم الكُتّاب على عاتقه، ومع مرور الوقت، أصبح غير قادر على فصل حياته الشخصية عن العمل، حتى بات الصمت هو اللغة الوحيدة التي يتقنها.
لكنّه لم يكن يدرك أنّ صمته هذا كان سجينًا لمشاعره التي كتمها لسنوات على حائط منزلهم القديم.
كبصر جدّته الذي رحل… في يديه النور وعلى دماغة القبّعة، وروحه لم تبرح مكانها منذ دهر متخفية في جوف قبّعة الإخاء.
هو الآن لا يصلح لشيءٍ سوى الابتعاد، واجتلاب بركة الإخوة الذين سقط معهم من رحم أمّه على أرض العامورة البيضاء.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .