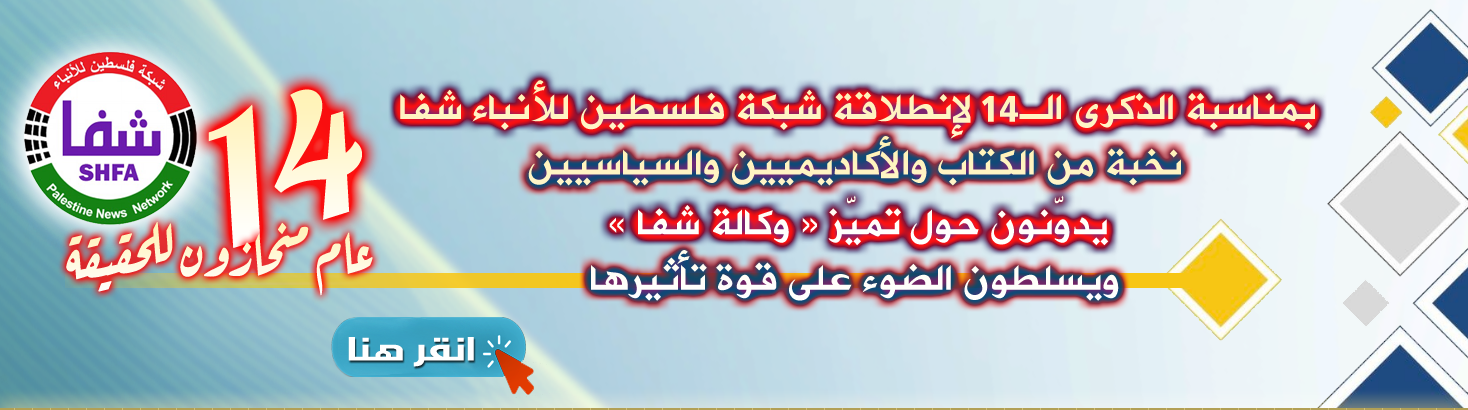الاقتصاد الفلسطيني بين فكي الحصار والمقاصة ، بقلم : سالي ابو عياش
يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بدرجة كبيرة على الإيرادات الضريبية التي تجمعها السلطة الفلسطينية من خلال آلية المقاصة مع إسرائيل، إضافة إلى التحويلات المالية والمساعدات الدولية، إذ تمكّن المقاصة إسرائيل من خصم الأموال مباشرة من الضرائب والجمارك على البضائع الفلسطينية، ثم تحويل ما تبقى إلى السلطة الفلسطينية. هذا النظام يجعل الاقتصاد الفلسطيني رهينة للقرارات السياسية والأمنية الإسرائيلية، فكل توتر أو أزمة تؤدي إلى حجز الأموال أو تأخيرها، ما ينعكس مباشرة على رواتب الموظفين والخدمات الأساسية.
في الواقع، يعتمد الاقتصاد الفلسطيني أكثر على الموارد الخارجية منه على قدراته الذاتية على الإنتاج المحلي أو الاستثمار في القطاعات المنتجة، ما يجعله هشاً أمام أي ضغط سياسي أو عسكري، ويعيق استقلاله المالي. ضعف الاقتصاد يعود إلى محدودية القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، وقيود الوصول إلى الأراضي والأسواق بسبب الحواجز العسكرية والمستوطنات، بالإضافة إلى قلة الاستثمارات المحلية وانعدام الاستقرار السياسي والأمني. السيطرة الإسرائيلية على الموارد الأساسية، من مياه وأراضٍ وطرق تجارية، تزيد من صعوبة تحقيق نمو اقتصادي أو اكتفاء ذاتي.
الحصار الإسرائيلي والسيطرة المالية عبر المقاصة تجعل أي خطوة نحو التنمية رهينة للقرار السياسي الإسرائيلي. الحواجز، البوابات، وقيود الوصول إلى الأراضي القريبة من المستوطنات أو مناطق C تحرم المزارعين من أرضهم، وتدمر محاصيلهم أو تُسرق، فيما تقطع طرق النقل الأسواق المحلية والخارجية، وتزيد كلفة الإنتاج، فتُضعف الاقتصاد كله وتزيد البطالة والفقر، بينما تبقي السكان في دائرة الاعتماد على المساعدات والتحويلات الخارجية.
إن ما سبق جاء نتيجة اتفاق باريس، الذي ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، وجعل منه اقتصاداً هشاً ومرهوناً بالقرارات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وخلال السنوات السابقة، كان الاقتصاد الفلسطيني يعاني من ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وانتشار البطالة المقنعة، نتيجة السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى إضعاف الاقتصاد الوطني الفلسطيني. ومع ذلك، تجلت هذه الأزمة بصورة أكثر وضوحًا بعد أحداث أكتوبر 2023، نتيجة تعجرف السياسات الإسرائيلية في فلسطين، سواء في غزة أو الضفة الغربية، مما أدى إلى زيادة حدة البطالة والجوع والفقر ودمار البنية الاقتصادية بشكل ملموس.
مع بداية أكتوبر 2023، تجلّت هشاشة الاقتصاد الفلسطيني بوضوح، حيث لم تعد المقاصة مجرد أداة لتحصيل الإيرادات، بل تحوّلت إلى وسيلة إسرائيلية للاستثمار السياسي والاقتصادي ضد الفلسطينيين. فقد استُخدمت أموال المقاصة لتعويض المستوطنين أو عائلاتهم عن أي عمليات فلسطينية، مثل تحويل ملايين الشواكل لعائلات مستوطنين قُتلوا أو تعرضوا لعميات فلسطينية، في حين كانت السلطة الفلسطينية بحاجة ماسة لهذه الأموال لصرف رواتب الموظفين أو تمويل الخدمات الأساسية.
إلى جانب ذلك، استخدمت إسرائيل جزءاً من هذه الأموال لبناء البوابات العسكرية في الضفة الغربية، التي تُقدر تكلفتها بما يقارب 12 مليون دولار، بهدف تعزيز السيطرة على الحركة الفلسطينية وفرض قيود إضافية على وصول المواطنين إلى أراضيهم وأسواقهم. كل هذا أدى إلى تدمير الاقتصاد الزراعي في الضفة، حيث تُنهب الأراضي، وتُدمَّر المحاصيل، ويُسلب المزارعون من مواردهم، بينما تُبقى الأسواق مغلقة أمام الإنتاج المحلي بسبب القيود المستمرة، مما يزيد البطالة والفقر ويجعل السكان أكثر اعتماداً على المساعدات والتحويلات الخارجية.
اليوم، باتت مسألة تقييد السوق الفلسطيني والبطالة والفقر جزءاً من سياسة ممنهجة، تصب مباشرة في جوهر الاستراتيجية الإسرائيلية المتطرفة تجاه الفلسطينيين، لا سيما فيما يتعلق بالضم، الاستيطان، والتهجير، سواء كان قسرياً أو حتى طوعياً تحت ضغوط الحياة الاقتصاديةوالسياسية والاجتماعية، حيث تتحكم إسرائيل بكل مفاصل الحياة الفلسطينية بما فيها الاقتصاد، المعابر والحدود، إلى الحواجز والطرق، بحيث تُعجز الفلسطينيين عن الوصول إلى أراضيهم وأسواقهم، أعمالهم ويصبح كل ذلك جزءاً من آلية مستمرة لإضعاف القدرة الاقتصادية الوطنية وفرض السيطرة الكاملة على حياة السكان.
الواضح اليوم أن إسرائيل كلما واجهت تحركاً دولياً أو شعبياً داعماً لفلسطين، حتى لو كان رمزياً، صعّدت سياساتها على الأرض لتفريغ هذه التحركات من مضمونها. فمثلاً اعتراف دولي شكلي بدولة فلسطين ترافق مع زيادة البوابات العسكرية، وتحويل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة، في محاولة لقطع الطريق أمام أي إمكانية لقيام كيان فلسطيني مستقل. ومع كل دعم شعبي لغزة أو تحرك لأساطيل الإغاثة، تقابل إسرائيل ذلك بتكثيف القصف والتدمير، وفرض سياسة تجويع ممنهجة، إلى جانب منح الضوء الأخضر للمستوطنين لممارسة إرهابهم في الضفة الغربية. هذه السياسة تهدف إلى إيصال رسالة للعالم مفادها أن أي دعم للفلسطينيين لن يغير من واقع السيطرة الإسرائيلية، بل سيؤدي إلى مزيد من العقوبات الجماعية.
لكن المفارقة الكبرى تتكشف في الداخل الإسرائيلي نفسه. فبينما يرى الفلسطيني في هذه السياسات أدوات قمع وتهجير وإبادة، بدأت قطاعات من المجتمع الإسرائيلي تدرك أن هذا النهج، الذي يقوده وزراء مثل سموتريتش وبن غفير، لا يحقق “إسرائيل الكبرى” ولا يضمن الأمن، بل يغرق إسرائيل في عزلة دولية ويفجّر تناقضاتها الداخلية. فالسياسات المتطرفة، من الضم والتوسع وإطلاق يد المستوطنين، عمّقت الانقسامات بين تيارات ترى أن هذا التوجه يقضي على فرص الاستقرار والتطبيع، ويحوّل إسرائيل إلى دولة منبوذة بعد أن تم الاعتراف بها وأصبحت صديقة لعدد من الدول خاصة العربية، وبين أخرى تتمسك بخطاب “القوة والسيطرة” مهما كانت الكلفة. انعكست هذه التناقضات على الشارع في مظاهرات متواصلة ضد حكومة نتنياهو، وصراع متصاعد بين المؤسسة العسكرية الحذرة من الانزلاق في حروب مفتوحة، والتيارات اليمينية المتطرفة التي ترى في التصعيد وسيلتها الوحيدة لترسيخ مشروعها. وهكذا، كلما صعّدت إسرائيل ضد الفلسطينيين لتثبيت مشروعها الاستيطاني، عمّقت الشرخ داخلها وكشفت التناقض بين وهم السيطرة وواقع الانقسام والضعف الداخلي.
فالاقتصاد الفلسطيني لم يعد مجرد ضعف تقني، بل أصبح جزءاً من آلة سياسية لإفقار الفلسطينيين، مصادرة مواردهم، وفرض السيطرة عبر البوابات والحواجز والضم والاستيطان، مما يحوّل الأرض إلى كانتونات معزولة ويزيد هشاشة المجتمع. ومع تصاعد العنف بعد أكتوبر 2023، تتراكم عوامل هدم الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل يجعل استمرار الوجود الفلسطيني بحدود مقبولة أمراً شبه مستحيل.
ويبقى السؤال: هل يمكن أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني أسيراً لهذه السياسات الإسرائيلية التي تستخدم المال كسلاح والاقتصاد كأداة حصار؟ أم أن تفاقم الأزمات وتراكم الضغوط قد يدفع نحو إعادة التفكير في نموذج اقتصادي مقاوم، يربط بين الصمود اليومي وبناء بدائل استقلالية جزئية، تعزز بقاء الفلسطينيين وتُفشل مشروع الاحتلال في تقويض وجودهم؟
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .