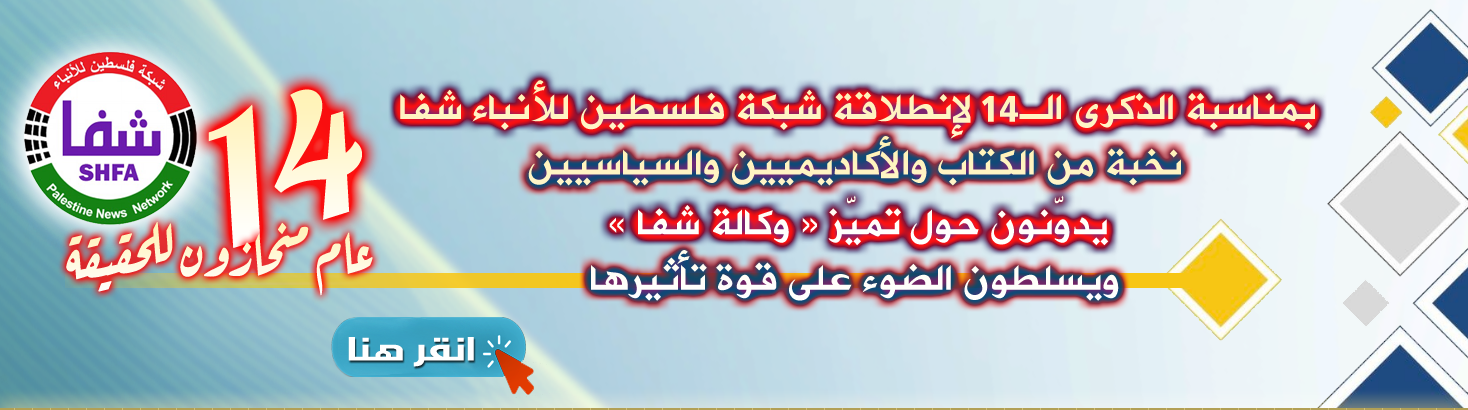محمود البريكان بين العُزلة والتأمّل: قراءة مُنمَّقة في كتاب بسمة الصباح ، بقلم: رانية مرجية
تمهيد
هناك كتبٌ لا تُقرأ، بل تُصغى. نصوصٌ تهبط على الروح همساً، حتى لكأن صفحاتها موسيقى خفيّة. هكذا تلقيتُ كتاب «محمود البريكان بين العزلة والتأمل» للكاتبة السورية بسمة الصباح؛ دراسةٌ نقدية تُحاول أن تُمسك بطيف شاعرٍ آثر الصمت على الضجيج، وغاب ليحضر أكثر، هو العراقي محمود البريكان. الكتاب يقع في نحو إحدى وتسعين صفحة، ويعتمد بناءً واضحاً بين تقديمٍ وتمهيدٍ ودراسةٍ ومختاراتٍ شعرية، الأمر الذي يجعل مدخل القراءة مُيسّراً لغير المتخصص، وواعداً للباحث معاً.
عن الكتاب ومادته
تنتخب بسمة الصباح محورين عميقين لمقاربة البريكان: العُزلة والتأمّل؛ لا بوصفهما حالتين نفسيّتين فحسب، بل بوصفهما عدستين لرؤية العالم ولِتشكُّل القصيدة ذاتها. تتوقف عند قصائد مختارة، وترافقها بشروحٍ تتلمّس الإيقاع الداخلي للغة، وتستجلي البنية الصورية التي توازن بين السكون والقلق، وبين الانطفاء والوميض. كما تُطعِّم قراءتها بمقتطفات سيرية وإشارات إلى أطوار التجربة، بحيث تُجاوز “القراءة النصيّة الخالصة” إلى قراءة سياقيّة تُضيء علاقة الشاعر بعالمٍ أراد أن يعبره في الظل.
محمود البريكان: الحضور من وراء الغياب
لم يكن البريكان من شعراء المَحافل؛ اختار العُزلة طريقاً معرفية وجمالية، فظلّ بعيداً عن صخب النشر والدعاية، الأمر الذي أسهم—كما تُذكِّر بعض التقديمات—في تأخر الاعتراف النقدي بمكانتِه، رغم شهادة مجايلين كبار بقيمته. هذه المفارقة—قلّة الظهور وغزارة الأثر—هي مفتاحٌ لفهم نبرة القصيدة لديه: قصيدةٌ تُحاور المطلق بلغته اليومية، وتعبر من التفاصيل الصغيرة إلى أسئلة الكينونة.
خرائط العُزلة والتأمل
تُقارب بسمة الصباح العُزلة عند البريكان كخيار معرفي: انكفاءٌ يوفّر للذات مسافة نظر، لا هروباً من العالم بل عبوراً إليه من منفذٍ أكثر شفافية. في المقابل، يأتي التأمّل بوصفه الحركة البطيئة للوعي وهو يُصغي لما تحت السطح: لِخَفَر الأشياء، للظلّ الذي ينساب من المعنى، وللغة وهي تُجرِّب أن تقول ما لا يُقال.
بهذه الثنائية تُعادِل الكاتبة بين الهدوء الظاهر والتوتّر الكامن في القصيدة: زمنٌ كتابيّ يمشي على رؤوس أصابعه، وصورٌ تتوهّج بقدر ما تتخفّى. هنا تبرع القراءة في التقاط اقتصاد البريكان اللغوي: كلمات قليلة، لكنّها مُحمّلة بعمقٍ دلاليّ، وبمعجمٍ لا يخشى المفاهيم العالية حين تستدعيها الضرورة الشعرية.
أدوات القراءة: من الصورة إلى الإيقاع الداخلي
لا تُراهن بسمة الصباح على المصطلح الأكاديمي البارد؛ لغتها ناقدةٌ ومتذوِّقة في آن. حين تتتبع رمزاً يتكرر (نهرٌ غامض، ظلٌّ مُقيم، أبدٌ يلوح كمِقدار)، فإنها لا تُسقط شبكة مفهومية جاهزة، بل تُصغي لبُرهة الصورة وهي تتخلّق في المشهد. هذا النَّفَس يمنح الكتاب قابلية القراءة خارج أُطر الجامعة، ويُبقيه، في الوقت نفسه، مُفيداً للباحث الذي يحتاج أمثلة مشروحة على بناء الصورة وتناميها عبر النص.
لغة بسمة الصباح: بين الدرس والبوح
لغة المؤلفة عذبةٌ من دون ترخُّص، وصافيةٌ من دون فقرٍ اصطلاحي. تُحافظ على مسافة احترام مع النصّ الشعري: لا تُحاصره بتعريفات، ولا تتركه بلا سياق. نبرة الكتاب—كما شعرتُ بها—هي نبرة مرافقة: ناقدةٌ تمشي بجوار القصيدة، لا أمامها ولا وراءها، تُشير إلى ما ترى وتدع القارئ يراه بذاته. في مواضع عديدة، تُضيء التقديمات المصاحبة (ومنها تقديم كاظم حسن سعيد) الخلفيّة التاريخية والتلقّي النقدي وتجربة الشاعر مع “الندرة” و”العزوف”، فتؤطِّر الدرس بجسرٍ وثائقي مُطمئن.
ما الذي تُضيفه هذه الدراسة إلى مكتبة البريكان؟
1. تركيز عدسة واحدة على ثنائية كبرى: حين نجعل العُزلة والتأمّل مركز الثقل، نتمكن من رؤية الخيوط التي تشدّ القصائد بعضها إلى بعض؛ فتغدو التجربة، في تنوّعها، ذات مشغلٍ واحد: تحويل الصمت إلى معرفة، وتحويل المعرفة إلى جمال.
2. توليف النص والسيرة: يُتاح للقارئ أن يربط بين التحوّلات الجمالية والملابسات الحياتية من غير تهويلٍ أو اختزال؛ فيرى كيف تُضيء محنة القلق الوجودي طريقةَ بناء الصورة والإيقاع.
3. لغة وسيطة: لا تُغرق الدراسة في الجدل النظري، ولا تكتفي بالذائقة الانطباعية؛ إنها لغة وسط تُشرك القارئ وتُرضي الباحث.
مساحاتٌ يمكن توسيعها
ولأن القراءة حبٌّ ومساءلة، فإنني أرى أن الكتاب كان سيزداد ثراءً لو أضاف:
• مقارنات مع تجارب عزلة وتأمّل لدى شعراء عرب (كعبد الوهاب البياتي أو يوسف الخير الله) أو عالميّين، لتبيان الفرادة والاشتراك.
• شذرات منهجية صريحة (تلقّي/بويطيقا/سيمياء الصورة) في ملحقٍ موجز، تُعين القارئ الأكاديمي على وضع القراءة في حقلٍ نقديّ واضح.
• زمنيةٌ أشمل للاختيار في المختارات الشعرية، كي تغطي مراحل إضافية وتُظهِر تَبدّل “إيقاع الصمت” عبر الزمن.
خاتمة: الشعر كحُجّة للوجود
يضعنا كتاب بسمة الصباح أمام شعرٍ لا يملأ الفضاء بقدر ما يُضيء الفراغ. يذكّرنا البريكان أن الغياب قد يكون أبلغ أشكال الحضور، وأن القصيدة، حين تُنصت طويلاً، تكتشف ما لم تكن اللغة تعرف أنها تعرفه.
ذلك بالضبط ما تفعله هذه الدراسة: تُعيد إلينا الشاعر من منفاه الاختياري، وتضع في يد القارئ خيطاً دقيقاً ليتتبع أثره بين العُزلة والتأمّل—بين صمتٍ يُفكِّر، وكلامٍ يلمع كالندى
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .