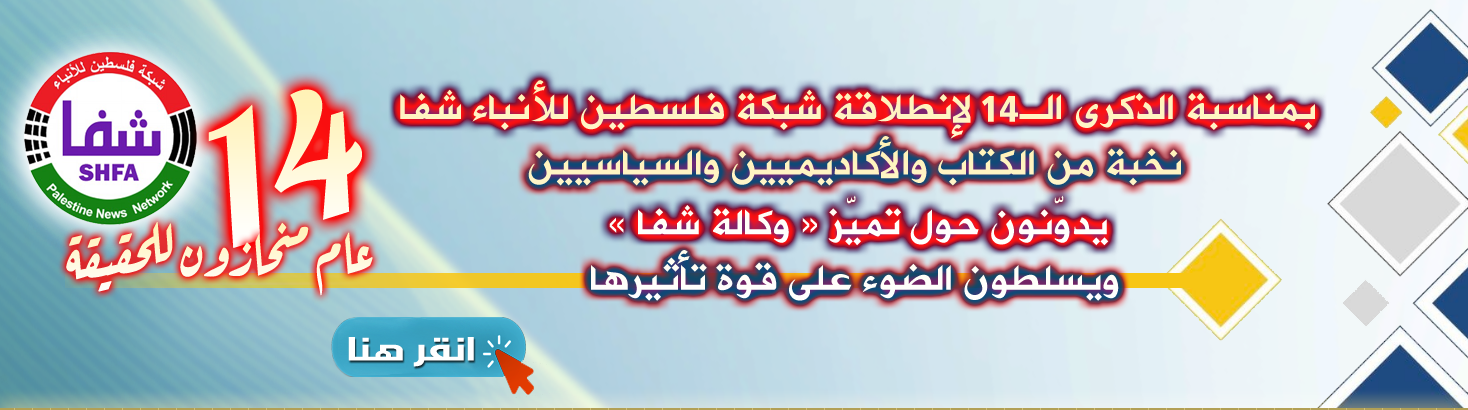قصة قصيرة بعنوان : ولادة الشمس في الزنزانة رقم 13 ، بقلم : غدير حميدان الزبون
لم تكن الزنزانة التي تحمل الرقم (13) في سِجِلّ سجن الرملة سوى فم إسمنتي مفتوح على ظلام أبدي.
جدرانها الرطبة تتصبّب عرقًا باردًا كأنها شربت من دموع من سبقوها.
سقف رمادي مقيت منخفض يوشك أنْ يهبط ليلامس رؤوس الأسيرات، كأنّه سماء كاذبة تحتال على الغيوم، فتعلو بمقدار عنق متمردة اشرأبّت على أسيادها، لكنّ السماء الحقيقية لم تكن فوقهن، فما برحت تنبض في قلوبهن.
المصباح المتدلي من زاوية السقف يُلقي ضوءًا أصفر باهتًا يترنح مع كل نسمة هواء تتسلل من شقوق الجدران، فيبدو وكأنه شمعة تحتضر في معبد مهجور.
في الركن الأعمق والأشد ظلاما جلست ليان الأسيرة ذات العشرين ربيعًا، ببطنها الممتلئ بثمرة لم تعرف طعم الهواء الحر.
كانت تضم بيديها الدافئتين قبتها الصغيرة كما تضم القدس قبابها.
كلّ موجة ألم تمر في جسدها أشبع برصاصة تشقّ طريقها في قلب المعركة، تتحامل على الوجع وتتحايل على نفسها دون فائدة، يخبرها حدسها بأنّ الموعد اقترب، فتهمس في جوفها مثل البتول : “يا ليتني متُّ قبل هذا وكنت نسيا منسيًّا”.
في الممر القريب يتردّد وقع حذاء السّجّان في إيقاع بارد، لكنّ قلب الزنزانة كان ينبض بوطن يتأهب لمخاض ولادة جديدة.
اقتربت أمّ عاصم أقدم الأسيرات عمرًا وأسرًا بوجهها المحفور بالتجاعيد كخريطة فلسطين، وبعينيها العميقتين كسرداب في معبد كنعاني، جلست قرب ليان وهمست:
“تذكّري يا بنتي، نساؤنا ولدن أطفالهن تحت أشجار الزيتون، وبين جيوش الغزاة، وأمام حصون المستعمرين، وفي ليالي الاجتياحات، فلا تقنطي من رحمة الله.
آهٍ يا بنيتي، كنّا نغسل المولود بدموع المطر، وإنْ لم نجد المطر غسلناه بعرق الصبر.
هذه الليلة ستلدين وسيولد الوطن معك”.
بدأت الانقباضات تتسارع، والأنفاس تضيق، والدائرة تتّسع بعيون الأسيرات الصافية كالينابيع.
التفّت الأسيرات حول ليان مثل الكاهنات يحرسن سرًّا مقدسًا.
ومع هبوط الظلام أكثر وأكثر ارتفع نشيد قديم بصوت منخفض ثابت:
“يا أرض قومي، يا سنابل انهضي، من رحم الحجر يولد القمح، ومن عتمة القبر تقوم الشمس”.
كانت ليان ترى الكلمات قبل أن تسمعها. رأت عشتار تصعد من العالم السفلي، وتحمل في يدها سنبلة وفي اليد الأخرى طفلًا، والحقول من حولها تكتسي خضرة بعد موت طويل.
في لحظة من الألم الشديد شعرت أنّ أسطورتها تُكتب الآن، وأنّها سطر في ملحمة فلسطين الكبرى.
في ومضات الوجع المميت عادت ليان بذاكرتها إلى قريتها.
رأت أباها يزرع شجرة لوز على حافة الحقل ويقول لها:
“هذه الشجرة لكِ يا ليان، إذا كبرتْ قبلك ستظلّك، وإذا كبرتِ أنتِ ستظلّينها”.
وفي صرخة ألم جديدة تذكرت أمها وهي تطرّز فستان عرسها قبل أن يختطفها الاعتقال، وتذكرت البحر الذي وعدت نفسها أن تُريه طفلها يومًا.
ثم عاد الألم ليقطع الخيط، ويعيدها إلى حاضرها، إلى جدران الزنزانة.
جاء الوجع الأخير كالمدّ يجرف كلّ ما قبله.
شعرت ليان بروحها تغادر جسدها، واستسلمت فركعت باتجاه القدس، وضغطت بكل ما تبقى في جسدها من قوة.
صرخت صرخة مقاومة وخرج الطفل عاريًا يصرخ بالنشيد الوطني.
امتزجت دموع الأسيرات بدم الولادة، وكانت الجدران ترتجف من صدى البكاء، وكأنها لم تُبنَ لتكتم الصوت، بل لتحفظه.
فتح السجّان الباب بوجهه الجامد، لكنّ عينيه ارتجفتا للحظة حين رأى الطفل ملفوفًا بكوفية صغيرة خبأتها ليان في قلبها منذ أول ليلة تحقيق.
رفعت ليان الطفل عاليًا كأنها تقدمه للشمس نفسها، وقالت بصوت اخترق الحديد:
“هذا ابني، ابن النور الذي لا يُسجَن، وهذا السجن لن يكون له بيتًا”.
بعد لحظات هبّت ريح باردة من شقوق الجدار، وأطفأت المصباح، فغرق المكان في عتمة مقدسة، لكنّ بكاء الوليد ظل يتردّد في الأروقة كأول طلقة في معركة التحرير.
ابتسمت ليان مدركة أنّ الحرية سبقتها إلى الحياة على هيئة طفل، وأنّ أبواب السجون مهما أُحكم إغلاقها لا تصمد أمام صرخة الميلاد التي تشقّ صمت الليل كما تشقّ السنابل قشرة التراب، حاملة معها فجرًا يتسلّل من بين القضبان، ليكتب على جدران الزنزانة أول سطر في ميثاق الوطن.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .