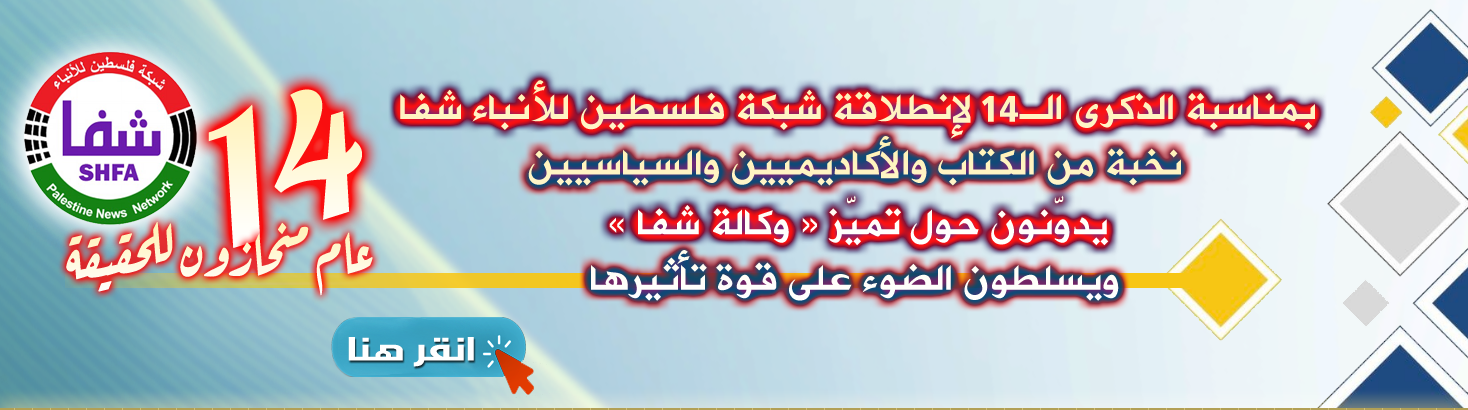قصة بعنوان : “بيتٌ من حُبٍّ تحتَ الرُّكام” ، بقلم : غدير حميدان الزبون
في صباح غزّيّ ثقيل مدّ البحر يده إلى الشاطئ ليمسح شيئًا من الرماد العالق على وجه المدينة، بينما الطائرات تحلّق مثل طيور سوداء تبحث عن فريستها.
هناك في الأزقة الضيقة كان الأطفال يركضون بين الجدران المهدّمة، يضحكون للحظة، ثم يختفون عند أول غارة جويّة.
وفي قلب الركام، بين حجرٍ وحجر، ظلّت يدٌ صغيرة ممدودة كأنها تبحث عن دمية ضاعت في الفوضى، أو عن صدرٍ يضمّها من وحشة العالم، بجانبها وريقات مبعثرة من دفتر مدرسيّ، بعضها يحمل حروفًا لم تُكمل كلماتها، كأنّ اللغة نفسها قُصفت قبل أن تُولد.
أمّا البيت بيت الحُبّ ذاك، فقد بقي واقفًا كهيكلٍ من صمتٍ وحجارة، تحرسه نافذة محطمة تُطلّ على البحر، كأنها عين عاشقة لم تنطفئ بعد.
كان في داخله سرير مكسور، وفستان عرسٍ أبيض علِق بشوكة حديدية، يتأرجح مع الريح مثل روحٍ مُعلقة بين الغياب والبقاء.
ومع كلّ نفحة نسيمٍ آتية من البحر، كان الركام يتهامس:
هنا كان حُبٌّ يعيش، هنا كان وطنٌ يتنفّس، هنا بيتٌ لم يمت بعد.
وسط هذا المشهد خرجت مريم من بيتها الصغير في خانيونس.
حملت حقيبتها الجلدية التي صارت أثقل من جسدها: كاميرا، أوراق، قلم، وبعض بقايا الطعام لزميلها المصوّر إبراهيم، الذي لم يعرف منذ أيام طعم الخبز.
كانت مريم تقول لنفسها:
“لن أسمح للحرب أنْ تسرق وجه الحقيقة حتى لو سرقت حياتي”.
في زاوية الصحفيين بمجمع ناصر الطبي، كان المشهد أقرب إلى مسرحية عبثية.
غسان يمازحهم: “اليوم سأغطي خبراً حصرياً وسيكون سقوط قذيفة على قذيفة”.
أحمد يكتب تعليقًا ساخرًا: “لو كانت الصواريخ تعرف الصحافة، لأرسلت إلينا اعتذاراً قبل أنْ تهدم السقف”.
ضحكوا جميعًا، حتى مريم ضحكت من قلبها، رغم أنها تعلم أنّ الضحك هنا مجرد هدنة صغيرة مع الحزن الكبير.
حين يسدل الليل ستاره، كانت مريم تكتب في دفترها لابنها غيث.
كانت تكتب رسائل صغيرة، وصايا مخبّأة بين الأوراق:
“يا غيثي، يا كلّ قلبي، إنْ سقطتُ يوماً، لا تدع دموعي تجرّك للهاوية، ابتسم في وجهي حتى لو لم تجدني، ابنِ بيتك من حبّ، لا من حجر، سمِّ ابنتك مريم، كي أعود معك في كل نداء”.
ذلك الدفتر لم يكن دفترًا عادياً، بل كان جسرًا بين الحياة والموت.
في لحظة سكون، استرجعت مريم طفولتها أمامها.
الأزقة التي لعبت فيها، شقائق النعمان التي كانت تضعها على ضفيرتها، قصص أمها عن كنعان ومريم الأولى، قصص الأجداد عن بيوت البرتقال واللوز قبل أنْ تسرقها النكبة.
ضحكت وهي تتذكر أول تغطية لها: يوم طاردت قطة صغيرة سرقت الميكروفون، فسقطت على الأرض وسط تصفيق الأطفال.
كان رامي زميلها الأقرب يتهامس: “حتى القطط تريد أن تنقل صوت الحقيقة يا مريم”.
في اليوم التالي كان صباحًا عاديًا، جلس الصحفيون يتبادلون الأخبار الساخرة، والقطط تنام على الكاميرات، وفجأة دوّى انفجارٌ أول وفي لحظة صارت السماء جدارًا من نار.
تبعه انفجار ثانٍ فتطاير الزجاج وتطايرت الأوراق والكاميرات.
صرخ غسان: “احموا الدفاتر” قبل أنْ يسقط.
أما مريم، فقد ابتسمت للحظة أخيرة، كما لو أنها كانت تعرف أنّ قصتها يجب أن تُكمل خارج حدود الجسد.
بين الركام، عُثر على دفترها، كانت آخر صفحة تقول:
“غيث، لا تُصلِّ علي صلاة الموتى، بل صلِّ صلاة الحياة، لا تبكِ على ضحكتي، بل اضحك بها، وحين تسقط القذائف تذكّر أني كنت أضحك حتى من أعدائي، لا تكن ظلّي، كن أنت، غيث، عِشْ”.
في لحظة، غيث الصغير الذي لم يتجاوز عقده الأول، صار يحمل العالم على كتفيه.
لم يفهم الموت كما يفهمه الكبار، لكنه كان يسمع همسات أمّه في الليل، كأنها تتردّد مع هدير البحر.
زملاؤها الصحفيون صاروا يروون قصصها: كيف كانت تصرّ على دخول أكثر الأماكن خطورة، كيف كانت تضحك وهي تركض بين الركام، وكيف قالت ذات مرة: “أنا أكتب لأني أحبّ الحياة، وأحبّ الحياة لأني لا أستطيع أنْ أكره”.
وقف غيث على شاطئ غزة، البحر أمامه، والسماء فوقه، والمدينة خلفه، وفي يده دفتر أمه.
قرأ وصيتها بصوت مرتجف، ثم رفع رأسه نحو الأفق.
هل سيكبر غيث ليصبح صحفيًا يكمل رسالتها؟
هل سيبني بيت الحب الذي حلمت به؟
أم ستبتلعه حرب أخرى قبل أنْ يكتب سطره الأول؟
الجواب لم يُكتب بعد، تركته مريم في وصيتها، وتركت للقارئ أنْ يتابع الحكاية مع غيث، ومع غزة، ومع كلّ طفل يحلم وسط الركام ببيتٍ من حُبّ.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .