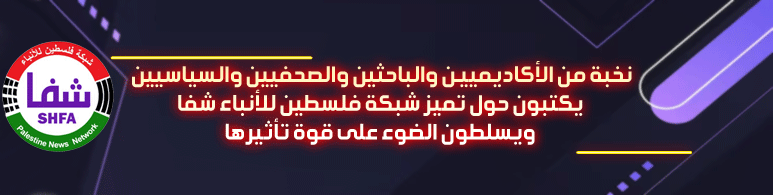إسطنبول… حين روى البحرُ حكاية القلبين ، ريشةُ المهندس محمد الدغليس وقلمُ المؤرخ وليد العريض
كانت إسطنبول – تلك المدينة التي تمشي على الماء وتنام على أكتاف التاريخ – تنتظر منذ زمنٍ طويل أن يرويها اثنان:
أحدهما يحمل الريشة والآخر يحمل القلم. الأول جاءها في نهاية الستينيات شابًا تفيض عيناه بالضوء والثاني دخلها في منتصف الثمانينيات وقلبه معقود على الحبر والحنين.
وما بين ريشةٍ ومعنى، قامت الحكاية…
الدغليس… حين كانت المآذن ترسم الفجر
في ربيع العام 1967 دخل محمد الدغليس إلى إسطنبول كما يدخل الحلم إلى العين.
سكن في ترلاباشي، على مقربةٍ من تقسيم التي كانت آنذاك عاصمة الألوان واللغات والضحكات.
كان طالبًا في كلية الهندسة المعمارية – جامعة إسطنبول التقنية (İTÜ)، يتعلّم كيف تُبنى المدن بالحب لا بالإسمنت وكيف تنطق الحجارة إذا صُمّمت بروح الفنان.
كلّ صباحٍ كان يعبر شارع الاستقلال نحو جامعٍ صغير يسمع منه الأذان قبل شروق الشمس، فيحسّ أنّ الضوء يولد من المئذنة لا من السماء.
في المقاهي القديمة كان يرسم العابرين على دفاتره: شيخًا يتفيّأ دخان التبغ عند الزاوية، امرأةً تمسح زجاج نافذتها لتلمع الحلم في عينيها وطفلًا يضحك للمطر كأنه يضحك للخلود.
في القرن الذهبي كان يرى المآذن تنعكس على صفحة الماء كأقلامٍ سماويةٍ تكتب سيرة المدينة، وفي بكركوي كان يتعلّم أن الجمال ليس في المشهد وحده، بل في الرؤية التي تحتضنه.
ومن بين خطوطه ودفاتره وليل الأزقة، كانت إسطنبول تتكوّن في داخله كمعمارٍ من ذاكرةٍ ودفءٍ وأصوات بشرٍ لا يُشبهون أحدًا إلا المدينة نفسها.
غادرها عام 1973 لكنّه لم يخرج منها يومًا؛ فقد بقيت في قلبه كقِنديلٍ لا ينطفئ وفي ذاكرته كلوحةٍ مفتوحةٍ على ضوءٍ لا يغيب.
العريض… حين صار التاريخ قلبًا يكتب بالحبر
وبعد عقدين من رحيله كان وليد العريض يطرق باب المدينة ذاتها في خريف العام 1986.
لم يدخلها سائحًا، بل تلميذًا في مدرسة الروح. كانت إسطنبول تمسح عن وجهه غبار الغربة وتقول له همسًا:
“هنا تبدأ حياتك الثانية…”
سكن في الفاتح على شارع بالي باشه جادسي حيث تختلط رائحة الخبز والسمسم بصوت الأذان وهدير الحياة.
التحق بـ جامعة إسطنبول – كلية الآداب (لالهلي) ليدرس التاريخ، لا كعلمٍ جاف، بل كجسدٍ من روحٍ تنبض بالحبر.
وفي الأرشيف العثماني عاش ستّ سنواتٍ بين الوثائق والمراسيم، يقرأ الحبر كأنه صلاة ويستخرج من كلّ سطرٍ أنفاس الذين مرّوا على هذه الأرض.
وفي تلك الأعوام وُلد ابنه أحمد في المستشفى الوطني عام 1987 فصار ميلاده رمزًا لوحدة الحياة بالمدينة، طفلًا يفتح عينيه على الأذان والبحر والحنين معًا.
رافق أصدقاءه: محمد التميمي، برهان الصمادي، أحمد أبوقديس، وحسين الجبور (رحمه الله)، تحت إشراف العالم النبيل محمد أبشرلي، فكانوا عائلةً صغيرة تحيا بالغربة وتتنفّس الصبر، وترفع صلاة الرجاء على ضفاف البوسفور كلّما ضاقت بهم الأرض.
وحين غادرها في 20 تموز 1992 لم يغادرها حقًا؛ فقد ترك في أرشيفها ملامحه وفي أزقّتها خطاه، وفي سمائها ابنه المولود من ضوئها. ترك فيها الباحث والعاشق والابن الذي لم يتعلّم الوداع.
حين التقت الذاكرتان في مرفأٍ واحد
واليوم حين تلتقي الذاكرتان عند مرفأ الحنين، تتجلّى الحكاية كاملةً:
المدينة التي رسمها الدغليس بخطوط الضوء وكتبها العريض بسطور الحبر،
المدينة التي لا تشيخ، لأن أبناءها لا ينسونها.
في إمينونو ما زالت رائحة السمك والكمّون تموج في الهواء،
وفي كاراكوي تلمع المقاهي كذكرياتٍ على حافة الموج،
وفي تشاملجا ترفع المآذن رأسها لتلمس الغيم،
وفي أوسكدار يهدأ البحر كقلبٍ وجد أخيرًا من يشبهه.
إسطنبول في هذه الحكاية، ليست مجرد مدينةٍ عتيقة،
بل وطنًا مؤقتًا يسكن الذاكرة إلى الأبد؛
هي التي جمعت المهندس الذي رسمها في دفاتره
والمؤرخ الذي كتبها في قلبه،
ثم جمعتهما بعد عقودٍ في لوحةٍ واحدةٍ وذاكرةٍ واحدةٍ وحنينٍ واحد.
إنها المدينة التي تغسل الحزن بالضوء
وتعلّم أبناءها كيف يصبح الحنين لونًا والتاريخ نبضًا والوداع وعدًا بالعودة.
هي إسطنبول… التي حين تُرسم تُحَبّ؛
وحين تُكتَب تُبعث من جديد.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .