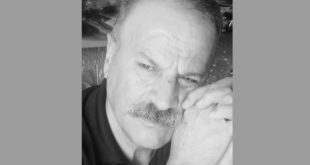“حين تنام الغفلة في حضن الجماهير” ، قراءة رانية مرجية في قصيدة «لا يهم» للشاعر جَنان السعدي
مقدمة
في زمنٍ تُختَزل فيه القصيدة إلى ترفٍ لغويّ، ويُستبدل الوجع بالاستعارة المكرورة، يظهر الشاعر جَنان السعدي ليعيد إلى الشعر وظيفته الأولى: النبش في الضمير الإنساني.
قصيدته «لا يهم» ليست نصًا عابرًا يُقرأ في غفلةٍ، بل مرآةٌ تفضح الغفلة ذاتها، تضع القارئ أمام نفسه بلا مواربة، وتمنحه فرصة نادرة للتأمل في ما صار إليه العالم العربي من تبلّدٍ، ورضا بالهوان.
- عنوانٌ يختزل الفجيعة
العنوان وحده – «لا يهم» – يُغني عن بيانٍ سياسي.
إنها جملة بسيطة، دارجة، تُقال عادةً لتبرير الفقد، لكنها في النص تتحول إلى قناعٍ ساخر للوجع الجمعي.
بهذه العبارة القصيرة، يهدم الشاعر جدار البلادة اليومية، ويُفجّر معنى اللامبالاة بوصفها أخطر أنواع الموت؛ موتًا بطيئًا لا يحتاج إلى رصاص، بل إلى قَبول.
- الغفلة ككائنٍ مدلل
حينما تنامُ الغفلةُ في أحضانِ الملايين
يُهَدهِدُها الثعلبُ وابنُ آوى…
هنا يبلغ الشاعر ذروة الصورة الرمزية.
الغفلة ليست فكرة أو مجرد سلوك، بل طفلة مدللة في حضن الوحوش، تُداعبها رقطاء السحر اللعين.
إنها صورة بديعة تجمع بين البراءة والافتراس، بين النعومة والخطر.
يُحوّل السعدي المشهد إلى مسرحٍ شعريّ تُدار فيه لعبة السلطة والجهل، حيث يهدّئ الثعلب الجماهير بأغاني الخلاص، فينام الوعي مطمئنًّا تحت خيمة الوهم.
- حين يصبح الشخيرُ نشيدًا وطنيًا
تعلو أنفاسُ الموتى بنداءِ الشَّخيرِ المستفحلِ العظيم
ما أعظم هذه السخرية، وما أوجعها!
يحوّل الشاعر “الشخير” إلى نشيدٍ وطنيٍّ للغفلة، صوتًا جماعيًا لمجتمعٍ يُحسن النوم أكثر من اليقظة.
إنه لا يتحدث عن موتٍ جسدي، بل عن موت الضمير، حيث يتحوّل الإنسان إلى جثةٍ تتنفس النسيان.
- بين البيان الثائر والوجدان الخائر
عُذراً لبيانٍ ثائرٍ… أن نامي أيتها الكائنات كما تشائين…
يستخدم الشاعر نبرة الاعتذار الساخرة ليهزأ من خطابات الثورة الفارغة.
ف “البيان الثائر” بات “خائرًا”، والنداء للتحرر صار دعوةً للنوم.
إنه يفضح تحوّل لغة المقاومة إلى طقوسٍ لغويةٍ بلا فعل، حيث تذوب الثورة في البلاغة، ويُدفن الغضب تحت وسادة العجز.
- الحقل والجراد: رموز البقاء المنهوب
لا تضجرْ من أسراب الجراد وإن أفسد الحقل…
تتراكم الرموز الزراعية في القصيدة (الحقل، البيدر، الزيتون، التين، النخيل) لتدلّ على العطاء والكدّ والارتباط بالأرض.
لكنّ الجراد – رمز الفساد – يلتهم الثمار دون مقاومة.
حتى حين يفسد كل شيء، يأتي الصوت المستسلم: «لا يهم».
إنها مأساة الإنسان الذي يتعلّم التعايش مع الخراب، حتى يصبح الخراب جزءًا من إيمانه.
- مفارقة العدالة: “لماذا يكدّ حمد ليأكل حمود؟”
في ذروة القصيدة، ينفجر السؤال الموجع:
سيّدي القائلُ
البيدرُ لعيالِ اللهِ…
لماذا يكدّ حمد؟ ليأكل حمود؟
هنا يعيد الشاعر طرح السؤال الأبدي عن العدالة، لا كفكرةٍ سماوية، بل كمعادلةٍ أرضية مقلوبة.
إنها صيحة العامل المطحون الذي يُستغلّ باسم الله والوطن، بينما ينام الآخرون على عرقه.
في هذا المشهد، يتحول الدين إلى خطابٍ مبرر للظلم، والكدّ إلى عبوديةٍ مقدّسة.
- شعرية السخرية: حين يصبح الوجع جماليًا
جَنان السعدي لا يصرخ؛ بل يبتسم بمرارة.
يمزج السخرية بالحزن، ويمنح القصيدة جمالًا مُرًّا، كزهرةٍ تنبت في الرماد.
إيقاع النص يتدفق بحريةٍ، والتكرار (“لا يهم”، “سيّدي القائل”) يعمل كجرسٍ يذكّر القارئ بأننا نكرّر جملنا أكثر مما نعيشها.
- الشاعر الذي عمّق الغفلة كما لم يفعل أحد
لقد طوّر السعدي مفهوم الغفلة من معنى ديني بسيط إلى منظور فلسفي شامل:
الغفلة ليست ضعفًا بل تواطؤًا، ليست غيابًا بل اختيارًا جمعيًّا.
وهنا تكمن عبقريته: أنه حوّل الغفلة من حالة إلى هوية.
فهو لا يلعن النائمين، بل يكشف لهم أن نومهم صار نظامًا للحياة، وأن “الاستسلام” بات عقيدةً اجتماعية تُورّث كما يُورّث الدين.
خاتمة
قصيدة «لا يهم» ليست مجرد نص، بل مرثيةٌ للإنسان العربي الذي نام في حضن البلادة، وسمّى نومه سلامًا.
هي صفعةٌ مكتوبة بحبرٍ ساخر، تذكّرنا بأن الوعي لا يُولد من الصراخ، بل من لحظة إدراكٍ مؤلمة:
أننا نحن من هدهدنا الغفلة، ونحن من قبّلنا رأسها قبل أن ننام.
رانية مرجية
كاتبة وناقدة فلسطينية
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .