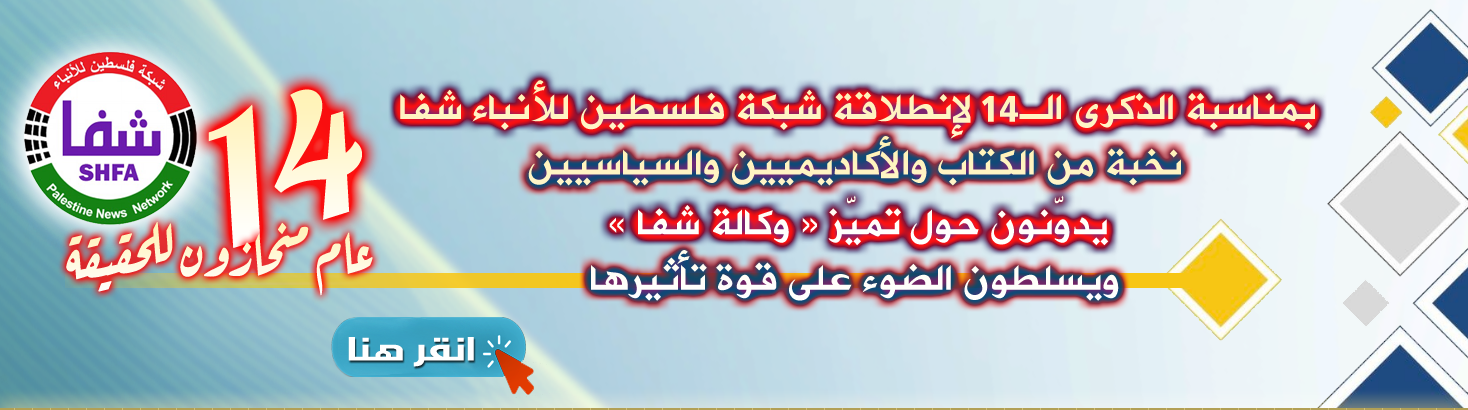قراءة نقدية يقدمها د. أحمد ناصر لقصيدة “من يحمي ويصون” للشاعر حسين جبارة
قصيدة من يحمي ويصون للشاعر حسين جبارة بنيت على سؤال متكرر يهيمن على فضاء النص: “من يحمي؟”، وهو سؤال يتجاوز دلالته المباشرة ليغدو صرخة احتجاج وقلق وجودي وسياسي في آن معًا. يستهل الشاعر قصيدته باستدعاء التراث القرآني من خلال إشارة واضحة إلى رحلة قريش “صيفًا وشتاءً”، لينتقل منها إلى واقع غزة المشتعل ومكة المهددة، رابطًا بين الماضي الذي حُمي بالمعجزة والحاضر الذي يواجه المصير ذاته بلا حامٍ ولا نصير. هذا التوظيف للإحالة القرآنية يتكرر عبر استدعاء قصة أبرهة والفيل، وصوت بلال، في تداخل يربط بين التاريخ المقدس والواقع المأزوم، ليؤكد أنّ المعضلة قديمة متجددة وأن الخطر لم يزل قائمًا بل صار أشد وقعًا.
من الناحية الفنية، تنتمي القصيدة إلى قصيدة التفعيلة (الشعر الحر)، حيث يظهر اعتماد الشاعر على تفعيلة المتدارك (فاعلن) مع تداخل ملحوظ لتفعيلة الرجز (مستفعلن)، لكنه لا يلتزم بالعدد التقليدي للتفعيلات في كل سطر، بل يوزعها توزيعًا حرًا ينسجم مع شحنة الانفعال ومع ما يفرضه المعنى. هذا التحرر من القوالب العروضية الصارمة أتاح للنص أن يحافظ على إيقاع داخلي نابض بالتكرار والجرس القوي، خصوصًا مع هيمنة صيغة الاستفهام المتكررة “من يحمي؟” التي تعمل كمحرك إيقاعي ودلالي في آن واحد. فالقصيدة، وإن بدت أحيانًا خطابية، تحافظ على نسق موسيقي يذكّر القارئ بحضور الإيقاع حتى في أكثر لحظاتها صخبًا وانفعالًا.
اللغة الشعرية هنا مشحونة بالرموز والتناقضات، حيث يقابل الشاعر بين المقدس والمدنس: “الصخرة من تدنيس حذاء”، “الكعبة تحت المنظار”، وبين الطهر والدمار: “يسجّي ويدفن أجسادًا دون لسان وأذان”. كما أن الرمز الحيواني يحتل مساحة بارزة: الفيل، الغربان، العقبان، وهي رموز لسطوة الغازي ووحشية المعتدي، في مقابل حضور الإنسان المقهور: الطفل الجائع، المهجَّر، والجماجم المدفونة. هذه الصور القاسية تعكس عبثية الواقع وتكشف عن مأساة الأمة التي تتعرض للنهش من الداخل والخارج.
أما من حيث المضمون، فالقصيدة تفضح ازدواجية المؤسسات الدينية والسياسية في تبرير القمع والخذلان، فتأتي صورة “إمام الحرم” المستسلم لتشير إلى التواطؤ بين الخطاب الديني الرسمي والسلطة القامعة، بينما يوازي ذلك نقد واضح للصمت العربي والإسلامي الذي يقف موقف العاجز أو المساير. ومع ذلك، لا تسقط القصيدة في اليأس الكامل، بل تفتح في ختامها أفقًا وحدويًا مشروطًا، حين تستدعي الرموز الكبرى من التراث الإسلامي: عمر وعلي، السني والشيعي، في إشارة إلى أن الخلاص لا يكون إلا بالتكاتف ونبذ الانقسام الطائفي. بهذا المعنى، تصبح القصيدة دعوة إلى التحرر من ربقة الخادم والآثم، وإلى استعادة القوة من خلال وحدة حقيقية تتجاوز الاصطفافات المذهبية.
إن نص حسين جبارة يمزج بين حرارة الخطاب السياسي ورهافة الحس الشعري، فيتحول إلى صرخة احتجاج عالية النبرة، تستند إلى طاقة الرموز القرآنية والتاريخية، وتستعين ببنية تفعيلية حرة تمنحه حركية وانسيابًا، وتستثمر في الوقت ذاته اللغة المأساوية المشبعة بالتناقضات. إنها قصيدة تستحضر الماضي لتدين الحاضر، وتستند إلى الإيقاع لتؤكد حضور الصوت، وتعلن بوضوح أن الحماية الغائبة لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف حقيقي يردّ عن المقدس والإنسان معًا.
وافر تقديري واحترامي لدكتور احمد ناصر على قراءته الناقدة لقصيدتي “من يحمي”.
شكرا للملاحظات الموضوعية وللتناول المهني. دمتم دكتور احمد سندا للبيان وللقصيد
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .