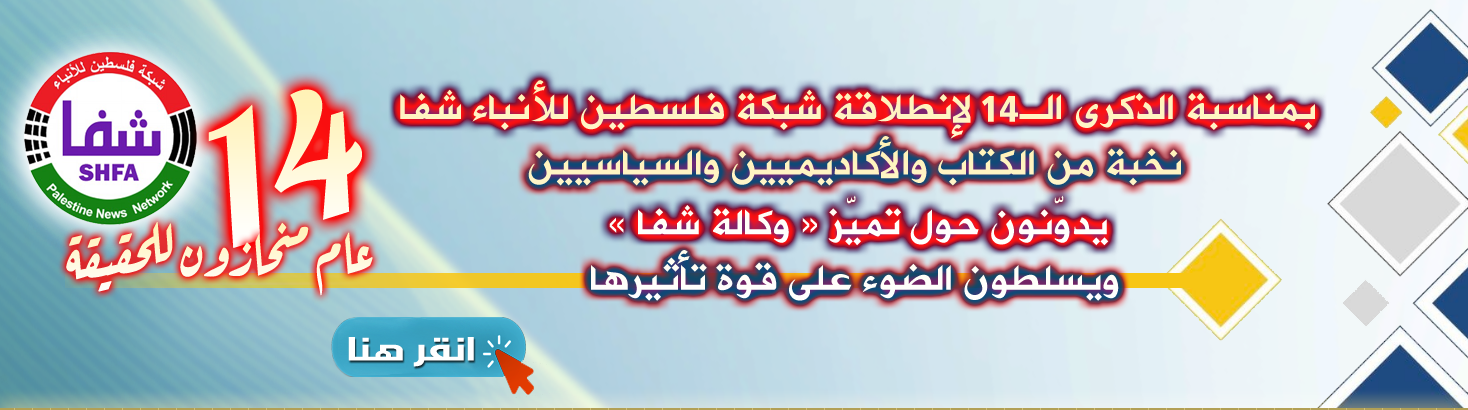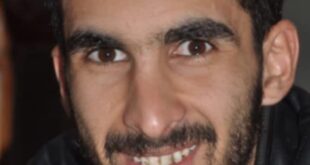تحليل ونقد سيميائي ، لكتاب ” الكتابة بأصابع مبتورة ” – للدكتور وائل محيي الدين ، الكتابةُ قدرٌ ، والقراءةُ نداءٌ ، بقلم : غدير حميدان الزبون
غدير حميدان الزبون تقرأ للدكتور وائل محيي الدين
كانت أولى مصافحتي لنصوص الدكتور وائل محيي الدين عبر نصّه الباذخ “مرافعات أمام ضمير غائب”، ذلك النص الذي يُقرأ ويُعاش بكلّ خفقة من القلب وارتعاشة من الضمير.
نصٌّ يتجاوز حدود الورق إلى الذاكرة الوطنية والإنسانية، فيجعل القارئ شريكًا في التجربة وشاهدا عليها.
كنتُ أتابع ذلك النص في كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر، فإذا بي أجد نفسي أمام مرآةٍ كاشفةٍ لتجربة الاعتقال الإداريّ التي يصفها الكاتب بعمق إنسانيّ نادر، تحت ما يسمّيه الاحتلال “الملفّ السرّيّ”، وهو في الحقيقة ملفّ الخوف من الوعي، والرهبة من الكلمة، والرعب من الحقيقة.
في قراءتي الأولى لذلك النص، لم أكن أقرأ سيرة أسيرٍ مجهول وإنما كنت أقرأ وجع فلسطين كلّها، هذا الوجع السّرمدي الذي لا نهاية له، والموزّع على الزنازين والانتظارات الطويلة.
كنتُ أقرأ وأرى ملامح أبناء شعبنا الفلسطينيّ المرابط في كلّ سطرٍ من سطور المرافعة، أولئك الذين يواجهون ظلم العالم بصبرٍ لا يكلّ، وبإيمانٍ لا يُهزم.
لقد وجدتُ نفسي كما وجد كثيرون من أبناء هذا الوطن في كلمات الأسير وهو يُحاكم الظلم أمام ضميرٍ غائبٍ عن العدالة، حاضرٍ في الوجدان.
ومنذ تلك اللحظة، لم تعد علاقتي بنصوص الدكتور وائل مجرّد متابعةٍ عابرة، بل باتت رفقة فكرية وروحية تفتّحت على ضفاف الكلمة.
ومع مرور الوقت، توثّقت بيننا صداقة أعتزّ بها على منصّات التواصل الاجتماعيّ، صداقة تتجاوز حدود الافتراض إلى توارد خواطر حقيقيّ في الأفكار والتجارب والرؤى.
كنّا نتبادل القراءة والرأي، ونحتفي بالكلمة الصادقة، وننحاز إلى الأدب الذي يُضيء الوعي ولا يغازل الزيف، حتى غدَت منشوراته على صفحته نافذةً تشرّع القلب على فكرٍ عميق، ورؤيةٍ متمرّسة، وقلمٍ ينهل من خبرةٍ وعمقٍ وشموخٍ وطنيٍّ لا يلين.
وقبل أيام معدودات جاد عليّ الدكتور بقراءة كتابه “الكتابة بأصابع مبتورة”، فكان ذلك الفيض الذي لا يُرتوى منه.
قرأتُه فكانت قراءته فتحًا جديدًا في المعنى، ودهشةً أخرى في اللغة، ومرافعةً ممتدةً في وجه الغياب.
وقفتُ أمام نصوصه كما يقف المتأمل أمام لوحةٍ حيّةٍ تنبض بالحياة والموت معًا؛ نصوصٌ تكتب عن الوجع الفلسطينيّ كونه قدرا إنسانيّا خالدا، وتكشف عن جمالٍ يولد من الرماد، وإيمانٍ يتجدد مع كلّ وجع.
لذلك راق لي أنْ أقترب من هذا العمل بقراءةٍ سيميائيةٍ نقديةٍ متأنّية، تنقّب في رموزه، وتستنطق لغته، وتُعيد اكتشاف العلامات التي يتخفّى خلفها وجدان الكاتب، في سعيٍ إلى فهم تلك الكتابة التي تُمدّدُ حضورها في الوعي مرّاتٍ متتالية دون أنْ تُتّهم إلّا بالصدق.
إنّها الكتابة التي تُقاوم البتر بقداسة الحرف، وتستبدل الأصابع بالضوء، وتحوّل الوجع إلى نشيدٍ للكرامة.
هذا الكتاب يخرج عن وصفه بمجموعة من المقالات الأدبية أو المقطوعات الوجدانية المتفرقة، إنّه بيان وجوديّ وإنسانيّ يكتبه صاحبه بأصابع الروح التي لم تُبتَر رغم بتر الجسد، وبدم القلب الذي لم يجفّ رغم طغيان الموت والخذلان.
“الكتابة بأصابع مبتورة” هو صرخة هُوية، ومرافعة عن الوعي، ومخطوط ألمٍ فلسطينيٍّ وعربيٍّ ينهض من بين الركام ليقول: ما زلنا هنا، نكتب كي لا تُمحى الذاكرة، وننقش الوجع كي يظلّ الوطن حيًّا في اللغة.
ينتمي هذا العمل إلى الأدب المقاوم، ولكنه يتجاوزه إلى أفقٍ أوسع؛ من خلال تحوّل الكتابة فيه إلى طقس خلاصٍ روحيٍّ، وإلى مساحة تأمل في معنى الإنسان، والهوية، والكرامة، والوطن، والموت، والحياة.
إنها كتابة تزاوج بين الدم والرمز، بين الحرف والجسد، بين الخطاب الجمالي والرسالة الإنسانية، فتمنح القارئ تجربة سيميائية مدهشة تُعيد تعريف معنى أنْ تكون كاتبًا في زمن الخراب، ومعنى أنْ تكتب وأنت محاصرٌ بواقع لا تجيدُ قراءته.
أولًا: العنوان علامة سيميائية كبرى.
العنوان “الكتابة بأصابع مبتورة” يشكّل مفتاح القراءة الرمزي للكتاب.
إنّه جملة متوترة بين طرفين متناقضين:
⦁ الكتابة: فعلُ خَلْق وبعث واستمرار.
⦁ الأصابع المبتورة: فعلُ فناء، وقمع، ومحو للجسد.
هذا التناقض السيميائي ينتج دلالة ثالثة، هي جوهر التجربة:
أنْ تستمر الكتابة رغم الألم، وأنْ يتحوّل الفقد إلى وسيلة للبقاء.
هكذا تتحول الكتابة إلى بِنية مقاومة، تُكتَب بالدم، ولا تسعى إلى الخلود الشخصي، وإنّما تهدف إلى إحياء الذاكرة الجمعية للأمة.
ثانيًا: سيمياء الفضاء النصي والموضوعي.
يتوزع الكتابُ على مجموعة من المقالات والخواطر والنصوص التأملية التي تنفتح على قضايا متعددة، لكنْ يجمعها محور روحي واحد: الإنسان في مواجهة القهر.
فالكاتب يرسم خريطة الألم الفلسطيني والعربي من غزة والقدس إلى السجون، والأعياد الدامية، وذكريات الشهداء، وينسج منها نسيجًا لغويًا يفيض رموزًا وصورًا واستعارات.
وكلّ فصلٍ من فصول الكتاب هو نافذة على جرحٍ مختلف، لكنّه في النهاية ينتمي إلى الجسد ذاته: جسد الوطن.
ثالثًا: سيمياء اللّغة والأسلوب.
اللّغة في هذا الكتاب هي كائن حيّ يتنفّس وينزف، حيث تتحول الكلمات إلى كواكب من الحزن والكرامة، ويغدو النصّ شبكةً من العلامات المشحونة بالدلالات:
⦁ التكرار:
كان وسيلة دلالية لإعادة تثبيت المعنى: “الكتابة نار، الكتابة ألم، الكتابة رسالة… “.
فالتكرار هنا إيقاع المقاومة الداخلية.
⦁ المجاز الجسدي:
تتحول اليد، والعين، والدم، والقلب إلى رموز سيميائية لحالة الأمة؛ فالجسد هو النصّ، والنصّ هو الوطن.
⦁ التناصّ الديني والوطني:
يستحضر الكاتب آياتٍ قرآنية، وأصداءً من درويش ونزار قباني ومظفر النواب، ليمنح خطابه عمقًا روحانيًا وثقافيًا، ويجعل النص ساحة تفاعل بين الأسطورة والواقع.
⦁ الإيقاع النفسي الداخلي:
الأسلوب يتراوح بين التقريري الحادّ والوجداني الشّاعري، فيخلق توازنًا بين الفكر والوجدان، وبين التحريض والبوح.
رابعًا: الوقفة على سمات الكاتب.
الدكتور وائل محيي الدين كاتب نادر الحضور في المشهد الثقافي الفلسطيني والعربي؛ إذ يجمع في شخصه بين وعي المثقف الثائر، وحسّ الشاعر الروائي.
من أبرز سماته الفنية والإنسانية:
⦁ الصدق الوجداني:
فهو لا يكتب لتجميل الواقع، بل ليوقظه، ونصوصه تنبض بدم القلب لا بزخارف البلاغة.
⦁ التزامه الوطني والإنساني:
الدكتور وائل محيي الدين يرى الأدب مسؤولية لا هواية؛ فكلّ كلمة عنده شهادة، وكلّ سطر موقف.
إنّه كاتب يقف في خط النار بالكلمة، كما يقف المقاوم بالبندقية.
⦁ عمق الرؤية الفكرية:
يتعامل محيي الدين مع القضية الفلسطينية على أنّها قضية وجودية – وأخلاقية – وحضارية.
⦁ شاعرية الرؤية السردية:
حتى في نصوصه المقالية، تسكنه روح الشاعر، والجملة عنده تتنفس وتغنّي وتقاوم.
⦁ قدرة نادرة على التحويل السيميائي:
فهو يحوّل التفاصيل اليومية (الأذان، المحكمة، العيد، السجن…) إلى رموز كونية تتجاوز الحدث إلى الأسطورة الإنسانية الكبرى: أسطورة البقاء رغم الفناء.
خامسًا: سيمياء الأصوات والمكان والزمان.
- الأصوات:
لديه معجم غني من مفردات الصوت (الأذان، صراخ الأطفال، أنين الأمهات، وغيرها الكثير)، وكلها تتحول إلى علامات صوتية ترسم ملامح هوية المكان.
فحين يكتب عن الأذان في القدس، لا يتحدث عن عبادة فحسب، بل يفوق ذلك ويسمو ويتجذّر في حديثه باحثا عن نبض الأرض حين تتلو شهادة الوجود. - المكان:
القدس: وجه الأرض حين تبتسم رغم الجراح.
غزة: اسم للكرامة المكتوبة بالنار.
السجن: ليس مكانًا للانكسار، بل مختبر الحرية الباطنية. - الزمان:
زمن الكتابة زمن جريح؛ يدور في حلقة من الفقد، لكنه لا يستسلم.
ففي كل دورة ألمٍ يولد فجرٌ صغير — تلك هي سيمياء البعث في فكر الكاتب.
سادسًا: الرموز المركزية.
البعد السيميائي الدلالة الرمز
فعل خلاصٍ من الفناء الحياة رغم البتر الكتابة
جسد الوطن الجريح ضريبة الحرية الأصابع المبتورة
تحوّل الموت إلى معنى الخلود في الوعي الجَمعي الشهيد
اختبار الصبر والرجاء الزمن المعلّق الأسير
حاضنة الخصب والمقاومة الأرض / الأم / الذاكرة المرأة
ضمير الأمة في أصفى صوره البراءة المذبوحة الطفل
سابعًا: البنية الخطابية والرسالة الفكرية.
الكاتب يقدّم نموذجًا فريدًا من الكتابة الملتزمة الجمالية؛ فهو لا يفصل بين الجمال والرسالة، بل يرى في الجمال أسمى أشكال المقاومة.
إنّ الكتابة لدى الدكتور وائل محيي الدين فعل أخلاقي، ووصيّة الإنسان للإنسان كي يبقى صوته حيًّا.
ففي عالمٍ فقد المعنى، يقدّم لنا محيي الدين نصًّا يذكّرنا بأنّ الكلمة ما زالت قادرة على أن تكون سيفًا، ودمعة، ورايةً، وجرحًا مفتوحًا على أملٍ لا يُطفأ.
الكلمةُ وطنٌ آخر.
في ختام هذا التحليل، يمكن القول إنّ “الكتابة بأصابع مبتورة ” بيان لنهجٍ فكريٍّ وجماليٍّ جديد، يكتب الوطن بالحروف كما يُكتب بالدم.
إنه نصّ يتجاوز حدود المقالة إلى فضاء الأسطورة الإنسانية، حيث تلتقي فلسطين مع كلّ أرضٍ مصلوبة، ويلتقي الكاتب مع كلّ إنسانٍ يكتب رغم فقدان اليد.
ففي عالمٍ أُغرِق في الصمت، يجيء صوت الدكتور وائل محيي الدين كأذانٍ جديدٍ في وجه العدم، ويُعيد للكلمة رسالتها المقدسة، ويُعيد للكتابة معناها الأول بأنْ تُولد من الرماد لتُبقي الحلمَ حيًّا.
ولأنّ الوطن لا يُكتب إلّا بالوجع، ولا يُخلّد إلّا بالحبر الممتزج بالدم، فقد استطاع هذا العمل أنْ يخلّد سيمياء الحرف المقاوم، ويجعل من كلّ جملة رايةً تُرفع على أسوار الذاكرة الفلسطينية والعربية.
وهكذا تتحول “الأصابع المبتورة” إلى أجنحةٍ تكتب، وتقاوم، وتنهض…
فلا تموت اللغة، ولا يُهزم الوطن، مادام ثمة كاتبٌ يكتب بيدٍ من نور.
حُرِّر يوم الثلاثاء، الرابع عشر من تشرين الأوّل/أكتوبر عام 2025م،
الموافق للعاشر من ربيع الآخر لعام 1447هـ،
في بيتِ لحم، في غرفةٍ تطالع نجمَ الوطن وتُصغي لنبضِ التاريخ،
قربَ حائطٍ يستندُ على مكتبةٍ حرّةٍ تهمسُ للحلم وتُنصتُ للكتب.
غدير حميدان الزبون
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .