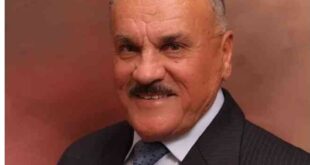قراءة شاملة لنص: “حين يعلو الصوت وتخفت الروح” للكاتبة رانية فؤاد مرجية ، بقلم : طه دخل الله عبد الرحمن
النص:
في أعماق النفس الإنسانية، ثمّة معركة خفيّة تدور كل يوم: معركة بين الرغبة في أن نُسمَع وبين القدرة على أن نُفهَم. كثيرًا ما نرفع أصواتنا، لا لأننا نعشق الصراخ، بل لأننا شعرنا أنّ همساتنا لا تجد من يصغي إليها. وكثيرًا ما نتصرّف بخباثة، لا لأننا نميل للشر، بل لأن البراءة وحدها بدت عاجزة عن حمايتنا في عالمٍ يزدحم بالمخالب.
الفيلسوف نيتشه يقول: “من يصرخ هو من لم يُستمع إليه طويلاً.” وهذا الصراخ، في جوهره، ليس إلا إعلانًا يائسًا عن وجودنا. هو صوت الجرح حين لا يجد دواء، هو احتجاج الروح حين يلتفّ الصمت حولها كقيد.
أما الخباثة، فهي الوجه الآخر للصرخة: التفاف العقل حين تُغلق أمامه الطرق المستقيمة. ليست دائمًا شرًا خالصًا، بل شكل من أشكال البقاء. ماكيافيلي لم يُخفِ هذه الحقيقة حين قال: “من أراد النجاة في عالم لا يرحم، عليه أن يتعلّم كيف لا يكون حملاً دائمًا.” وهكذا، يتعلّم الإنسان أحيانًا أن يستعير من الذئب مكره، ليحمي قلبه من أن يُفتَرس.
لكن السؤال الفلسفي الأعمق:
هل نحن حقًا بحاجة إلى الصوت العالي والمكر كي نثبت وجودنا؟
أم أنّ الحاجة الحقيقية هي إلى إعادة تعريف القوة؟
سقراط علّمنا أن القوة ليست في الانتصار على الآخرين بل في الانتصار على الذات. حين نملك أنفسنا، نصبح أحرارًا، حتى لو كُبلت أيدينا. أما غاندي، فقد جعل من الصمت قوة حين قال: “في اللحظة التي نؤمن فيها بقدرتنا على تغيير العالم باللاعنف، نصبح أقوى من أي جيش.” فالقوة إذًا ليست في العنف اللفظي ولا في الخباثة، بل في الثبات الأخلاقي الذي لا ينكسر.
ألبير كامو يذهب أبعد من ذلك حين يصف عبثية هذا العالم. في نظره، الصراخ والخداع قد يكونان استجابة طبيعية لعبث الوجود، لكن الإنسان الحقّ هو الذي يحوّل العبث إلى فعلٍ إيجابي، إلى تمرّدٍ يثبت المعنى بدل أن يذوب فيه.
نحن إذن أمام خيارين:
• إمّا أن نترك الآخرين يحددون طريقة ردودنا، فنصرخ ونناور وفق ما يفرضونه علينا.
• وإمّا أن نعيد تعريف صوتنا، فنختار الحزم الهادئ بدل الصراخ، والحكمة العميقة بدل الخباثة.
إبكتيتوس، الفيلسوف الرواقي، لخّص هذا بقوله: “من يملك نفسه، يملك العالم.” إنّ السيطرة على انفعالاتنا ليست ضعفًا، بل ذروة القوة. حين نختار أن يكون صوتنا ثابتًا، واضحًا، هادئًا، نحن لا نقلّل من قوتنا، بل نضاعف أثرها.
إنّ الصوت العالي والخباثة قد يمنحاننا انتصارًا لحظيًا، لكنهما يسلباننا السلام الداخلي. أمّا الحزم الواثق، الهادئ، فهو الذي يمنحنا ما هو أبقى: كرامة لا تُباع، وأثرًا يتردّد حتى بعد أن نصمت.
خاتمة وجدانية
أحيانًا، يا صديقي القارئ، نحن لا نحتاج إلى أن نعلو أكثر، بل أن نهدأ أكثر. لا نحتاج أن نكون أذكى من الآخرين بخباثة، بل أن نكون أصدق مع أنفسنا بصدقٍ يوجع لكنه يحرر. الحياة قصيرة جدًا لنضيعها في الصراخ، ومليئة بما يكفي من الجراح لنزيد عليها مكرًا. فلنترك لصوت أرواحنا المجال، ذاك الصوت الهادئ العميق الذي لا يعلو لكنه يبقى، لا يخدع لكنه يوجّه، لا ينطفئ لكنه يضيء.
في النهاية، من يملك صوته الداخلي، يملك نجاته.
القراءة:
يعالج هذا النص إشكالية وجودية ونفسية عميقة تتعلق بصراع الإنسان الداخلي بين حاجته للتعبير عن ذاته وبين الطرق التي يختارها للقيام بذلك. تنتقل الكاتبة ببراعة من التشخيص إلى التحليل الفلسفي ثم تقديم الحل والخلاصة الوجدانية.
- التشخيص: تشريح أعراض الضياع الإنساني
تبدأ الكاتبة بتشريح حالتين بشريتين شائعتين:
علو الصوت (الصراخ): لا يتم تقديمه على أنه عدوانية، بل كلغة أخيرة للضعيف. إنه *رد فعل على إحساس عميق بـ “عدم الإنصات”. الصراخ هنا هو تعبير عن جرح نفسي “صوت الجرح حين لا يجد دواء” واحتجاج على الصمت القسري الذي يفرضه المحيط “احتجاج الروح حين يلتفّ الصمت حولها كقيد”.
*الخباثة (المكر): لا يتم تصويره على أنه شر مطلق، بل كآلية دفاع ووسيلة للبقاء. هو نتاج شعور بأن البراءة والسذاجة لم تعدا كافيتين في عالم قاسٍ عالمٍ يزدحم بالمخالب. إنه انعكاس لخيبة الأمل من فشل الطرق المستقيمة والأخلاقية في تحقيق الأمان.
*الخلاصة: الكاتبة تخلع عن هاتين الآليتين صفتهما الأخلاقية المطلقة (شر مطلق) وتضعهما في إطار سيكولوجي (استجابة للجرح والخوف) واجتماعي (نتاج لبيئة قاسية). هذا يتيح للقارئ فهم جذور السلوك بدلاً من إدانته فحسب. - الإطار النظري: البنية الفلسفية للحجج*
تقوم الكاتبة ببناء حجتها على مدارج فلسفية متعددة ومتكاملة:
*فلسفة القوة والضعف (نيتشه): تستشهد بمقولة نيتشه لتؤسس لفكرة أن الصراخ تعبير عن ضعف مُزمن (عدم الاستماع) وليس قوة.
*فلسفة الواقعية السياسية (ماكيافيلي): تستخدم فكرة ماكيافيلي لتبرير، ولو مؤقتاً، آلية الخباثة كضرورة واقعية للنجاة في عالم لا يرحم، مستعيرة استعارة الذئب والحمل.
*فلسفة الفضيلة والأخلاق (سقراط): هنا تبدأ في قلب الطاولة على التصور السابق. تقدم سقراط كنموذج لإعادة تعريف القوة، من قوة خارجية (الانتصار على الآخر) إلى قوة داخلية (الانتصار على الذات). هذه هي النقلة النوعية في النص.
فلسفة اللاعنف والمقاومة (غاندي): تقدم غاندي كنموذج عملي يتحدى كل المفاهيم التقليدية للقوة. القوة هنا ليست في الصوت العالي بل في *الصمت الواعي، ليست في العنف بل في **الثبات الأخلاقي.
فلسفة العبث والتمرد (ألبير كامو): تذهب لأبعد حد بوضع المشكلة في إطارها الوجودي. إن الصراخ والخداع هما استجابة “طبيعية” للعبث، لكن الإنسان “الحقيقي” هو من *يتمرد على هذا العبث بخلق معناه الخاص عبر الفعل الإيجابي والأخلاقي.
هذا التدرج من نيتشه (الوصف) إلى كامو (الحل الوجودي) يبني حجة قوية ومتعددة الأبعاد. - الحل: الرواقية وإعادة التعريف
بعد التشخيص والتحليل، تقدم الكاتبة حلها الذي يستقي روحه من الفلسفة الرواقية بشكل واضح، ممثلة بإبكتيتوس:
*الخياران: تضع القارئ أمام مفترق طرق: أن يكون ردة فعل يسيره الآخرون، أو أن يكون فعلًا نابعاً من ذاته.
*إعادة التعريف: جوهر الحل هو *إعادة تعريف مفاهيم القوة والصوت والذكاء.
*القوة ليست في الصراخ بل في الحزم الهادئ والسيطرة على الانفعالات.
*الصوت الحقيقي ليس هو العالي، بل هو الثابت، الواضح، الهادئ الذي يضاعف أثره.
*الذكاء ليس هو الخباثة، بل هو الحكمة العميقة.
*المكاسب والخسائر: توازن الكاتبة بين المكاسب قصيرة المدى للخباثة والصراخ (انتصار لحظي) وخسائرهما طويلة المدى (السلام الداخلي)، وبين مكاسب القوة الهادئة (كرامة دائمة، أثر باق). - الخاتمة الوجدانية: النداء الإنساني
تتحول الخاتمة من خطاب تحليلي إلى خطاب وجداني مباشر موجه إلى صديقي القارئ. هنا تستخدم الكاتبة لغة شعرية مؤثرة:
*التقابل: لا نحتاج إلى أن نعلو أكثر، بل أن نهدأ أكثر، الصدق مع أنفسنا بصدقٍ يوجع لكنه يحرر.
*الحكمة الوجودية: “الحياة قصيرة جدًا لنضيعها في الصراخ، ومليئة بما يكفي من الجراح لنزيد عليها مكرًا”. هذه الجملة هي خلاصة النداء الإنساني للنص بأكمله.
- الاستعارة الشعرية: صوت الأرواح الهادئ العميق الذي يضيء ولا ينطفئ وهو نقيض الصراخ الذي يعلو لكنه قد يخفت.
- الخصائص الأسلوبية والبلاغية
- اللغة: لغة شعرية مشبعة بالصور البلاغية (التشبيهات والاستعارات) التي تنقل الأفكار المجردة إلى مشاعر محسوسة (الروح والقيد، الجرح والدواء، المخالب).
- البناء المنطقي: بناء محكم يبدأ من العام (المعركة الخفية في النفس) إلى الخاص (الأمثلة والتجليات)، ثم ينتقل من السؤال الفلسفي إلى حلّه الخيارات والحلول.
- الإيقاع: استخدام الجمل القصيرة المفعمة بالحكمة (“من يملك صوته الداخلي، يملك نجاته”) والتي تخلق تأثيراً قوياً وبليغاً في القارئ.
الخلاصة:
“حين يعلو الصوت وتخفت الروح” هو أكثر من مقال؛ هو درس في الفلسفة العملية للحياة. إنه يدعو القارئ إلى مراجعة أدواته في التعامل مع العالم، محذراً إياه من أن وسائل الدفاع العاطفية (الصراخ، الخباثة) يمكن أن تتحول إلى سجون له. النص هو تصريح ثقة بالإنسان وقدرته على اختيار *القوة الأصيلة النابعة من امتلاك النفس والثبات الأخلاقي، التي تمنحه نصراً أبعد أثراً وأكثر ديمومة من أي انتصار لحظي يمكن أن تمنحه إياه آليات الضعف المُقنَّعة بقناع القوة.
طه دخل الله عبد الرحمن
البعنه – الجليل
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .