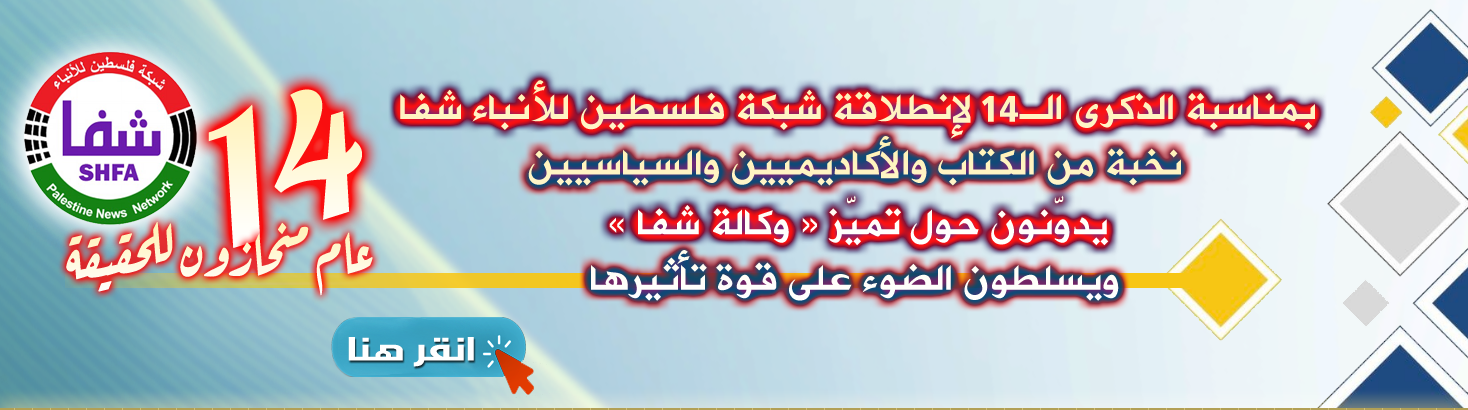قصة قصيرة بعنوان : جدار الفراق ، بقلم : غدير حميدان الزبون
في قرية صغيرة منسية كحلمٍ انطفأ على أطراف الخريطة، وفي قلب الجغرافيا الممزّقة التي تشبه رقعة قماش مهترئة خيطتها الحروب، كان الصمت سيّد المكان، فلا يُسمع إلا صدى الرياح وهي تتسلل بين الأزقة كعازفٍ أعمى يبحث عن نغمة ضائعة حاملةً في طياتها عبق الزمان، ورائحة حكاياتٍ لم يجرؤ الغبار على دفنها.
هناك، كانت نور الحالمة تحيا بين ظلال الزهور التي تزين جدران منزلها البسيط، عيناها تلمعان بالبراءة والأمل، وقلبها يواصل نبضه ويتغذى على الحلم.
حلمها الذي كان بعيداً لكنّه مستمر، تحلم أنْ تتزوج من سامي ذلك الفتى الذي أسر قلبها.
وفي الزقاق الآخر على تلّة مجاورة كان سامي ذلك الشاب العصامي يمتشق في كلّ يوم سلاح عزيمته الوحيد، ليتسلق جدار الفصل العنصري الذي كان يعزل بينه وبين أحلامه.
وفي ليلة مقمرة جلست نور قرب نافذتها تسترق من السماء بريق نجومٍ تظنها رسائل من سامي، وتُصغي إلى هدير البحر البعيد كما لو كان يحمل صوته من وراء الأسلاك.
أيقنت نور أنّ المسافة بينها وبين سامي ليست أميالًا ولا حواجز إسمنتية، بل امتحانًا تصوغه الأقدار؛ ليرى إنْ كان الحب قادرًا على اجتياز متاهات الأرض.
أما سامي فقد اعتاد كلّ فجرٍ أنْ يوقظ قلبه قبل جسده، يربط حذاءه المهترئ، ويحمل حقيبته الصغيرة المليئة بالكتب وأوراقه المبللة برائحة الحلم، ثم يمضي صوب الجدار الذي بدا مثل كائن أسطوري ضخم يتغذى على خوف البشر.
مع تنفُّس كلّ فجر يتقدّم بخطوات ثابتة رتيبة فيلمس الإسمنت البارد بأصابعه وكأنه يقرأ نقشًا منقرضًا، ثم يرفع رأسه إلى السماء موقنًا أنّ للغيوم طرقًا أخرى لا تعرفها البنادق.
كان الخيط الخفي يمتدّ بينهما، هو حبلٌ من نورٍ يمرّ بين الثقوب الصغيرة في الجدار، ويحمل أصداء الضحكات القديمة، ورائحة الربيع حين كانا يتراكضان بين أزهار الحقول.
لم يكن الجدار بالنسبة لهما نهاية، بل بداية أسطورة تتشكل، حيث يتحوّل الانتظار إلى سيف، والحنين إلى جناحين، والحب إلى نشيدٍ يتردّد في صدور العصافير العائدة عند الفجر.
كانا يؤمنان أنّ يومًا من الأيام سيكلّ الحديد من الوقوف، وتنهار الحجارة كما ينهار الصمت أمام صرخة الحياة، وسيمدّ سامي يده من بين الغبار فتمسكها نور، ويعبرا معًا نحو الضفة الأخرى من الحلم، حيث لا فوّهات ينبعث منها الرصاص، ولا جدار، ولا فصل، ولا نهاية.
كبر سامي في أحضان قريته التي طالما لعب فيها مع أقرانه على أطلال الحجر الصغير.
هناك، يتقاسم الأطفال الضحكات كما يتقاسمون الخوف من غدر الزمان.
كان سامي فتى قوي القلب يملك روحاً لا تعرف اليأس، وعزيمة لا تفارق قلبه، إلّا أنه مثل باقي أبناء الأرض كانت له قصته الخاصة.
فبعد أنْ سقط والده شهيدًا على جدران المستحيل تضاعف عبء الحياة على قلب سامي، واضطر لترك دراسته ومغادرة قريته التي شهدت ولادته، ليكمل مسيرة والده في التضحية.
كان يقطع كلّ يوم مسافات طويلة على درب الجدران، يتسلل تحت الظلال الكثيفة التي يخلقها جدار الفصل العنصري كي يصل إلى مكان عمله في الداخل المحتل.
أميال وأميال يقطعها في صمت، لكنّ قلبه كان ينبض بالأمل في كل خطوة، وأذنه تلتقط همسات وعده لنور الفتاة التي أحبها منذ الطفولة.
وعدٌ قطعه على نفسه أنْ يفي به عندما تنقشع سحب الزمن ويصبح بإمكانه أنْ ينقذها من غربة المكان، ويعيدها إلى حضنه فتكون بداية جديدة تحت سماء حرة.
كان الليل من حوله كثيفًا، يتربّص كصيادٍ ماهر، لكنّ عينيه كانتا ترى ما وراء الظلام؛ ظلّ نور وهي تبتسم في ذاكرته كان أقوى من كل عتمة.
كلما ضاقت الدروب كان يسمع نبض الأرض تحت قدميه، يذكّره بأن جذوره أعمق من الجدار وأصلب من الحجارة.
في جيبه الصغير ورقة مطوية كُتبت بخطّ مرتجف: “سأنتظرك عند شجرة اللوز التي تعرفها فلا تتأخر”.
كان يعرف أنّ الوصول إليها لن يكون نزهة، بل عبورًا في قلب الخطر فأبراج المراقبة لا تنام، وأصابع البنادق تتربّص بكل ظلّ يتحرك.
ومع ذلك مضى نحوها وهو يسير على حدّ أسطورةٍ قديمة، تقول إنّ من يواجه الجدار بقلب لا يعرف الخوف، تفتح له الأرض ممرًّا خفيًا، وتغطيه السماء برداء من الغيم.
كل خطوة كانت تقترب به من نقطة اللاعودة، وكل نبضة كانت تصرخ في داخله: إمّا أن تعود بها، أو لا تعود أبدًا.
عند آخر المنعطف، لمح في البعيد شجرة اللوز وحولها وهجٌ غامض، كأنها الحارس الأخير للحلم، أو بوابة عبورٍ إلى زمن بلا قيود.
لكنه لم يكن يعلم أنّ هناك من يترصّده خلف الظلال، وأنّ اللقاء المنتظر قد يفتح أبوابًا لمغامرة أعظم مما يتخيّل، وأنّ الجدار اللعين سيقف بجسده المنيع، ويتفوّق على رصاصة هزيلة تنطلق من بندقية أحد هواة القتل.
في ليلة ساكنة كانت نور تطوف حول الزهور في حديقة بيتها، تشم رائحة الياسمين الذي يفتن الذاكرة ويسافر بالحلم.
كانت تتخيل سامي عائدا من متاهة العمل يحمل معها وعده، لكنه كان يتأخر في العودة.
أيقنت أنْ لا شيء يمكن أنْ يتأخر في هذا العالم سوى الأمل، وأنّه حينما نترقب عودة الغائب فإننا نعيش في فقاعة من الأمل الزائف.
ذات مساء وفي ذروة الوجع بدأ صمت القرية يعمّ كغيمة سوداء، وكأنّ الأرض نفسها تحبس أنفاسها.
كان الجميع يعلم أنّ سامي في ذلك اليوم كالعادة قد تسلق الجدار، وتسلل خلف سياج الاحتلال، ولكنْ هذه المرة كانت النهاية مريرة.
ففي اللحظة التي كان فيها سامي يركض بين الحقول لاهثاً تحت مطاردة جنود الاحتلال، كانت روحه قد أضحت أثراً في الرياح، وفي الذاكرة.
سقط عن الجدار وجسده ارتطم بالأرض، لكنّه كان يبتسم، وكأن روحه قد تحررت أخيراً من قيد الملاحقة.
وصل الخبر إلى نور، وهي في مكانها وسط الزهور، كأن السماء قد انشقت تحت قدميها.
تحطمت زهور الياسمين التي كانت تعانق يديها، وسقطت قطعاً صغيرة من قلبها. كان موت سامي ليس إلا رمزاً للخيبة التي كانت تكمن في كل خيط من خيوط الزمان حيث تحققت النبوءة بأنّ الملاحقة لا تنتهي إلا بالاستشهاد، لكنّ قلبها بقي يتمسك بذكرى وعده، وصوته الذي كان يهمس لها كلّ ليلة: “سأعود إليكِ يا حبيبتي”.
وفي لحظة انقطاع الأمل، وبينما كانت الشوارع قد امتلأت بالحزن خرجت نور إلى الجدار الذي أصبح هو الآخر شاهداً على مأساة الحب، وعلى النضال الذي لا ينتهي، وقفت هناك في مواجهة الجدار العنصري تحدق في ذلك الذي كانت تحلم أن يتسلقه يوماً ما ليأتي إليها، لكنها الآن كانت ترى فيه أكثر من مجرد جدار فصل.
كانت ترى فيه رمزاً لوحدة قلبين لا تفرقهما المسافات.
وفي تلك اللحظة شعرت أن روح سامي كانت تراقبها من بعيد بين الذكريات والهواجس، في كل رفّة ريح، وفي كل شعاع ضوء يخترق الأفق.
شعرت بروحه كأنها تُلامس قلبها، وتهمس لها: “إنني هناك، حيث لا ينتهي الأمل، ولا ينفصل العشق عن الأرض”.
ثم رفعَت عينيها نحو السماء في لحظة اكتمال القمر، وكأنّ نور كانت على موعد مع القدر، وأخذت تردد بين شفتيها بصدق وحب ودموعها تتناثر:
“سامي، سأنتظرك حتى يكون في القلب مكان لك”.
الزمن قد يمر، والجدار قد لا يُهدم، لكنّ أرواح المحبين، مهما كان الفراق قاسياً لا تغيب؛ إنها تتسرب بين شقوق الحجارة كالماء السرمدي، تهمس في أذن الريح، وتوقظ الندى على وجنات الصباح.
وفي اللحظة التي يظنّ فيها العالم أنّ الحكاية انطفأت تتّقد في العتمة شعلة لا يراها إلا العاشقون، شعلةٌ حملتها النجوم منذ فجر الخلق، لتدلّ التائهين نحو مواسم اللقاء.
فما الجدار في النهاية إلا ظلّ، وما الحب إلا النهر الذي يحفر مجراه في قلب الصخر حتى يُعيد للضفتين عناقهما الأول.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .