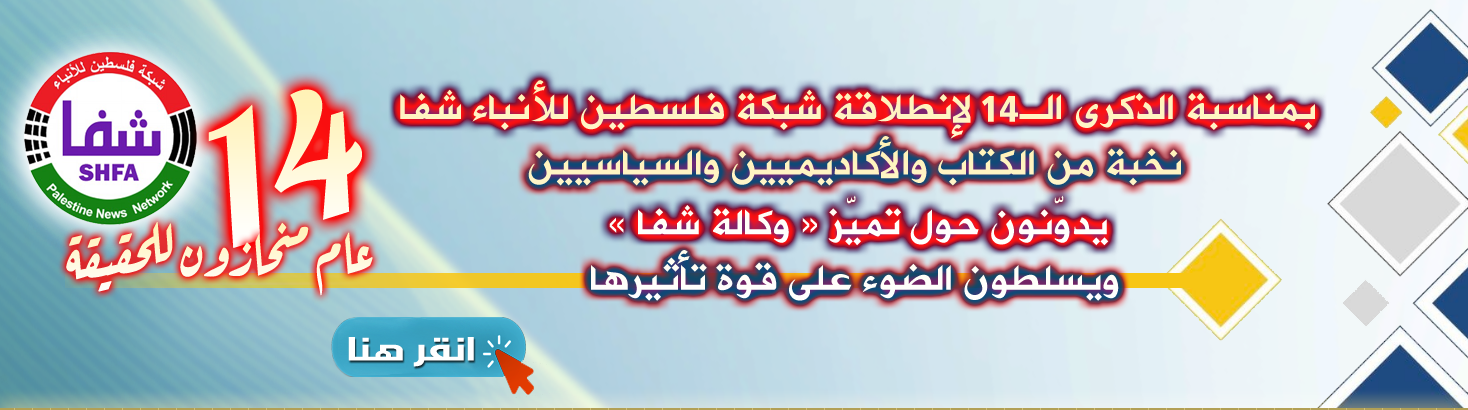قراءة وجدانية في قصيدة “مصر” للشاعر ناظم حسون ، بقلم : رانية مرجية
منذ أن أطلق الشاعر ناظم حسون أولى كلماته في قصيدته “مصر”، ندرك أننا أمام حالة شعرية تتجاوز الوصف المباشر إلى عشقٍ صوفيّ، لا يرى في مصر مجرد وطن، بل “معنى”، و”هوية”، و”مصير”. القصيدة التي ألقاها في أمسية إحياء ذكرى الزعيم الخالد جمال عبد الناصر في بلدة أبو سنان، جاءت أشبه بنشيد وجدانيّ مغمّس بحبٍّ لا يتقن المواربة.
بين التاريخ والعاطفة
يبدأ الشاعر قصيدته بنداء للشِّعر نفسه، كأنّه يستحثّه ليعلو فوق ذاته، ليكون على قدر المقام، في حضرة الكيان الذي اسمه مصر:
في حضرةِ النيلِ جُدْ بالشِّعرِ يا شِعْرُ
واخْشعْ جلالاً وحُبًّا… إنَّها مِصْرُ
هذا النداء يحوّل القصيدة منذ البدء إلى طقسٍ احتفاليّ وجدانيّ، كأنّ مصر ليست بلدًا بل كيانًا حيًا يجب أن تُستقبل فيه بالكلمة الطاهرة والنبض الخاشع. في هذا البيت وحده تتلخّص الفكرة الكبرى: مصر ليست موضوعًا للكتابة، بل معبَر روحيّ لا تكتبه الأقلام بل تعيشه الأرواح.
مصر: كونيةُ الأثر، خالدةُ الحضور
في كل بيت، يتصاعد المديح من ثنايا التاريخ، ليس كشعارات جوفاء، بل كحقائق تسكن الذاكرة البشرية:
هُنا الحضارةُ والتّاريخُ قد وُلِدا
فالدِّينُ والعِلْمُ والعِمرانُ والفِكَرُ
أعطت أثينا وروما بعضَ ما بلغَتْ
منَ المعارفِ مِمَّا غالَهُ الذِّكْرُ
بهذا التصوير، يرسم الشاعر خريطة كونية تبدأ من النيل ولا تنتهي. هي مصر التي أنارت العالم، لا فقط بنفسها، بل بما أنجبته من رؤى وفكر وعمارة وروح.
صوت الأزمنة، وصدى القداسة
القصيدة تتنقّل بين العصور دون عناء، ففي سطر نجد وادي الملوك، وفي سطر آخر نجد موسى وعيسى، ثم يأتي عمرو، فتنفتح أبواب التأويل الديني والتاريخي والسياسي دفعة واحدة:
موسى وعيسى أقاما في مضافَتِها
فزالَ عنْها ظلامُ الجَهلِ والكُفْرُ
ونورُ أحمدَ بالإيمانِ ظَلَّلَها
لمّا تظَلَّلَ في أفْيائِها عَمْرُو
بهذا الدمج البديع بين الرموز الدينية الكبرى، يجعل الشاعر من مصر “حضنًا للرسالات”، و”قِبلةً للأنبياء”، و”رحمًا للحكمة”، لا تُطفئها العصور.
مصر كعاطفة لا تُكتب
عند هذا المقطع، تتبدّل النبرة من نبرة المادح إلى نبرة العاشق، العاشق الولهان، الذي لا يقوى على الإنكار، ولا يتقن الادّعاء:
أنا المُتيَّمُ، لا لَوْمٌ ولا عَتَبٌ
وقدْ تساوى لديّ السِّرُّ والجَهرُ
اللغة هنا تصبح ذاتية، داخلية، يتحدث الشاعر عن مصر كما يتحدث العاشق عن معشوقته. لا فرق عنده بين السر والعلن، لأن الحب بلغ به حدّ الانصهار.
ولعل أجمل انقلابٍ شعريّ في النصّ، هو حين يُسبغ على الأسر في حضرة النيل نكهة عذبة، لا قهر فيها:
قالوا بأنَّ الأسْرَ قهْرٌ وذِلَّةٌ
قلْتُ بِحِضْنِ النِّيلِ كَمْ يعْذُبُ الأسْرُ
هو إذًا أسر الحنان، لا أغلال القمع. النيل هنا ليس نهرًا، بل حضنًا أموميًا يحتوينا، حتى في ضيقنا.
من تمجيد الأرض إلى تمجيد الفكرة
ولأن المناسبة هي ذكرى الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، فإن القصيدة تنتهي حيث يجب أن تبدأ الذاكرة:
يا شمسَ ناصرَ لن ننساكِ مُشرقةً
وان أفِلْتِ سيبقى الفِكْرُ والذِّكرُ
هنا يختم الشاعر بنبرة وجدانية ناصرية عميقة، تمزج بين الحنين والإيمان. فناصر لم يكن “شخصًا”، بل “رؤية”. لم يكن زعيمًا عابرًا، بل ميثاقًا أخلاقيًا لا يزال يشعل قلوب الأحرار.
ختامًا
قصيدة “مصر” لناظم حسون ليست مجرد مدح ولا مجرّد تمجيدٍ مناسباتي. إنها سفر شعريّ يمتد من أزمنة الفراعنة حتى ضفاف النكسة والحلم القومي، ويعبر القلب كما تعبر ضفّة النيل الهادئة روح مصر الخالدة.
هكذا تُكتب القصائد حين تكون اللغة صلاة، والحبّ انتماء، والتاريخ يقظةً في الحرف، لا نوماً في متحف
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .