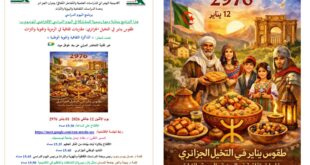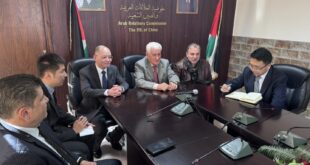“يا بني قابيل”… سفر اللعنة وبنيان الخراب عند إسلام شمس الدين ، قراءة نقدية ، بقلم : رانية مرجية
في نصّه الشعري المكثّف “يا بني قابيل”، يقتحم الشاعر المصري إسلام شمس الدين التاريخَ لا ليروي، بل ليُدين. لا ليتأمّل الأسطورة، بل ليكسرها، ويصوغ من شظاياها نبوءةً دامية لهذا العصر الذي انقلب فيه القاتل نبيًّا، والدم طقسًا يوميًّا، والصمت فضيلة مغشوشة.
تستند القصيدة إلى المرجعية الدينية التوراتية–القرآنية لحكاية “قابيل وهابيل”، لكن الشاعر لا يقف عند حدود الحكاية، بل يقتلعها من زمنها، ويزرعها في لحظة بشرية أكثر بشاعة: لحظتنا نحن.
الميثولوجيا كأداة محاسبة
يفتتح النص بنداءٍ تكراري قاسٍ:
“يا بني قابيل”
وهذا النداء لا يحمل رجاءً ولا حنانًا، بل هو بمثابة استدعاء إلى محكمة أخلاقية. إنّه صوت الشاعر وقد تحوّل إلى نبيٍّ ساخط، لا يبشّر بل يفضح. يخاطب أحفاد القاتل الأول لا ليُصلحهم، بل ليواجههم بميراثهم الدموي:
“إنما خُلقتِ الدنيا لأبيكم
فأمهرها سبعة قرابين
وأسكنها سبع أراضين
وأزكاها بدماء أخيه”
نحن أمام مشهد تأسيسي للعالم، لكنه تأسيس على جريمة. فالملك أتى بالدم، والسيادة جاءت بالذبح، وما سُمّي “الحياة” ليس إلا ميراثًا ملوّثًا.
من هذا التأسيس، تُبنى القصة الكبرى: قابيل، بحسب القصيدة، لم يكن فردًا، بل مشروعًا دائمًا للسيطرة، والقتل، والتوريث الفاسد.
هابيل… الصمت القاسي
بالمقابل، لا ينقذ النصّ هابيل من دائرة اللوم. فها هو يوصف بـ”العمّ الأخرق”، الذي يواري سوءته غراب، رمز الخراب والموت. وهذه صورة غير معتادة، إذ لا يُمنح هابيل هنا مجد الضحية، بل يُختزل إلى سذاجة تراجيدية لا تغير في مجرى التاريخ شيئًا.
كأن الشاعر يقول لنا: هابيل مات، ولم يبقَ منه سوى سكون القبر. أما من عاش، فكان من نسل القاتل.
صدمة الأنساب… حين يُحاكم الجذر
في الجزء الثاني من النص، تبلغ القصيدة ذروتها الصادمة:
“قد كان أبوكم قاتلاً
وكانت أمكم بغيّا”
هنا تتجاوز القصيدة حدود المسموح. إنها تشهّر بالنَسب، وتُسقط الطهر الزائف عن كل ما نعتقد أنه مقدّس.
قابيل ليس فقط قاتلاً، بل سلالة قاتلة. وأمه – الأم الأولى في النص – متواطئة إما بخطيئة جسدية أو بخطيئة الصمت.
البيان هنا ليس أخلاقيًّا، بل تفكيكيّ:
فالشاعر يهدم فكرة “البداية الطاهرة”، ويؤسّس لمراجعة نقدية لجذر البشرية. أنتم – يا بني قابيل – لستم ضحايا، بل أنتم استمرار الجريمة.
“وسبحوا باسم شيطانهما المقدس
يخلُ لكم وجه الدنيا
ولا تكونوا من بعدها قومًا صالحين”
في هذه الخاتمة، يبلغ النص درجة من السخرية السوداء المرعبة. فحتى “الشيطان” بات مقدّسًا، واللعنة صارت نظامًا عالميًّا، والدين اختُزل إلى أداة تبرير للدم، لا سبيلًا للرحمة أو التزكية.
اللغة: تشريح شعري للضمير الإنساني
أسلوب إسلام شمس الدين في هذا النص يتسم بالحدّة، والقصر، والتكثيف، مع إيقاع داخلي لا يعتمد الموسيقى التقليدية، بل يستمدّ موسيقاه من وقع الكلمات الثقيلة وصداها الأخلاقي.
لا زخارف لغوية، ولا استعارات غامضة. اللغة تشبه صفعة، مباشرة، دامغة.
تُستخدم المفردات ذات الطابع المقدّس (“قرابين”، “أراضين”، “شيطان مقدس”) لتؤكد الانزلاق الأخلاقي للإنسان، وتظهر كيف انقلبت رموز الطهر إلى طقوس دموية.
تأويلات ممكنة: من الموروث إلى الواقع السياسي
النص مفتوح على تأويلات متعددة.
يمكن قراءته كتأمل وجودي في أصل الشر،
ويمكن أيضًا إسقاطه على راهن عربي يفيض بالدم، حيث تتكرر أفعال قابيل يوميًا: في فلسطين، في المخيمات، في صمت العواصم، في إعلام يبارك القتل، وفي دينٍ تمّ تحريفه ليخدم الطغيان.
من هنا، يبدو أن “يا بني قابيل” ليست مجرد قصيدة، بل بيان شعري ضد كل نظام قتل باسم الحق، وضد كل تواطؤ صامت باسم السلام، وضد كل “أمّ” صمتت كي لا تهتزّ صورة العائلة.
خاتمة: جيلٌ يُحاكم جذره
إسلام شمس الدين لا يمنحنا عزاءً. إنه لا يكتب للطمأنة، بل لخلخلة ما نظنه ثابتًا.
إنه شاعر يقف أمام البشرية ليسألها سؤالًا حارقًا:
من أنتم يا من تتناسَلون من قابيل؟
وهل ما زال فيكم من يحمل دم هابيل؟
أم أن القاتل الأول انتصر نهائيًّا، وصار دينًا، ومذهبًا، ومشروعًا سياسيًا؟
“يا بني قابيل” قصيدة تُقرأ لا بالأعين، بل بالوعي الموجوع.
قصيدة تُصلي في محراب الغضب لا الورع.
قصيدة تجعلنا نحاكم الميراث قبل أن نباركه، والأنبياء قبل أن نسبّح بأسمائهم، والدم قبل أن نجفّفه من الذاكرة
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .