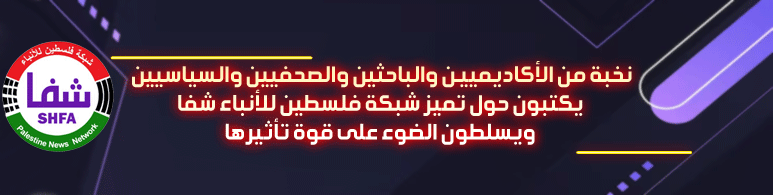طريق الحرير الممتد عبر القرون ، رحلتي مع معلمين سعوديين في دروب الثقافة الصينية ، بقلم : وانغ قوانغ يوان
في سبتمبر عام 2024، وبينما كانت شمس الخريف الأولى تنثر ضوءها الذهبي على أوراق الجُميز في جامعة بكين للغات والثقافة، وجدتُ على مكتبي قائمة أسماء تحمل دلالة خاصة.. مائة معلم ومعلمة من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. بدعم مشترك من وزارة التعليم السعودية والمركز الصيني للتعاون والتبادل اللغوي التابع لوزارة التعليم الصينية، اجتمع هؤلاء المعلمون في رحاب جامعة بكين للغات والثقافة، ليبدأوا رحلة دراسية تمتد لثلاث سنوات: سنة أولى لتعلم اللغة الصينية، تتبعها سنتان من الدراسة الأكاديمية العليا.
عندما قلّبتُ أسماء هذه القائمة، عادت بي الذاكرة إلى خمسة عشر عاما مضت. ففي عام 2010، أوفدتني جامعتي الأم، جامعة بكين للغات والثقافة، إلى جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، لأشارك في إنشاء أول برنامج بكالوريوس لتعليم اللغة الصينية في السعودية، بل وفي منطقة الخليج بأسرها. أبدى الطلاب شغفا كبيرا بتعلم اللغة الصينية، وكان في عيونهم بريق الفضول تجاه اللغة الصينية وثقافتها. لا يزال ذلك محفورا في ذاكرتي حتى اليوم. ويا لسعادتي حين علمت أن عددا من أولئك الشباب الحالمين أصبحوا اليوم معلمين للغة الصينية في المدارس السعودية، يواصلون الطريق وينقلون الشغف إلى أجيال جديدة. واليوم، وأنا أقف أمام هؤلاء المعلمين القادمين إلى الصين في مهمة معرفية نبيلة، أدرك تماما أن رحلتهم هذه ليست مجرد تجربة شخصية، بل هي جزء من مستقبل تعليم اللغة الصينية في المملكة. فحين يعودون إلى وطنهم، سيقفون على منصات التعليم في المدارس السعودية، ليكونوا ركيزة أساسية في دفع مسيرة تعليم الصينية، والمساهمة في تعزيز التبادل الثقافي بين الصين والسعودية بروح جديدة ونَفَس واعد.
بعد غياب سنوات، وجدت نفسي مرة أخرى أقف على منصة التدريس، لأُلقي محاضراتي على مجموعة من المعلمين السعوديين، وشعرت بمزيج من الحماسة والمسؤولية. كانت المادة التي كلّفت بتدريسها هي “الثقافة الصينية والتواصل بين الثقافات”، وهي في الأصل مادة مخصصة لطلبة الدراسات العليا، لكنها قُدّمت هذه المرة في مرحلة التدريب اللغوي. ومن أجل تقديم محتوى يوازن بين العمق الأكاديمي ومستوى الطلاب في اللغة والفهم الثقافي، قمت بإعادة هيكلة المنهج بشكل كامل. قمت باختيار وتلخيص أهم المحاور في الثقافة الصينية، وركزت على الفكر الكونفوشي والطاوي والبوذي، والأسس الزراعية للحضارة الصينية، وثقافة مقاطع الكتابة الصينية. كما صممت أنشطة حوارية تفاعلية تُشجّع الطلاب على التفكير والمقارنة في إطار التواصل بين الثقافات. لم أكتف بنقل المعرفة فقط، بل سعيت إلى دمجها بتعلم اللغة، من خلال الصور والقصص والأنشطة، لجعل المادة أكثر وضوحا ومتعة. وهكذا، أصبحت هذه المادة تجمع بين العمق النظري والجاذبية التعليمية.
وأخيرا، جاء يوم بدء التدريس، وهو مشهد لن أنساه ما حييت. فعلى الرغم من أن لدي خبرة تدريسية تمتد لخمسة عشر عاما، كانت هذه هي المرة الأولى في مسيرتي المهنية التي أُدرّس فيها مادة بهذا القدر من العمق والتعقيد، أمام هذا العدد الكبير من الطلاب، وباللغة العربية التي ليست لغتي الأم. لكن ما إن دخلت قاعة المحاضرات حتى استقبلني مائة من الإخوة والأخوات السعوديين بتحية دافئة وابتسامات صادقة ومشرقة، فزالت في تلك اللحظة كل مشاعر التوتر والقلق التي كانت في داخلي وشعرت بألفة غابت عني طويلا.. لم يكن ذلك مجرد احترام الطلاب لأستاذهم، بل أشبه بترحيب العائلة وثقتها. بدأنا الحديث بشكل عفوي، تبادلنا التحية والتشجيع. عبّرت لهم عن إعجابي العميق بقرارهم مغادرة وطنهم ومرافقة أسرهم في رحلة طويلة إلى الصين طلبا للعلم، وهم بدورهم شكروني على التحضير الجاد الذي قمت به، وقالوا إنهم يشعرون بالفخر لحضور هذه المحاضرات. كانت كلماتهم صادقة ومؤثرة، ومنحتني دافعا أكبر لأبذل كل جهدي في تقديم هذه المادة بأفضل صورة ممكنة.
ومن هناك، انطلقت رحلتنا المشتركة في عالم من المعرفة والثقافة.
تعرّفنا على أحوال الصين العامة خلال الفصل الدراسي، من الجغرافيا والطبيعة إلى النظام السياسي، ومن مسيرة التنمية الاقتصادية إلى السياسات السكانية. استعرضنا الجبال والأنهار واكتشفنا تنوّع الأقاليم واختلاف المناخات. على الخريطة، أخذتهم في جولة عبر المناظر الطبيعية الصينية، وكنت أحرص على ترشيح بعض المقاطعات التي تتميز بطابع ثقافي خاص. وفي كل مرة كنت أتحدث عن منطقة معينة، كنت أربطها بتجاربي الشخصية في السعودية. فعندما تطرّقت إلى الطقس الحار الرطب في المناطق الساحلية بجنوب شرقي الصين، قلت لهم: “هذا يشبه تهامة في غربي السعودية!” عندها ضحكوا ضحكة يعرفها من عاش هذا الطقس، وشعرت في تلك اللحظة أن المسافة بيننا قد تقلصت وأن الجغرافيا قد تحوّلت إلى جسر ثقافي بيننا.
تعرّفنا كذلك على التأثير العميق الذي تركته الحضارة الزراعية في تشكيل نظام الكتابة الصيني، حيث استخدمتُ أمثلة من مقاطع الكتابة الصوتية والرمزية، ووجّهت أنظارهم نحو الجذور الكتابية المرتبطة بالزراعة، مستعينا بالصور والرسوم المتحركة لشرح تطوّر مقاطع الكتابة الصينية عبر الزمن. كما تناولنا المبادئ الأساسية لثلاث مدارس فكرية رئيسية في الثقافة الصينية: الكونفوشية والطاوية والبوذية، وقارنّاها بالقيم الإسلامية. شارك المعلمون بحماسة في هذا النقاش، وأجمعوا في النهاية على أن هناك تقاطعات واضحة في القيم الجوهرية مثل “الرحمة والعدل والتسامح” في الإسلام، و”الصدق والوفاء والاحترام” في الثقافة الصينية، مما يستحق المزيد من البحث والتأمل المشترك.
وفي حديثنا عن التواصل بين الثقافات، تناولنا عددا من المواقف الحياتية التي قد تشهد سوء فهم أو اختلافا في التوقعات بين الصينيين والعرب، من أساليب التحية وتقدير الوقت، إلى عادات الضيافة وطريقة التعبير في الحوار. وتوقفنا بشكل خاص عند تلك الفروقات الدقيقة بين التصريح والتلميح، وبين ما يُقال وما يُفهم ضمنا، وهي من المسائل التي تفتح بابا لفهم أعمق للسلوك الثقافي المتبادل.
وحين انتقلنا إلى دراسة النصوص الكلاسيكية التي أرّخت للتبادل الحضاري بين الصين والعالم العربي، قدّمتُ نماذج من ((مروج الذهب َومعادن الجوهر)) و((رحلة ابن بطوطة)) التي توثق انطباعات ابن بطوطة عن الصين، كما استعرضنا فقرات من ((سجل الرحلات إلى الصين)) والتي ذكرت الكوفة والمنطقة العربية، بالإضافة إلى وقائع زيارة تشنغ خه لمكة المكرمة. كانت تلك لحظات فكرية ساحرة، سرنا فيها معا على ضفاف التاريخ، نستنشق عبق حضارتين التقتا منذ قرون، وما زالتا تتحاوران بروح إنسانية صادقة.
وفي نهاية الدورة، عبّر أحد المعلمين السعوديين عن مشاعره قائلا إنه لم يكن يعرف الكثير من قبل عن عمق العلاقات التاريخية بين الصين والعالم العربي، لكنه شعر بفخر كبير بعد حضور هذه الدورة، حين أدرك أن حضارتيهما كانتا ترتبطان بروابط وثيقة منذ قرون طويلة. فأجبته بأن التبادل بين الصين والعالم العربي يمثّل فصلا فريدا في تاريخ الحضارة الإنسانية، وأننا اليوم لا نكتفي بمشاهدته فقط، بل نحن شهود عليه وحلقة من حلقاته المتواصلة. خلال فترة التدريس، كان هناك أمران لا يزالان يتركان أثرا عميقا في نفسي ويثيران في داخلي مشاعر التأثر والإعجاب.
أول ما لفت انتباهي هو مدى التزام المعلمين السعوديين وانضباطهم في الحضور والتعلم. فقد كانت نسبة حضورهم طوال الفصل الدراسي شبه كاملة، وحتى في حال المرض أو ظروف طارئة، كانوا يقدّمون اعتذارهم مسبقا بطريقة رسمية تعبّر عن احترامهم للمادة وللمعلم. في كل محاضرة، أجدهم يُقبلون على التعلم بروح من الجدية والاحترام. وما زاد إعجابي هو أنهم حافظوا على حماسهتم للتعلّم وعزيمتهم القوية على الرغم من مسؤولياتهم العائلية الكبيرة. فقد كان العديد منهم يقطن في ضواحي بعيدة عن الجامعة، ويستغرق وصولهم أكثر من ساعة. ومع ذلك، لم يكن يمنعهم الطقس القاسي أو المسافات الطويلة من الوصول إلى القاعة في الوقت المحدد، دون أي تذمّر أو شكوى.
الأمر الثاني الذي أثار إعجابي هو قدرتهم العالية على فهم الثقافة الصينية وتقبّلها، بما يفوق ما كنت أتوقعه. فخلال فصل دراسي واحد فقط، لم يكتفوا باكتساب كمّ كبير من المعارف الثقافية، بل أظهروا أيضا قدرة لافتة على التفكير النقدي وحسّا ثقافيا مرهفا. وقد تجلّى هذا بوضوح في أبحاثهم النهائية، حيث كانت موضوعات العديد منهم مبتكرة، وزوايا المعالجة متميزة، والمضامين عميقة ومبنية على فهم متين. كنت أقرأ تلك الأوراق البحثية وأنا أشعر بالدهشة والتقدير، لما تحمله من دلائل على اجتهادهم وجديّتهم واحترامهم العميق لما يتعلمونه من ثقافة الآخر.
وخارج أوقات الدراسة، كانت علاقتنا مليئة بالود والتفاهم. فبقيادة البروفيسور خليل لوه لين وتحت إشرافه، شاركنا معا في تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والتعليمية التي ساهمت في تعزيز أواصر التفاهم والصداقة بيننا. من بين هذه الأنشطة، استقبالنا لمعالي وزير الإعلام السعودي، السيد سلمان الدوسري، حيث قدّم المعلمون السعوديون بالتعاون مع طلاب صينيين عروضا متميزة، شملت إلقاء قصائد عربية وعرضا تعليميا باللغة الصينية، وقد نالت هذه الفقرات إعجاب الوزير والوفد المرافق له. كما تواصلنا مع شركة “السور العظيم” الصينية للسيارات ونظمنا ندوة عن ثقافة السيارات في الصين. وخلال هذه الفعالية، تعرّف المعلمون السعوديون على تطوّر الصناعة الصينية من خلال مشاهدة نماذج من السيارات المحلية، كما أُتيحت لهم فرصة التفاعل مع الطلاب الصينيين، حيث شكّلوا مجموعات تبادل لغوي، ما أضاف بُعدا عمليا لتعلّم اللغة، وأسّس لمنصة تواصل حيّة بين الصين والعالمي العربي.
وفي حياتنا اليومية، كانت طيبة المعلمين السعوديين ودفء تعاملهم من أكثر الأمور التي أثرت فيّ وأثارت إعجابي. فقد اعتادوا أن يهدوني بين الحين والآخر هدايا بسيطة ولكنها محمّلة بالمعاني.. كتابا، أو قطعة فنية صغيرة، أو علبة من الحلوى التي أعدّوها بأيديهم. لكن ما لمس قلبي حقا هو ثقتهم الكبيرة بي؛ إذ كان بعضهم يسألني عن مطاعم الحلال في بكين، وآخرون يستشيرونني في مسائل تتعلق بالتأشيرات أو الرعاية الصحية، وكان البعض يطلب اقتراحات لأماكن مناسبة للرحلات العائلية خلال العطلات، بل حتى أوقات الإفطار والسحور في شهر رمضان في بكين. لقد فقدت العدّ من كثرة الرسائل والاستفسارات التي وصلتني، لكن ما بقي حاضرا في ذاكرتي هو تلك الروح الطيبة والاحترام الكبير الذي كانوا يعبرون عنه في كل مرة يشكرونني فيها بإخلاص وامتنان.
وفي الوقت نفسه، كنتُ أنا أيضا أتلقى منهم الكثير من الدعم والمساعدة التي لا تُقدّر بثمن. كلما واجهتُ صعوبة لغوية أثناء تدريسي بالعربية، ألجأ إليهم دون تردّد، فكانوا يجيبونني بصدر رحب واهتمام صادق. أما حين كنت أبحث عن فهم أدق للعادات والتقاليد الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، كانوا لا يبخلون عليّ بالمعلومة، بل يشرحون لي التفاصيل بكل صبر ووضوح. هذا التبادل الصادق في الفهم والدعم جعلني ألمس عن قرب طيبة السعوديين وصدق مشاعرهم، وأشعر بأن علاقتنا في القاعة الدراسية لم تعد مجرد علاقة بين أستاذ وطلابه، بل أصبحت صداقة حقيقية مبنية على الثقة والتفاهم بين ثقافتين.
قبل خمسة وثلاثين عاما، أقامت الصين والمملكة العربية السعودية علاقاتهما الدبلوماسية رسميا؛ وبعد خمسة وثلاثين عاما، ها هي اللغة الصينية تشهد ازدهارا ملحوظا على أرض المملكة. يعكس هذا التحوّل عمق الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين البلدين.
في السنوات الأخيرة، وبفضل الاهتمام الكبير والدعم المشترك من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم تحقيق تكامل عميق بين مبادرة “الحزام والطريق” و”روية السعودية 2030″، مما مهّد الطريق لتعاون غير مسبوق بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية وغيرها. وفي خضم هذا التقارب، برز التعليم اللغوي بوصفه جسرا أساسيا للتواصل الحضاري، وأصبح التعاون في تعليم اللغة عنصرا محوريا في التبادل الإنساني والثقافي بين الصين والسعودية. وإذا نظرنا إلى المشهد الدولي الأوسع، نرى أن التعاون الصيني- السعودي في ميدان التعليم يشكّل نموذجا جديدا يحتذى به في العالم العربي، بل وأحد أبرز الأمثلة على قدرة دول الجنوب العالمي على التعاون والتبادل الثقافي والمعرفي بروح من الندية والاحترام المتبادل.
أخيرا، أرجو أن يواصل المعلمون السعوديون دورهم النبيل كسفراء للغة والثقافة، وأن تظل العلاقات الصينية- السعودية نموذجا مشرقا للتفاهم والتعاون، وأن يسهم هذا التلاقي الحضاري في بناء عالم أكثر تواصلا وتسامحا وتبادلا للمعرفة.
- وانغ قوانغ يوان – أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية بجامعة بكين للغات والثقافة – الصين
إقرأ مزيداً من الأخبار حول الصين … إضغط هنا للمتابعة والقراءة
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .