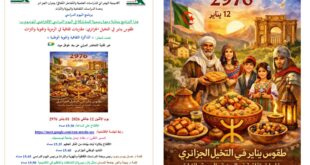“أتطلّع للآتي”: قصيدة الجرح المفتوح والمستقبل المُراوِغ ، قراءة نقدية في مجموعة محمد علوش الشعرية ، بقلم: جابر حسين الموسوي
أولاً: التقديم العام للمجموعة: ليست “أتطلع للآتي” عنواناً شعرياً فحسب، بل بيان وجود وشعر وهوية، حيث ينطلق الشاعر الفلسطيني محمد علوش من فعل مضارع ينفتح على الزمن الآتي، ليُعلن قطيعة مع القهر والماضي الجاثم، دون أن يفقد جذره التاريخي، فتبدو المجموعة كأنها محاولة لاقتناص النور في آخر النفق.
الشاعر لا يأتي من برجٍ عالٍ أو من سلطة اللغة، بل من هوامش الجرح الجمعيّ الفلسطيني، من ذاكرة المنفى والمخيم، من وجع المدينة وسؤال العدالة، وكما أشار الشاعر والناقد محمد دلّة في تقديمه للمجموعة، فإن شاعرنا علوش لا يدخل الشعر من باب الأيديولوجيا الجافة، بل من صميم التجربة الحارقة، واللغة المرتبطة بالتراب والناس.
ثانياً: الشكل والأسلوب – قصيدة النثر كخيار وجودي: وهنا يختار محمد علوش قصيدة النثر لا كترف فني، بل كفضاء يتّسع لهياجه، وهواجسه، وغضبه الهادئ، وهذه القصيدة ليست فوضى، بل مشروعاً لغوياً مضاداً للنسق، وللشعر الرسميّ الجاهز.
“القصيدة خائنة الأعين…
لم يشهد ولادتها أباطرة النقابات”
(من: لا تستر عورتها)
الأسلوب يتأرجح بين الإيقاع الداخلي والغنائية المتوترة والسرد الشعري المتشظي، وهناك رغبة صريحة في كسر التقاليد، لكن دون التخلي عن الحفر في المعنى والصورة، ولذا، فإن الشكل هنا ليس غلافاً، بل امتداداً لجوهر التجربة.
ثالثاً: البنية الموضوعية: فلسطين كذات وقضية، ويحضر الوطن في المجموعة كذات فاعلة، لا كخلفية، ليست فلسطين مجرد ذكرى، بل هي جرح يومي متجدد، وحلم لا يخبو، في قصائد مثل اليرموك، حيفا، غزة، الخليل، نقرأ خريطة من الألم الممتزج بالمقاومة:
“أنا القروي
تسكنني بساطة السهل
وهامة الجبل”
(من: القروي)
في اليرموك، يختلط الوجع السوري بالنزيف الفلسطيني، فتتحول القصيدة إلى وثيقة سياسية وشهادة شعرية ضد الرداءة والانقسام:
“يا عرب النفط ويا حراس القحط
أرقاماً صرنا…
قطعاناً صرنا…”
والشاعر ينحاز للفقراء بوعي جمالي وأخلاقي، فنراه يُدين البُنى الفاسدة، وينتصر لأصحاب الرغيف المُر، وأطفال المخيم:
“من يسمع صرخات الفقراء؟
يا خبز الفقراء المعجون بدمنا”
ويسخر من المؤسسات الرسمية التي فقدت دورها:
“نقابات العمال شموعها بالأحمر
ما عادت تستر عورتها”
ويحضر العنصر الأنثوي كمجاز للخصوبة، للأمومة، للقصيدة، وللوطن، وهي ليست متعة شعرية بل شريك في المعاناة والمقاومة:
“أمي
توقظ الحدائق كل صباح”
(من: أجمل من في الكون)
“تحاصرني الأمنيات
تحاصرني مملكة الموت
وعشتار تواعدني بلقاءٍ ينزف أشواقاً”
(من: تحاصرني الأمنيات)
ولغة محمد علوش تتوتر بين الشفافية والمجاز الكثيف، وهو شاعر الصورة المركّبة، حيث تتوالد الصور لا كزينة، بل كأدوات كشف:
“فيك وفينا قد مات الموت”
(من: طفل البحر)
تغتني قصائده برموز أسطورية (عشتار، تموز، اللات)، ودينية (يوسف، المعراج، نوح)، وشعبية (حنظلة، الكوفية، رغيف الخبز)، واللغة هنا ليست وسيلة تعبير، بل جزء من المعركة.
ورغم انتماء القصائد لقصيدة النثر، إلا أن الموسيقى لا تغيب، حيث يعتمد الشاعر على تقنيات مثل: التكرار: “يموت… يموت…”، والتوازي التركيبي: “أنا الحصان… أنا الشراع…”، والقطع والتدوير الذي يصنع توتّراً إيقاعياً:
“تأكلني الوحوش
لتأكلني
وتأكل يتمي
وجوعي”
(من: ناديت إخوتي)
كما أن قصيدة “أتيت أعراس الخليل” المكتوبة على تفعيلة واضحة تُظهر أن الشاعر يتقن الإيقاع العمودي والحر، ويتنقل بينهما بمرونة شعرية نادرة.
كما رصد محمد دلّة، فإن العناوين تتوزع غالباً في شكل جمل خبرية، ما يدل على أن الشاعر يكتب ليقول، لا ليتجمل.
والعنوان في هذا الديوان ليس “تسمية خارجية”، بل هو جزء من القصيدة نفسها، يخدم دلالتها، ويُفتح كعتبة قرائية أولى.
ومن أهم نقاط القوة التي يمكننا الإشارة لها في هذه القراءة، حضور فلسطين الطاغي دون خطابية، وتوازن بين الذات والهمّ الجمعي، وتنوع أسلوبي وشكلي لافت، واشتغال رمزي متقن، صور شعرية مشحونة وعميقة.
وهناك نقاط قابلة للتعزيز، وأهمها، تقليل التراكم المجازي في بعض النصوص، وتعزيز الاقتصاد اللغوي دون الإخلال بالوهج، والحذر من المباشرة في بعض المقاطع ذات الطابع السياسي.
بين النار والأمل، جاءت مجموعة “أتطلع للآتي” ليست مجرد قصائد، بل وثيقة شعرية صادمة وشاهدة، وهي بيان شعري من شاعر مكّرس يسكنه غضب المخيم، وبهاء القصيدة، ونبل الفقراء، حيث يمسك محمد علوش قلمه كفأس، ليهدم خرافة الشعر المعلّب، ويكتب نصاً جديداً، يسمّي الجرح، ويصنع من الرماد رغيفاً وحلماً وسماءا.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .