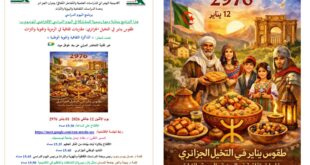فلسطين بين الحُكم الذاتي والحيّز العام ، ثلاثون عامًا من التحدي البنيوي ، بقلم: د. عمر السلخي
منذ ما يزيد عن مئة عام، عاش الفلسطيني تحت سلطات متعاقبة: الدولة العثمانية، ثم الانتداب البريطاني، فالاحتلال الإسرائيلي، وتخلل ذلك فترات حكم إداري أردني في الضفة الغربية ومصري في قطاع غزة. هذا التعاقب السياسي زعزع علاقة الفلسطيني بالحيز العام، إذ نشأ المواطن على شعور بأن الملكية العامة لا تخصه، بل هي تابعة لسلطة غريبة أو مفروضة عليه.
نتيجة لهذا الانفصال، أصبح من المألوف أن نرى القمامة في الشوارع، أو نلحظ تخريبًا في الممتلكات العامة، أو إهمالًا للحدائق والمدارس والبنى التحتية. لم تكن هذه الظواهر ناتجة عن غياب الوعي، بل عن شعور دفين بأن الفضاء العام ليس امتدادًا للذات، بل ملكًا للآخر الذي يتحكم بنا.
السلطة الوطنية: بداية تجربة جديدة
مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، ولأول مرة منذ قرون، أُتيحت للفلسطينيين فرصة ممارسة نوع من الحكم الذاتي. شكل ذلك منعطفًا تاريخيًا يُفترض أن يعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والمكان، ويحوّل الملكية العامة إلى مجال ينتمي له الفرد ويشعر بالمسؤولية تجاهه.
وبعد مرور ثلاثين عامًا على هذه التجربة، ما زال السؤال مطروحًا: هل نجحنا في ترميم العلاقة بين الفلسطيني والحيّز العام؟
لا شك أن هناك تحولات إيجابية. فقد ظهرت مبادرات تطوعية ومجتمعية تهدف إلى تنظيف الشوارع، وتجميل الساحات، والمحافظة على المرافق العامة. كما نشأت ثقافة جديدة لدى الأجيال الشابة تتبنى العمل التطوعي والانتماء إلى المكان.
لكن هذه التحولات لم تكن كافية. فما زالت مظاهر الإهمال والتعدي على الممتلكات العامة قائمة، وما زال الانفصال النفسي والاجتماعي حاضرًا في تعاملنا مع الحيز العام، وكأنّنا لم نغادر تمامًا عباءة الاحتلال.
السلطة ليست الدولة
إحدى الإشكاليات العميقة التي واجهتها السلطة الوطنية خلال العقود الثلاثة الماضية هي أنها لم تتحول فعليًا إلى دولة ذات مؤسسات راسخة تعكس إرادة الناس وتحمي المصلحة العامة. فضعف الشفافية، وغياب المساءلة، وتفشي المحسوبية والبيروقراطية، جعلت المواطن يشعر أن السلطة أقرب إلى “جهاز إداري” منها إلى “نظام يمثلني”.
غياب العدالة وتهميش المشاركة الشعبية في صنع القرار عمّق الفجوة بين الفرد ومحيطه السياسي، وأضعف الشعور بالمسؤولية تجاه الممتلكات العامة. فما دام المواطن لا يشعر أن صوته مسموع، فإنه لن يشعر أن الرصيف والمدرسة والحديقة تمثله.
ما العمل؟
التحول لا يتم من خلال الخطب والشعارات، بل ببناء عقد اجتماعي جديد يستند إلى:
إشراك الناس في التخطيط المحلي واتخاذ القرار.
تعزيز الرقابة الشعبية والإعلام المستقل.
ترسيخ ثقافة الانتماء من خلال التعليم والتربية.
إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة الرسمية.
المطلوب ليس فقط تنظيف الشوارع، بل تنظيف العلاقة بين المواطن والدولة من شوائب الاحتلال والتهميش. فمشروع الدولة يبدأ من السلوك اليومي، من الطريقة التي ننظر بها إلى الحيز العام، ومن الإحساس بأن هذا المكان يعكس كرامتنا، ويستحق حمايتنا.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .