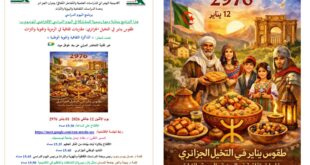الدكتور نبيل طنوس ، حين تصبح الكلمة وطنًا، ويصير الناقد أمين الوجدان الفلسطيني ، بقلم: رانية فؤاد مرجية
هل يولد الإنسان ناقدًا بالفطرة؟
هل يُمكن لمعلّم في قرية جبلية أن يصبح شاهدًا على قصيدة وطن؟
هل للترجمة القدرة على إنقاذ الذاكرة من الغرق؟
للإجابة على هذه الأسئلة الوجودية، يجب أن نصغي لمسيرة رجل استثنائي، الذي علّمنا أن الكتابة ليست مجرد حرفة، بل هي خلاص. والانتماء ليس مجرد شعار، بل عمق ممتد في اللغة والتاريخ والرؤية.
إنه الدكتور نبيل طنوس، مولود في قرية عين الأسد خلال نزوح عائلته، وعادوا إلى قريتهم المغار بعد الهدوء. وُلِد ليكون شاهداً على التهجير، لكنه قرر ألا يكون لاجئًا في المعنى، بل مقيمًا دائمًا في جوهر الكلمة، حارسًا لهوية تتصارع يوميًا كي لا تُمحى.
في عالمٍ أدمن الضجيج، اختار طنوس درب الصمت العميق، صمت يحفر في العمق ويستخرج ما تراكم في طبقات النصوص من ألم وضوء. لم يكن ناقدًا يصفق، ولا أكاديميًا يجترّ النظريات، بل مفكرًا حرًا، يُمسك القصيدة كما يُمسك الجراح المِبضع، لا ليمزقها، بل ليكشف ما فيها من نبض وشقاء وجمال.
عند قراءة كتاباته عن محمود درويش، لا تشعر أنه يكتب عنه فقط، بل كأنه يُنصت له وهو يهمس من قبره: “احذر يا طنوس، لا تمدحني كثيرًا، بل افهمني”. وهذا ما يفعله طنوس: لا يصف، بل يفهم، لا يُنظّر، بل يُعانق، لا يستهلك النص بل يُقيم فيه. في دراساته عن درويش وسميح القاسم وراشد حسين، يذهب إلى البعيد البعيد، ليكشف عن فلسطين كحلم مقاوم، وكقلب ينزف دون أن يستسلم.
لقد رأى طنوس في القصيدة مرآة للكينونة الفلسطينية، وفي كل بيت شعر، نبضًا لشهيد أو شهيدة، أو لروح أمّ لم تجف دمعتها منذ دير ياسين وحتى جنين. لذلك، لم تكن قراءته جمالية فقط، بل وجودية، تستفهم النص لتفهم الذات، وتُعيد تموضع السؤال: من نكون حين نُحاصر؟ وما المعنى حين يُمنع عن الكلام؟
أما الترجمة، فهي عند نبيل طنوس ليست نقلاً لغويًا، بل فعل مقاومة ثقافية. لم يترجم من العبرية أو إليها كمجرد وسيط، بل كمن يُعيد تعريف الجسر بين الشعوب. وكأن كل ترجمة قام بها، كانت محاولة خجولة لإنقاذ فلسطين من أن تُقرأ بخطأ أو تُفهم بسطحية. لقد قاوم عبر اللغة، لأن الهوية تبدأ من الكلمة، و”الآخر” لا يُهزم بالبندقية فقط، بل بالفكرة.
وعندما دخل عالم التربية، لم يُرِد أن يكون مُربيًا نمطيًا، بل موجهًا للأرواح. نال الدكتوراه من جامعة موسكو، لكنه لم يسكن البرج الأكاديمي، بل بقي ابن التراب، ابن الجبل، ابن المدرسة الأولى، حيث الطالب ليس رقمًا، بل مشروع وعي. أراد أن يكون التعليم تجربة تحرر، لا منظومة تلقين، وأن يكون الفكر مفتاحًا للكرامة، لا بابًا للمسخ. في كتابه “التربية الاجتماعية اللامنهجية”، جعل من الهامش منهجًا، ومن المسكوت عنه بوصلة.
نبيل طنوس ليس فقط ناقدًا، بل هو ذاكرة تمشي على قدمين. رجل لم تُغره الأضواء، ولم يسعَ يومًا للمنصة، بل جعل من كل ورقةٍ يكتب عليها منبرًا، ومن كل حوارٍ تربوي صلاة سرية. هو من القلائل الذين فهموا أن النقد لا يعلو على النص، بل ينحني له، احترامًا لا خنوعًا، وأن من يقرأ درويش دون وجع، لم يقرأ شيئًا بعد.
اليوم، في زمن الغرق الجماعي، نحتاج إلى مَن يُعيد للكلمة نُبلها، وللنقد رسالته، وللهوية معناها. نحتاج إلى نبيل طنوس آخر، لا ليُكرر طنوس الأول، بل ليواصل ما بدأه: أن يكون الإنسان ابن لغته، وأن تكون فلسطين أولًا وأبدًا في القلب، وفي النص، وفي الحبر.
هو ليس أسطورة، لكنه استثناء.
هو ليس نبيًا، لكنه نذير المعنى.
في زمن تكثر فيه الأصوات وتقلّ فيه الحكمة، يبقى نبيل طنوس بوصلةً لمن أراد أن يكتب لا ليُبهر، بل ليُغيّر.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .