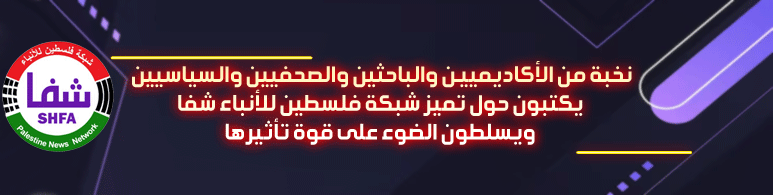قراءة في نص ، حينَ يُعادُ إليكَ الغياب للشاعرة السورية ريما حمزة ، بقلم : رانية مرجية
المطر يفتتح الناي الداخلي
حين أقرأ نص ريما حمزة “حين يُعادُ إليك الغياب” أشعر أنني لست أمام قصيدة وحسب، بل أمام انفتاح كونيّ على جرح لا ينتهي. النص ليس مجرد كلمات مرصوفة في بنية شعرية، بل هو حالة روحية تنفذ إلى أعماق الذات، وكأن الشاعرة تكتب من منطقة يتعانق فيها الحلم والعدم، الحب والفقد، النبوءة والانكسار.
ريما هنا لا تصوغ مشهداً شعرياً عادياً؛ بل تبني عالماً داخلياً تتكاثف فيه الصور مثل غيوم محمّلة بالرعد، تبحث عن مطر يفيض من قارئها أكثر مما يفيض من كلماتها.
الغياب كحضورٍ يبتلع الزمن
في النص يتحول الغياب من حالة نقص إلى كيان كامل، يعود إلى المحبوب لا ليُتمّ نقصاً، بل ليضاعف الفقد ويجعله قدراً لا مفرّ منه. الغياب ليس عارضاً عابراً بل هو جوهر العلاقة، حتى يكاد يصبح الشخص الآخر انعكاساً له، أو ضحية له.
الصور التي ترسمها ريما ـ البحر، المرافئ، السراب، السفن ـ ليست مجرد رموز؛ إنها مسارح لفلسفة الغياب. البحر يفتح قمصانه، لكن المرافئ عطشى. الحضور لا يروي، واليقين لا يُكفّن. هكذا يتجسد الفراغ كمعادل موضوعي للوجود ذاته.
جراح النبوءة وخطيئة المرآة
النص ينطق بجرح يمشي على حدّ السكين: جرح ليس فيه خلاص ولا رجاء، لكنه مع ذلك يجرّ وراءه معجزات مكسورة. الشاعرة تضع الحبيب في موضع نبي ضائع، فقد دعاءه وأرضه، لتسائل بذلك المعنى الروحي للقداسة حين تفقد مرآتها البشرية.
المرآة في النص ليست انعكاساً، بل خصم وجودي. هي نساء المرايا اللواتي يضاجعهن الرجل، كأن المرآة هنا تُكمل خيانة المعنى، تفتح على تعدد بلا عمق. لكن الشاعرة تعرف أن مرآة عينيها وحدها هي النبوءة الحقيقية، التي إن غابت لم يبقَ إلا العذاب.
جمالية الموت كخلاص مؤجل
في مواضع متعددة يتكرر الموت لا بوصفه نهاية بل كطقس شعائري. “ولا تقترف غير موتك حتى يُعاد إليك الغياب”؛ كأن الموت هو الشرط الوحيد للانبعاث، أو هو المرآة الأخيرة التي يمكن أن تعيد للغياب معناه.
إنه موت ممتد، موت يتكرر في الحروب الداخلية، في النساء اللواتي يمتن بجلدة إثر جلدة، في الحب الذي يمرّ كنعش بملامح فاتحة. ومع ذلك، يبقى هذا الموت شكلاً من أشكال الخلاص المؤجل، أو ما يسميه الفلاسفة “العدم الذي يؤسس الوجود”.
اللغة كمحراب للمعنى الضائع
لغة ريما حمزة في هذا النص لغة متفجرة، لا تعرف الاستقرار في صورة واحدة، بل تتنقل بين فضاءات كونية: البحر، الليل، المطر، الطين، الشتاء، الشمعدان… كل صورة تحمل عبء المعنى وتُسلمه لصورة أخرى. النص أشبه بقدّاس شعري حيث تذوب الاستعارة في أخرى، فلا يبقى للقارئ إلا أن يضيع في هذا المد الشعوري الكثيف.
بين الفقد واليقين.. فلسفة المحال
السؤال الأخير الذي يعلو في النص: “وهل كنتَ تعرف أن اشتعالي هو الفارق المستحيل بين وهم الرحيل واليقين؟” هو سؤال وجودي، لا يخص الحبيب وحده بل يخص الإنسان في رحلته الكونية. الحب هنا يتحول إلى ساحة امتحان ميتافيزيقي، حيث يُختبر المعنى ذاته: هل الحضور يقين أم وهم؟ وهل الغياب قدر أم اختيار؟
خاتمة: النص كمرآة كونية
قصيدة “حين يُعادُ إليك الغياب” ليست مجرد مناجاة عاطفية، بل هي مشروع فلسفي شعري يضع القارئ أمام نفسه. إنه نص يتنفس بالرموز ويصرخ بالصور، يتوسل المطر والبحر والليل، لكنه في النهاية يتركنا أمام سؤال جوهري: كيف نواجه الغياب إذا كان هو الوجه الحقيقي للحضور؟
بهذا المعنى، يمكن القول إن ريما حمزة كتبت نصاً يُشبه صلاة طويلة في معبد الحب المهدوم، صلاة لا تنتظر جواباً بل تفتح باباً لقلق أبدي
حينَ يُعادُ إليكَ الغياب
وأنتَ تضاجعُ نساءَ المرايا،
أمرُّ ببالِكَ مثلَ حمامة،
فتفتحُ البحارُ أزرارَ قمصانِها،
وترجعُ لحدودِها البِكرِ السفن.
لكنّ المرافئَ عطشى،
لم تكفَّنْ مراكبَها باليقينِ،
ولا سالَ من شطِّها غيرُ السرابْ.
فكيفَ يُعيدُكَ وجهي نبيّاً،
وقد ضلَّ عنكَ الدعاءُ،
وفاتَتكَ الأرضُ
إلا خرابْ؟
يرقصُ زمنُكَ المكسورُ فوقَ الساعات،
يسكبُ ضجركَ كأسًا لنفسِه،
فجرحُكَ يجترحُ المعجزاتِ،
إلا أنْ يُغيِّبَ كُحليَ كلَّ المدائنِ
في ضبابٍ كثيفٍ بلا انتهاء.
فما جدوى النبوءاتِ
حين تخلو الحكايا من وجهك
وظلك
وما نفعُ مرآةِ عيني
إذا لم تُرَتِّلْ سواكَ العذابْ؟
تعالَ قليلاً إلى جُرحِكَ المستبدِّ،
ولا تقترفْ غيرَ موتِكَ
حتى يُعادَ إليكَ الغيابْ.
تضيقُ مساراتُ اللهفةِ،
حضورٌ يختنقُ بصدايَ،
فآتيكَ كنزوةٍ في ضميرِ السؤال
تكتبُ حواسُ الهزيمةِ شعراً،
وجلدةً إثرَ جلدةٍ،
تموتُ بحروبِكَ كلُّ النساء.
وأنتَ تعدُّ بقاياك في راحتيَّ،
كطفلٍ يُجَرِّبُ في حزنِهِ أصبعَ الطينِ،
لا البحرُ يشبهُ انكساراتِكَ،
ولا الأرضُ تذكُرُ خطاكَ،
فكيفَ تدثِّرُ هذا الشتاءَ بكفِّ الإشتهاء؟
يا لشمعدانِ وجعِكَ العاقلِ،
واحتراقِ الخطايا في حومةِ الذكرى…
آتيكَ سؤالًا حائرًا من قلقِ الهُناك:
كيفَ سرقَكَ من معبدي
الحديثُ عن الغوايةِ والوِصال؟
وهل كان غيري يضمُّ الآه إليكَ،
ويتركُ نافذةً للحنينْ؟
وهل كنتَ تعرفُ أنَّ اشتعالي
هو الفارقُ المستحيلُ
بين وهمِ الرحيلْ واليقينْ؟
تأخَّرَ حمامي الزاجلُ،
مرَّ نعشُ الحبِّ بملامحِ فاتحة،
جفنُ الليلِ وداعةُ انكسار،
وعطرٌ لم يتجلَّ بأحمرِ غُرناطتي،
فابكِ فتوحاتِكَ
على شاهدِ احتضار.
فما كنتُ إلا امتدادَكَ في لحظةِ الهمس،
حين اختصرتُ الحكايا إلى ومضةٍ،
ثم غادرتُ من غيرِ صوتٍ،
تركتُ المدى في يديكَ،
وفي قدميَّ ارتعاشَ الطريقْ.
سبايا الضياعِ حلبةُ رقص،
وخيالاتي وقعُ خطى
في بابٍ مهيَّأٍ للحضور،
وتري يختالُ بذاكرةِ المُحال،
فيجُنُّ الليلُ موسيقى،
وينهالُ قمر.
ولكنهُ الآنَ يبحثُ في وجنتيَّ
عن الليلِ.. عن كوكبٍ تائهٍ،
عن أناملَ لم تستدلَّ على بابِها،
حين ضاعتْ،
وكان المطرْ.
ريما حمزة
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .