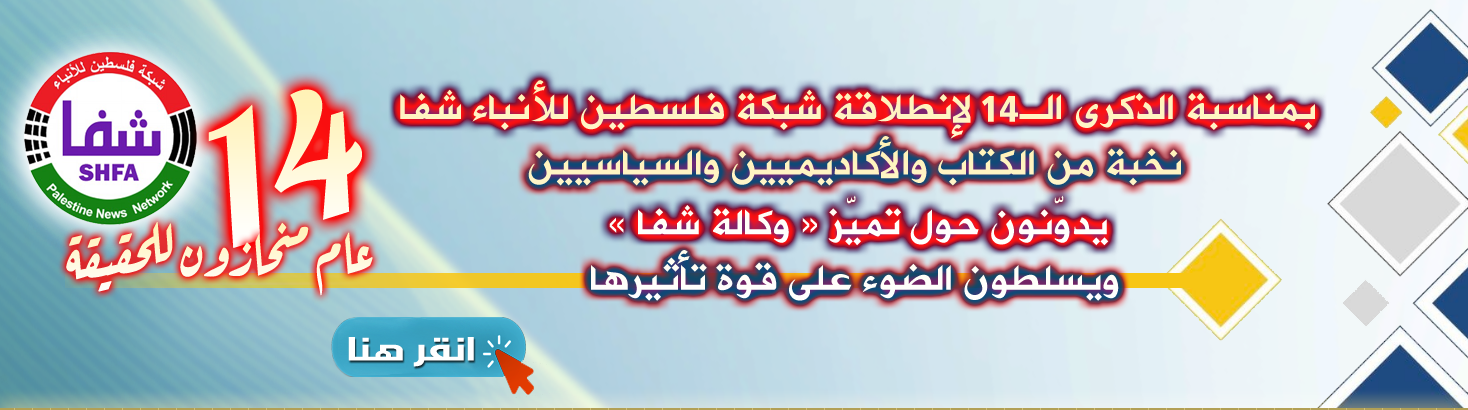من الإعلام التربوي إلى التربية الإعلامية : ثنائية التكامل في مستقبل التعليم ، بقلم : نسيم قبها
في عالم سريع التقلّبات ومنفتح المعارف ، تتقاطع فيه الخطوط بين الواقع والافتراضي، وبين الحقيقة والتمثيل، تبرز إشكالية فلسفية عميقة في حقل التربية: أين يقع الفعل التربوي من الفعل الإعلامي؟ وهل يمكن فصل وسائل الإعلام عن العملية التربوية والتعلمية في عصر أصبحت فيه الشاشات نافذة العالم إلى توجيه الأدمغة ؟ للإجابة عن هذه التساؤلات، لا بد من الغوص في تحليل مفاهيمي يميز بين “الإعلام التربوي” و”التربية الإعلامية”، ليس كمجرد مصطلحين متقابلين، بل كظاهرتين متكاملتين تشكلان معاً ركيزة أساسية لا غنى عنها لجودة قطاع التعليم في القرن الحادي والعشرين.
الإعلام التربوي : الوسيلة التي تتحول إلى جوهر
قد يعرف الإعلام التربوي على أنه “توظيف تقنيات ووسائل الإعلام المختلفة (سواء كانت تقليدية كالمذياع والتلفاز، أو حديثة كالتطبيقات التفاعلية والواقع المعزز) في خدمة الأهداف التربوية ونقل المعرفة.” هنا، يكون الإعلام في موقع “الوسيلة” أو “الأداة” التابعة للعملية التعليمية التعلمية . إنه الوعاء الذي يحمل المضمون التربوي، والجسر الذي يعبر من خلاله المعلم إلى عقل المتعلم.
من المنظور الفلسفي التربوي، يمكننا فهم الإعلام التربوي عبر عدسة “البراغماتية التطبيقية”، حيث تكون القيمة الحقيقية للوسيلة تكمن في فاعليتها وتحقيقها للغاية المنشودة، وهي التعلم. فشاشة العرض التفاعلي، أو البودكاست التعليمي، أو القناة التربوية على “اليوتيوب” – جميعها أدوات تكتسب شرعيتها من قدرتها على إيصال المعلومة، وشرح المفاهيم المجردة، وتحفيز الانتباه، وإثارة الدافعية للتعلم. إنها تجسيد لمبدأ “التعليم من خلال الوسيط”، حيث يتحول الإعلام إلى امتداد لحضور المعلم، بل ويتجاوز حدود الزمان والمكان ليصنع فضاءً تعليمياً تعلميا مفتوحاً ومستمراً.
غير أن الخطر الكامن هنا، والمناقش بكثافة في أدبيات “نقد تكنولوجيا التعليم”، يكمن في “اغتراب” العملية التعليمية. فحين تتحول العلاقة من “معلم-طالب” إلى “شاشة-طالب”، قد نفقد “الجدلية الإنسانية” التي تحدث في الصف الدراسي ، والتي هي أساس بناء الشخصية والقيم. كما أن سيطرة النموذج “السلعي” على الإعلام التربوي قد تحوله من أداة للتحرر الفكري إلى أداة لإعادة إنتاج المعرفة الجاهزة، مما يقتل روح الإبداع والنقد لدى المتعلم. هنا تبرز ضرورة أن يكون الإعلام التربوي مبنياً على أسس “بيداغوجيا المقاومة” التي ترفض تحويل المتعلم إلى متلقٍ سلبي، وتسعى لتمكينه حتى داخل النموذج الوسيط.
واليوم تبرز الحاجة في انتقال الإعلام بشكل عام من دور الناقل للخبر التربوي ، إلى دور الشريك السائل في ماهيّة التعليم وجودته ، وهو يد المدافع التي يجب أن تبقى حاضرة من أجل ديمومة التعليم مدى الحياة.
التربية الإعلامية : الجوهر الذي يصنع الوعي
إذا كان الإعلام التربوي يعني “استخدام الإعلام في التربية”، فإن التربية الإعلامية تعني “تربية الفرد على فهم الإعلام”. إنها عملية تعليمية تهدف إلى تنمية “الوعي النقدي” و”الكفاءة التحليلية” لدى المتعلم تجاه مضامين الإعلام بجميع أشكاله. إنها لا تهتم بماذا يقول الإعلام، بل بكيف يقول ولماذا يقول؟ ومن وراء الكلام؟ وما هي الآليات والتقنيات المستخدمة للتأثير؟
فلسفياً، تقف التربية الإعلامية على أكتاف مدرسة “فرانكفورت النقدية” و”ما بعد البنيوية”، حيث يتم النظر إلى الإعلام ليس كمرآة للواقع، بل كمنتج نشط لهذا الواقع، وكمجال للصراع الأيديولوجي وبناء الهيمنة الثقافية. إنها تهدف إلى “إزالة طلسمة” الخطاب الإعلامي، وكشف “البنى العميقة” الخفية التي تحكمه، من مال وسلطة وأجندات. المتعلم هنا ليس وعاءً يُملأ، بل هو “ذات عارفة” تُسلح بأدوات التفكيك والنقد.
التربية الإعلامية، بهذا المعنى، هي شكل من أشكال “التربية من أجل التحرر” كما رأها “باولو فريري”. إنها تعلم الفرد كيف “يقرأ العالم” من خلال قراءة الإعلام، وكيف يتحول من كائن “مُستَهْلِك” سلبي للرسائل إلى “صانع” فاعل ومعارض نقدي. إنها تتعامل مع “فيض المعلومات” ليس كمشكلة، بل كمادة خام للتفكير النقدي، مما يطور “المناعة الفكرية” لدى النشء ضد التضليل والإشاعات وخطاب الكراهية.
الثنائية التكاملية وأثرها على جودة التعليم: من الأداة إلى العقلية
لا يمكن فهم أهمية وضرورة كل من الإعلام التربوي والتربية الإعلامية بمعزل عن بعضهما البعض. إنهما وجهان لعملة فاعلة اسمها “التعليم في العصر الرقمي”. فجودة التعليم لم تعد تقاس فقط بكمية المعلومات المقدمة، بل بقدرة النظام التعليمي على إنتاج “عقل نقدي مبدع” قادر على التعامل مع تعقيدات العصر.
· الإعلام التربوي يرفع من جودة التعليم من خلال:
· تجسير الهوة بين التجريد والحس: تحويل المفاهيم المجردة إلى صور ورسوم متحركة ومحاكيات تفاعلية.
· تخصيص التعليم: توفير مسارات تعلم فردية تناسب الاحتياجات المختلفة للمتعلمين.
· تحقيق الديمقراطية التعليمية: جعل المعرفة متاحة للجميع، في أي وقت ومكان.
· التربية الإعلامية ترفع من جودة التعليم من خلال:
· بناء المواطن الواعي: إعداد جيل قادر على تمييز الحق من الباطل، والمشاركة في الفضاء العام بوعي ومسؤولية.
· تعزيز التعلم مدى الحياة: تزويد الفرد بمهارات البحث والتحليل والتقييم التي تمكنه من التعلم المستقل خارج جدران المدرسة.
· حماية الهوية الثقافية: تمكين الشباب من فهم آليات العولمة الثقافية ومقاومة محاولات الاختراق الفكري والثقافي.
إن الفصل بين الإعلام التربوي والتربية الإعلامية هو فصل (مصطنع). فالمدرسة التي تدمّر أحدث الوسائل التكنولوجية في فصولها (الإعلام التربوي) دون أن تعلّم طلابها كيف ينقدون رسائلها (التربية الإعلامية)، تكون كمن يسلح جنوده بأحدث الأسلحة دون أن يعلمهم كيف يصوبون. والعكس صحيح، فالتعليم النظري عن مخاطر الإعلام دون توفير بدائل إعلامية تربوية جذابة يكون كالوعظ بلا فعل.
لذا، فإن مستقبل جودة التعليم رهين بتبني نموذج تكاملي، حيث يكون “الإعلام التربوي” هو الجسد التكنولوجي الحيوي للعملية التعليمية، وتكون “التربية الإعلامية” هي الروح الناقدة والواعية التي تحرك هذا الجسد. فقط من خلال هذه الثنائية يمكننا الانتقال من “تربية الإعلام” إلى “إعلام التربية”، أي إلى بناء نظام تعليمي لا يتعامل مع الإعلام كوسيط عابر، بل كمادة للتفكير وكمجال للفعل، مما ينتج في النهاية متعلماً ليس مجرد مستهلك للمعرفة، بل هو ناقد لها، ومنتج لها، وفاعل في عالمه بوعي وحكمة. هذه هي الغاية السامية للتربية الحقيقية في زمن الثورة الرقمية.
- – نسيم قبها – الإئتلاف التربوي الفلسطيني – الحملة العربية للتعليم
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .