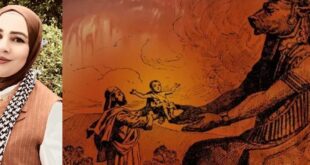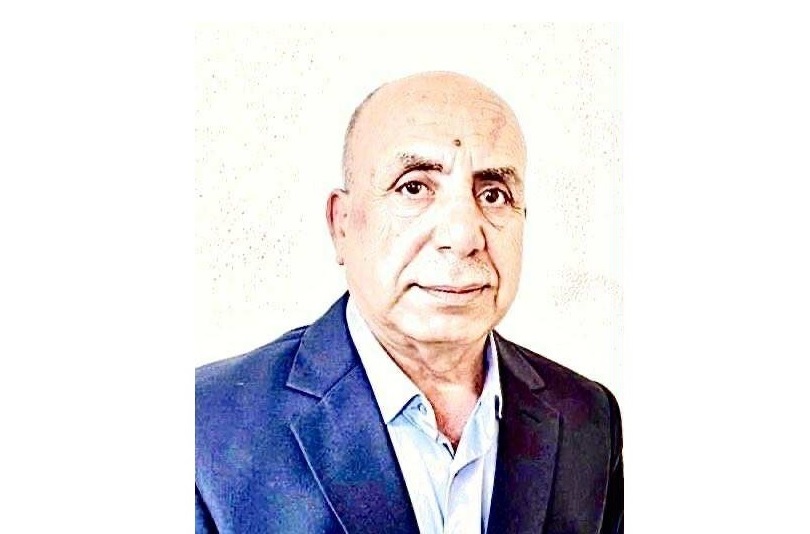
صرخة قرى جنين المحاصرة خلف جدار الضمّ والتوسع ، بقلم : ثروت زيد الكيلاني
الخلفية والتمهيد
منذ الشروع في بناء جدار الضمّ والتوسّع عام 2002، دخلت الجغرافيا الفلسطينية في طور جديد من الهيمنة الاستعمارية التي لا تكتفي بالاحتلال المباشر، بل تستند إلى هندسة مكانية – قانونية – معرفية تهدف إلى إعادة تشكيل الوجود الفلسطيني برمّته. فالجدار، بامتداده المتعرج، ليس حاجزاً مادياً فحسب، بل بنية استراتيجية تعيد ترسيم الحدود دون مفاوضات، وتفرض وقائع ديموغرافية بعيدة المدى، وتحوّل الأرض إلى سلسلة من المعازل البشرية التي يُشار إليها ببرودة سياسية بلفظ “مناطق عزل”، بينما هي في الحقيقة بانتوستان معاصرة تتقاطع مع نموذج الفصل العنصري الذي حظرته اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
في هذا الإطار، برزت في محافظة جنين مجموعة من التجمعات السكانية التي أصبحت محاصرة خلف الجدار، مثل: أم الريحان، بلدة برطعة، خربة برطعة، عبد الله اليونس، ظهر المالح، الرعدية، المنطار، الشيخ عزيز، وخربة فارس وغيرها. هذه القرى لم تعد جزءاً من الضفة الغربية إلا نظرياً؛ فهي محاطة بجدار، وتُدار حياتها اليومية عبر بوابات أمنية تُفتح وتُغلق وفق اعتبارات لا علاقة لها بالقانون أو احترام الكرامة الإنسانية، بل بمنطق السيطرة الاستعمارية التقليدية الذي يعامل الإنسان بوصفه جسماً يجب ضبطه، لا مواطناً يتوجب احترام حقوقه.
بهذا، يتحوّل الجدار إلى أداة تنتج عقاباً جغرافياً طويل الأمد، تتحقق آثاره من خلال آليات غير مباشرة لكنها فعّالة: تقييد الحركة، تكبيل الاقتصاد، خنق الزراعة، تقليص الوصول إلى التعليم والصحة، وخلق بنية نفسية قائمة على الانتظار والقلق واللايقين. ويجري ذلك ضمن ما يمكن تسميته بـ التواطؤ البنيوي بين الجغرافيا والقانون؛ إذ تستخدم إسرائيل منظومة تصاريح معقدة تفتقر لأي أسس قانونية معترف بها دولياً، لكنها تُقدَّم للعالم بوصفها “إجراءات تنظيم”، بينما هي في جوهرها نظام تمييز عنصري يخالف المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري (1973)، ويصطدم بوضوح مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر عام 2004، الذي أكد عدم شرعية الجدار وطالب بإزالته وتعويض المتضررين.
لا يتوقف المشروع الاستعماري هنا عند العزل الجغرافي، بل يمتد إلى إعادة تعريف الفلسطيني قانونياً: من صاحب حقّ أصيل في الأرض إلى “سكان منطقة مغلقة” يحتاج إلى تصريح للذهاب إلى مدرسته وعيادته وحقله، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً للمادة (12) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحرية الحركة، وللمادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في الصحة والرفاه، وللمادة (26) التي تضمن الحق في التعليم.
إن تحويل الحقوق الأساسية إلى “امتيازات مشروطة” لا يمكن تفسيره إلا ضمن منطق الإدارة عبر الإضعاف، حيث لا يتطلب القمع وجود قوة عسكرية دائمة، بل يكفي تثبيت بوابة، أو تغيير المناوبة الأمنية، أو حصر ساعات المرور.
وتتعمق خطورة هذه المنظومة حين ندرك أنها لا تستهدف تعطيل الحاضر فحسب، بل إعادة قولبة المستقبل عبر إغلاق الطرق، وتقييد التواصل بين العائلات، وفرض أنماط اقتصادية هشة تجعل القرى المحاصرة معرضة للتراجع المستمر. إن هذا النوع من العزل لا ينتج فقط اقتصاداً ضعيفاً، بل ينتج وجوداً هشاً يصبح فيه الإنسان مقيّداً بمصفوفة من القرارات اليومية التي لا يمكن التنبؤ بها، وهو ما يشكل انتهاكاً جوهرياً للمادة (1) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها والسيطرة على مواردها.
بهذا المعنى، يشكل الجدار منظومة استعمارية لا تُعيد رسم الجغرافيا فقط، بل تعيد رسم الخريطة النفسية والحقوقية والاجتماعية للفلسطيني، وتحوّله من فاعل في المكان إلى كائن محاصر داخل مكانه.
إنه مشروع يعيد تعريف الأرض بوصفها ملكية قابلة للتجزئة، والإنسان بوصفه وحدة متحركة يجب ضبطها.
تلك هي “الفلسفة العميقة للجدار”: السيطرة على الجغرافيا عبر التحكم بالزمان، والسيطرة على الزمان عبر التحكم بالإنسان.
المحور الأول: العزل الجغرافي كأداة قهر يومي وإعادة إنتاج السيطرة
منذ إنشائه، لم يعد الجدار مجرد حاجز مادي يفصل الإنسان عن الأرض، بل أصبح آلة استعمارية متكاملة تعيد تشكيل المكان والوجود الفلسطيني. المناطق المحصورة خلفه تحولت إلى جيوب مغلقة تتحكم فيها ساعات فتح البوابات، وإجراءات التفتيش التعسفية، والتغييرات اليومية في الطواقم الأمنية. كل حركة، وكل خطوة، صارت مشروطة، لا تتعلق بالحاجة الإنسانية، بل بقرار إداري خارجي، ما حول الحياة اليومية إلى سلسلة من القيود القهرية تُعيد إنتاج حالة هشاشة مستمرة للسكان.
العزل الجغرافي لا يقتصر على حرمان الوصول إلى الأراضي، بل يمتد ليشمل الفضاء الطبيعي ذاته. الطرق الزراعية شبه معطلة، وانقطاع الوصول أدى إلى انخفاض الإنتاج وانحسار الأمن الغذائي. تمدد الأشجار الحرجية داخل الأراضي الزراعية، فضلاً عن فيضانات مياه الصرف الصحي، يشكل مكرهة بيئية وصحية حقيقية تهدد الحياة، وتحوّل الأرض من فضاء للمعيشة والإنتاج إلى مصدر قهر دائم. حرمان الإنسان من معالجة أرضه والحفاظ عليها يجعله شاهداً حياً على تآكل وجوده الاقتصادي والبيئي، ويؤكد أن الأرض نفسها أصبحت أداة للضغط والإضعاف.
ويمتد تأثير العزل إلى التعليم والخدمات الصحية، حيث يضطر الطلاب إلى الاستيقاظ قبل ساعات طويلة لعبور البوابات، فيما يجد المرضى أنفسهم في مواجهة معاناة يومية للوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية. البوابات، التي تُدار بأسلوب يشبه المعازل أكثر من كونها معابر، تحول الحق الطبيعي في الحركة إلى اختبار دائم للكرامة الإنسانية. هذه القيود تمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وحق الوصول إلى الخدمات الأساسية المضمونة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
الفصل الجغرافي يترجم نفسه أيضاً إلى فصل اجتماعي ونفسي؛ حيث تتفتت الروابط الأسرية، وتصبح المناسبات الاجتماعية والدينية، مثل الأعراس والجنازات، أحداثاً شبه مستحيلة التحقيق. هذا الفصل لا يمس الإنسان جسدياً فقط، بل ينحت في وجوده النفسي والاجتماعي، ويولد شعوراً دائماً بالاغتراب والعجز، ويعزز هيمنة المراقبة المستمرة على كل جانب من جوانب الحياة اليومية.
باختصار، الجدار ليس مجرد سياج أو حاجز، بل منظومة متكاملة لإعادة إنتاج العزلة والفصل والقهر. الأرض تتحول من فضاء للمعيشة والإنتاج إلى أداة لإضعاف الإنسان، تفكيك المجتمع، وفرض نمط حياة يهيمن عليه القانون الخارجي بديكتاتورية يومية. هذا الواقع يجعل فهم الجدار بعيداً عن البعد المادي فقط، بل تجربة شاملة للتحكم في المكان والزمان والحياة اليومية، وانتهاك مستمر للحقوق الأساسية، مما يضع السكان في حالة هشاشة مستمرة أمام آلة استعمارية منظمة ومتعددة المستويات.
المحور الثاني: نظام التصاريح والسيطرة اليومية – الإنسان الفلسطيني تحت إدارة القهر
تتحول البوابات والمعابر خلف الجدار من أدوات نقل عادية إلى آليات مراقبة واستبعاد قهرية، حيث يصبح الحق الطبيعي في الحركة مشروطاً دائماً بالتصاريح، الوقت، ونمط الحياة الذي تحدده السلطة الاستعمارية. نظام التصاريح لا يقتصر على كونه أداة تنظيمية، بل يمثل بنية عنصرية متكاملة لإعادة هندسة المجتمع الفلسطيني، وتقييد حرياته الأساسية.
العبور من هذه البوابات ليس مجرد تنقل، بل تجربة يومية للاختبار والانتظار والإذلال، حيث تتحكم في الحياة العملية للفلسطينيين، في التعليم والعمل والزراعة والصحة، وتحول كل خطوة إلى اختبار للإرادة والكرامة.
أولاً: التصاريح كأداة لإعادة إنتاج القهر
ربط الحركة بالزمن: يُسمح بالعبور في ساعات محددة، غالباً في فترتين صباحية ومسائية، وأي تأخير يعني رفض الدخول. الحق الطبيعي في الحركة يتحول إلى امتياز مشروط.
تغييرات مزاجية في القوانين اليومية: تغيير الطاقم الأمني يؤدي إلى تعديل التصاريح بشكل تعسفي؛ شخص كان يُسمح له بالعبور يُمنع فجأة، وأوراق كانت مقبولة تُرفض لاحقاً.
قيود على وسائل النقل والبضائع: السيارات غير المسجلة باسم المقيم داخل الجدار ممنوعة، الزوجة لا تستطيع العبور بسيارة زوجها إذا لم يكن التصريح مشتركاً، ونقل البضائع أصبح شبه مستحيل، ما يفاقم الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.
ثانياً: التأثيرات الاجتماعية والنفسية لنظام التصاريح
تفكك الروابط الأسرية والمجتمعية: منع العبور السلس يحرم العائلات من التواصل اليومي، حضور المناسبات الاجتماعية والدينية، ما يؤدي إلى هشاشة النسيج الاجتماعي وفقدان شعور الانتماء.
ضغط نفسي مستمر: التفتيش التعسفي، الإهانات اليومية، والرقابة على الحركة تولّد حالة من الخوف واللايقين النفسي.
عزلة تعليمية وصحية: الطلاب والمرضى يواجهون صعوبة الوصول إلى المدارس والمستشفيات، ما يعطل دورة التعليم والرعاية الصحية، ويزيد من تراجع الحقوق الأساسية.
ثالثاً: البعد القانوني لنظام التصاريح
انتهاك حرية الحركة: المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تكفل حرية التنقل داخل الدولة، وهو ما يتعرض له الفلسطينيون للقيود اليومية.
انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: حرمان الوصول إلى الأراضي والأسواق والوظائف يعطل الحق في الحياة الاقتصادية ويخرق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إعادة إنتاج الفصل العنصري: الربط بين الحقوق والهوية أو الموقع الجغرافي، والمراقبة اليومية، ونظام التصاريح التعسفي يشكل نموذجاً عملياً للفصل العنصري كما ورد في اتفاقية مناهضة الفصل العنصري لعام 1973.
ولتوضيح عمق القهر اليومي الناتج عن نظام التصاريح، يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
ساعات الحياة المراقبة: كل لحظة خارج البيت تخضع لتحديد مسبق، ليصبح الحق الطبيعي في الحركة امتيازاً مشروطاً، ما يحول حياة الفلسطينيين اليومية إلى جدول زمني مقيد.
إعادة إنتاج الهشاشة: الأسرة، العمل، المدرسة، والرعاية الصحية كلها مرتبطة بإجراءات التعقيد الأمني، فتتحول الحياة اليومية إلى تجربة مستمرة من الضعف والانكسار الاجتماعي والاقتصادي.
إذلال يومي مستمر: عمليات التفتيش التعسفي والإهانات النفسية واللفظية تمثل ضغطاً دائماً، حيث يتحول القهر القانوني إلى تجربة حسية مباشرة، تؤثر على الكرامة الإنسانية لكل فرد.
تقييد التعلم والإنتاج: الطلاب والمزارعون والموظفون يفقدون القدرة على الوصول إلى مدارسهم، أعمالهم، أو أراضيهم في الوقت المناسب، ما يحد من فرص التنمية البشرية والاجتماعية.
اختبار مستمر للكرامة الإنسانية: كل عبور للبوابات يمثل معركة يومية من أجل الحق الأساسي في الحركة، ويعكس التحكم المطلق في الزمن، المكان، والحياة نفسها، مما يجعل الإنسان الفلسطيني في مواجهة دائمة مع آلة الاستبعاد والقهر المنظم.
باختصار، نظام التصاريح لا يقتصر على تنظيم الحركة، بل هو أداة يومية لإعادة إنتاج القهر، السيطرة، والفصل الاجتماعي. كل جانب من جوانب الحياة اليومية – الاقتصادي، التعليمي، الصحي، الاجتماعي والنفسي – يخضع لإرادة السلطة الاستعمارية، ليصبح الإنسان الفلسطيني محاصراً بين القيود المادية والقانونية والنفسية، في تجربة مستمرة للضغط والإذلال، تعكس عمق الهيمنة ونموذجاً حياً للسيطرة الاستعمارية اليومية.
المحور الثالث: الآثار الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والصحية – الأرض والمجتمع تحت حصار الجدار
الجدار ونظام التصاريح لا يقتصران على فصل الإنسان عن المكان، بل يمتد تأثيرهما ليطال كل عناصر الحياة اليومية للفلسطينيين. الفضاء الذي كان مصدراً للمعيشة والإنتاج تحوّل إلى سجن مفتوح تسيطر عليه قوانين التعقيد والتقييد اليومي، ليصبح الإنسان الفلسطيني أسيراً لآلة قهر متعددة الأبعاد، حيث تتشابك الضغوط الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والصحية مع القيود القانونية المستمرة.
اولاً: الآثار الاقتصادية
تراجع الإنتاج الزراعي: حرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وأدواتهم الزراعية، خصوصاً المعدات الثقيلة لإعادة تأهيل الأرض بعد الأمطار أو الاستصلاح، أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاجية. إنتاج الزيتون والمحاصيل الموسمية تقل في بعض القرى بنسبة تصل إلى 40–60%.
انهيار الحركة التجارية: القيود على نقل البضائع، التفتيش المتكرر والمعقد للشاحنات، وإجراءات الموافقات المسبقة تحرم التجار من الوصول إلى الأسواق في الوقت المناسب، ما يجعل النشاط التجاري هشاً وغير مستقر.
تعطيل العمالة والدخل: العمل داخل أراضي 1948 ممنوع، والعمل داخل الضفة مقيد، ما يحرم العمال من فرص عمل مستقرة ويؤدي إلى هشاشة مستمرة في الدخل والعجز الاقتصادي المستدام.
ثانياً: الآثار الزراعية والبيئية
حرمان صيانة الأرض: لا يُسمح للفلاحين باستخدام المعدات الكبيرة لصيانة الأرض أو إعادة تأهيلها، ما يؤدي إلى تدهور التربة وفقدان الإنتاجية.
التهديدات البيئية والصحية: فيضانات مياه الصرف الصحي والمجاري تغمر الأراضي الزراعية والطرق، ما يخلق مكرهة صحية وبيئية تهدد الحياة اليومية للسكان.
امتداد الأشجار الحرجية: توغل الأشجار الحرجية داخل الأراضي الزراعية يحد من المساحات الصالحة للزراعة ويعوق إدارة الأرض واستغلالها بشكل فعّال.
تدهور الاستدامة الزراعية: النقص في الوصول إلى الموارد، وانقطاع الري، وتقييد التنقل يجعل الأراضي عرضة للتصحر، ويؤثر على الغطاء النباتي ويهدد الأمن الغذائي طويل المدى.
ثالثاً: الآثار الاجتماعية والصحية
العزلة الاجتماعية: منع العبور السلس يعوق الروابط الأسرية، ويحد من قدرة السكان على المشاركة في المناسبات الاجتماعية والدينية، ما يضعف النسيج الاجتماعي ويعزز شعور الاغتراب.
إعاقة التعليم: صعوبة الوصول إلى المدارس والجامعات تؤدي إلى تراجع التحصيل الدراسي وتأخر الشباب، ما يعطل التنمية المعرفية ويقيد الفرص المستقبلية.
أزمات صحية مستمرة: عدم القدرة على الوصول إلى المراكز الصحية في الوقت المناسب يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة والحالات الطارئة، ويزيد من الضغط النفسي الناتج عن الانتظار الطويل والإذلال في البوابات.
رابعاً: البعد القانوني والحقوقي
انتهاك القانون الدولي الإنساني: تقييد الوصول الجماعي، الحرمان من الأرض، ومنع الوصول إلى الخدمات الأساسية يمثل انتهاكاً مباشراً لاتفاقيات جنيف الرابعة.
خرق حقوق الإنسان الأساسية: الحق في العمل، التعليم، الصحة، والحركة كلها تتعرض للانتهاك، ما يعكس إخلالاً متعمداً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إعادة إنتاج الفصل العنصري: العزل الجغرافي، القيود اليومية، ونظام التصاريح التعسفي يكرس نموذج فصل عنصري شامل وفق تعريف اتفاقية مناهضة الفصل العنصري لعام 1973.
ولتجسيد عمق القهر وتأثيره على المجتمع الفلسطيني، يمكن تلخيصه وفق الآتي:
ساعات الحياة المراقبة: كل لحظة خارج البيت تخضع لتحديد مسبق، ليصبح الحق الطبيعي في الحركة امتيازاً مشروطاً، وتحول الحياة اليومية إلى جدول زمني مقيد.
إعادة إنتاج الهشاشة: الأسرة، العمل، المدرسة، والرعاية الصحية كلها مرتبطة بإجراءات التعقيد الأمني، فتتحول الحياة اليومية إلى تجربة مستمرة من الضعف والانكسار الاجتماعي والاقتصادي.
إذلال يومي مستمر: عمليات التفتيش التعسفي والإهانات النفسية تمثل ضغطاً دائماً، حيث يتحول القهر القانوني إلى تجربة حسية مباشرة تؤثر على الكرامة الإنسانية لكل فرد.
تقييد التعلم والإنتاج: الطلاب والمزارعون والموظفون يفقدون القدرة على الوصول إلى مدارسهم، أعمالهم، أو أراضيهم في الوقت المناسب، ما يخلق جيلاً محاصراً بين القيد والتأخير، ويحد من فرص التنمية البشرية والاجتماعية.
اختبار مستمر للكرامة الإنسانية: كل عبور للبوابات يمثل معركة يومية من أجل الحق الأساسي في الحركة، ويعكس التحكم المطلق في الزمن والمكان والحياة نفسها، مما يجعل الإنسان الفلسطيني في مواجهة مستمرة مع آلة القهر المنظم والمتعددة المستويات.
باختصار، الجدار ونظام التصاريح يشكلان منظومة قهرية متعددة الأبعاد: يعزل الإنسان عن أرضه، يقيد حركته، يعوق تعليمه وعمله، ويضغط على صحته ونسيجه الاجتماعي، بينما يعيد إنتاج الفقر والهشاشة البيئية والاقتصادية. كل هذه الآثار تجعل من الحياة اليومية للفلسطينيين تجربة مستمرة للضغط والإذلال، نموذجاً حياً للسيطرة الاستعمارية المنظمة والمتكاملة.
المحور الرابع: صمود القرى الفلسطينية المحاصرة – مطالب وتوصيات
في مواجهة القهر اليومي الذي يعيشه سكان القرى الفلسطينية المحاصرة خلف جدار الضم والتوسع، وما يمثله هذا الواقع من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان وفرض تمييز عنصري ونظام أبارتهايد على الأرض، نقدم هذه المطالب والتوصيات كإطار شامل وعميق لدعم صمود المواطنين الفلسطينيين وحماية حقوقهم الأساسية، مع مراعاة الأبعاد القانونية، الإنسانية، الاجتماعية، الزراعية، التعليمية، والصحية.
اولاً: حرية الحركة وكرامة الإنسان
فتح جميع الحواجز والبوابات على مدار الساعة، بما يتيح الوصول الكامل للأراضي الزراعية، المدارس، الجامعات، والمراكز الصحية دون قيود تعسفية.
تقليص الممنوعات لتشمل فقط ما يشكل خطراً مباشراً، مع ضمان عبور آمن وكريم لجميع السكان، خصوصاً الأطفال، كبار السن، النساء والفتيات، والمرضى.
حماية الحق الطبيعي في الحركة كحق أساسي وغير قابل للتجزئة، وعدم تحويله إلى امتياز مشروط.
ثانياً: التعليم والرعاية الصحية
إزالة جميع العراقيل أمام التحاق الطلاب بالمدارس والجامعات لضمان جودة تعليم مستدام وعادل لجميع الفئات.
إنشاء مستشفى دائم وعيادات صحية داخل القرى المحاصرة، تشمل مرافق دعم نفسي واجتماعي لمواجهة آثار العزل والتفتيش التعسفي.
توفير رعاية صحية عاجلة للمرضى وكبار السن، وضمان الوصول الآمن والسريع إلى الخدمات الطبية.
ثالثاً: دعم صمود المواطنين الفلسطينيين على الأرض
حماية الحق الطبيعي في التواجد والعمل على الأرض، سواء في الزراعة أو النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.
تمكين السكان من إدارة مواردهم الطبيعية والزراعية بشكل كامل، بما يشمل استخدام المعدات الثقيلة وصيانة الأراضي.
معالجة المخاطر البيئية طويلة المدى: فيضانات المجاري، توغل الأشجار الحرجية، تدهور التربة، وحماية الموارد الطبيعية لضمان الأمن الغذائي.
دعم المجتمعات المحلية من خلال مشاريع اقتصادية، صحية، وتعليمية نوعية ومستدامة، تضمن استمرار الحياة اليومية وتعزز القدرة على مقاومة القهر والاستيطان.
تعزيز الروابط المجتمعية والنسيج الاجتماعي لمواجهة العزلة والتفكك الناتج عن العزل الجغرافي ونظام الحواجز.
رابعاً: مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
الاعتراف بالانتهاكات على أنها خرق للقانون الدولي: جميع الإجراءات التعسفية بما في ذلك العزل الجغرافي، نظام التصاريح، تعطيل التعليم والصحة، وانتهاكات الأرض تُعد خرقاً لاتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية.
إلزام الاحتلال بالمساءلة القانونية: محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات، وفرض عقوبات فعّالة توقف التمييز العنصري ونظام الأبرتهايد.
حماية السكان الفلسطينيين بشكل فوري: تنفيذ آليات دولية عاجلة لضمان وصول السكان إلى أراضيهم وخدماتهم الأساسية دون تدخل الاحتلال، مع مراقبة دولية مستمرة لضمان التنفيذ.
تعزيز الرقابة الدولية والشفافية: إنشاء آليات توثيق يومية للانتهاكات، وربطها بمؤسسات حقوق الإنسان الدولية لتقرير مستمر لمجلس الأمن، محكمة العدل الدولية، والأمم المتحدة.
ضمان التعويض واستعادة الحقوق: مطالبة الاحتلال بتعويضات عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، واستعادة القدرة على إدارة الأرض والموارد الزراعية بحرية كاملة.
خامساً: مساءلة المجتمع الدولي
إلزام الأمم المتحدة والدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات في القرى المحاصرة، بما يشمل تنفيذ قرارات مجلس الأمن، توصيات محكمة العدل الدولية، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
تفعيل آليات متابعة صارمة وشفافة لرصد الانتهاكات اليومية وفرض عقوبات حقيقية على من يخالف هذه الالتزامات، لضمان تطبيق القانون الدولي وعدم الاكتفاء بالبيانات الشكلية.
توفير حماية دولية فعّالة للسكان من خلال تدخل عاجل لمؤسسات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين، بما يضمن تنفيذ الحقوق الأساسية مثل حرية الحركة، التعليم، الصحة، والعمل على الأرض.
سادساً: حملة عالمية ودولية لدعم صمود القرى
تكليف مؤسسات حقوق الإنسان، المنظمات الدولية، والمجتمع المدني بإطلاق حملة شاملة للتوعية، المناصرة، وحماية السكان.
توثيق الانتهاكات اليومية ونشرها على المستويات الدولية لإبقاء ملف القرى المحاصرة في دائرة اهتمام المجتمع الدولي.
تطوير شبكات دعم مستدامة تربط السكان المحليين بالمؤسسات الدولية لضمان حماية مستمرة وصمود حقيقي.
سابعاً: رؤية استراتيجية طويلة المدى
خطط شاملة لتعزيز القدرة الاقتصادية، التعليمية، الصحية، والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني.
مشاريع مستدامة تعتمد على السيادة الفلسطينية على الأرض والقرارات المحلية، لضمان استمرار الحياة اليومية وحماية حقوق المواطنين.
إنشاء آليات وطنية ودولية للمتابعة والمساءلة لضمان التنفيذ الكامل للمطالب وتحويل الحقوق النظرية إلى واقع ملموس.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .