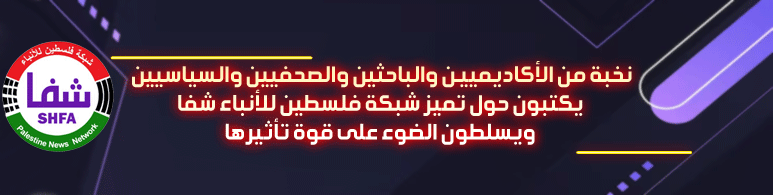فلسفة المقاومة ، بين الحجر والغيمة ، بقلم : د. وليد العريض
(ولِدت هذه المقالة في معركة فكرية مشتعلة مع الأستاذة أميرة مهداوي والدكتورة سارة الشماس، حيث اشتبكت الكلمات بالمشاعر، وارتدى الفكر عباءة التراب المقدّس، وصاغ قلب المقاومة من طين الذكرى ولهيب العشق للوطن).
المقاومة ليست طلقاتٍ فقط، بل طقوس يومية يتقنها من قرر أن يعيش رغمًا عن الموت.
هي أن تنهض من تحت الركام وتبحث عن فردة الحذاء لطفلك كي يذهب إلى المدرسة
أن تُصلح صحن الستالايت كي تلتقط خبراً عن مدينةٍ تشبهك ولا أحد فيها يعرفك.
حين تضيق اللغة بالحياة، تتكلّم المقاومة.
تصبح كل لقمةٍ خبّأتها أمٌّ تحت الحصار فعلاً بطوليًا
وكلّ لحاف فوق جسد رضيع بردان، خطةَ بقاء مدروسة.
المقاومة ليست ردَّ فعل، بل فلسفةُ وجود، تقول:
“أنا هنا وسأظلّ أحب الحياة… ولو كانت سكينًا في خاصرتي.”
الطفل حين يُلقى في وجه الزمن، لا الحجر فقط.
لم يكن الطفل يقذف الحجر، بل كان الحجر يقذفه نحو الخلود.
كل رميةٍ صارت فصلًا في كتاب الجرح وصورةً تُطبع على قمصان الغاضبين في كل اللغات.
ذلك الطفل لم يكبر فقط، بل تحوّل إلى أيقونة لا تشيخ.
حين تصبح الملامح طلقات.
ليلى خالد لم تجرِ عملية تجميل، بل عملية فدائية في وجهها.
نزعت التجاعيد التي يعرفها العدو وزرعت وجها لا يمكن قصفه.
صارت الملامح قناعًا للمطاردة، وابتسامتها أداة خداعٍ للموساد.
في عيادة الجراحة، كانت تصنع شكلًا جديدًا للمرأة التي لا تُهزم.
في الأغنية حنجرةٌ لا تُقصف.
حين غنّت الأمهات عند بوابة السجن: “يا طالعين الجبل”
لم يكن اللحن شوقًا فقط، بل حمولةً سريةً من الصبر
تحملها الريح إلى سجينٍ لا يعرف الوقت، لكنها تخبره:
“أنا معك بصوتي، بدمعي وبوطنٍ صغير يسكن حنجرتي.”
الثوب حين يصبح خريطة.
لم تخطّ المرأة الفلسطينية التطريز للزينة فقط،
بل لتخيط الوطن على صدرها، غرزةً غرزة.
كان كل صليبٍ صغير على الثوب، اسمَ بلدة،
وكل لون، حكاية لدمعةٍ لا تزال تقاوم النسيان.
الجرّة ليست وعاءً، بل ذاكرة.
في بيت لحم، جرّة زيتٍ خبّأت صمودًا لأربع سنين.
لم تكن جدارًا من طين بل جدار كرامة.
الجرار الفخارية لا تفسد، كما لا تفسد الذاكرة حين تُغلق المخازن ويُفتح الجرح.
حين تنحني الطبيعة على أهلها، تصبح جزءًا من الجبهة.
في البترا، الماء ليس فقط ماءً
هو سائل الحياة المحفوظ في باطن الحجر كأن الأنباط قالوا:
“إذا أغلق الرمل فمَ الأرض، نُفجّرها قطرةً قطرة.”
في غزة، البحر لا يمدّ شراعه، لأنّ السمك محتلّ.
تخنق الشبكة الزرقاء أنفاس الموج وتتحوّل الأمواج إلى نداءات لا تُسمع.
لو كان البحر حرًّا، لكان نفقًا نحو الحرية وسمكةً تردّ الجوع.
الحكاية حين تُزرع في الذاكرة، لا تُروى فقط.
الجدّ لا يحكي ليستدرج النعاس من عيون الحفيد،
بل ليزرع فيه سؤالًا يقاوم: متى نعود؟
كل حكاية عن بيت مهجور، بابٍ بلا مفتاح عن بئرٍ جفّ
هي ذخيرة للغد ورصاصة من حنين.
في الأزرار أيضًا تسكن المقاومة.
الهاكر الفلسطيني حين يسرق كاميرات العدو
المصوّر حين يخفي الكاميرا في دمية ابنته
الطفل الذي يُوثّق استشهاد أخيه بهاتفٍ مكسور
كلّهم جنود لا يعرفهم الإعلام
لكن العدو يعرفهم جيّدًا… لأنهم لا يُهزمون.
في الحب مساحة عصيّة على الاحتلال.
أن تحب وطنك، لا يعني أن تهتف باسمه فقط
بل أن تحميه حين يبكي وتزرعه حين يُجفّف
وتغفر له حين يهينك وتحتضنه حين يطردك.
أن تُقبّل حبيبتك عند الحاجز وترسل لها وردةً في جنازة،
أن تكتب لها قصيدةً في حلكة ملجأ
ذاك هو وجه آخر للحرب اسمه الحب.
المقاومة ليست عسكريّة فقط، بل فنّ الحياة تحت قصفها.
أن تُشعل موقدًا وتُعدّ فطورًا في غرفة بلا نافذة
أن تدرّس ابنك على ضوء شمعة
أن تحفر نبتة برتقالٍ على طرف الجدار
أن تضحك رغم الطائرات وتغنّي رغم الدموع
أن تُولد كلّ يوم رغم أنك تموت كلّ ليلة.
في هذا الشرق الموبوء بالهزيمة
وحدها فلسفة المقاومة تمنح الحياة نكهةً تُشبه الغيمة:
خفيفة لكن لا أحد يقدر على حجبها.
وحين تنهمر، تنبت وردًا فوق الحجر.
د. وليد العريض
مؤرخ، أديب، شاعر وكاتب صحفي
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .