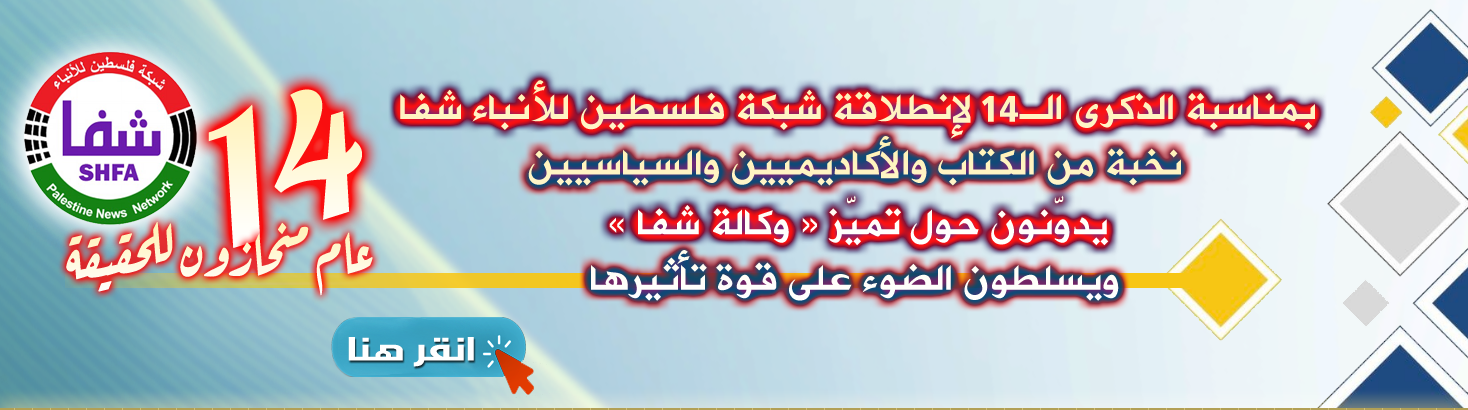صلابة نفسية أم تخدعنا الانطباعات؟ ، بقلم : أ. مروة معتز زمر
حياتنا مزيج من المواقف والأحداث التي تشكّلت عبرها شخصياتنا؛ مزيج يحمل داخله ندوباً صغيرة وكبيرة، لمسات من الألم، ارتعاشات خوف، لحظات فقدٍ لم نكن مستعدين لها، وَومضات من الفرح جاءت كاستراحة قصيرة وسط الطريق.
كل إنسان يمشي وهو يحمل حقيبة لا تشبه حقيبة غيره، وإن تشابهت الأحداث الظاهرة، فإن العمق يظل فريداً، لا يشاركنا أحدٌ رؤيته ولا يجدل خيوطه سوى نحن، ومع كل موقف جديد، يطلّ علينا سؤال وجودي يلاحقنا بإصرار..
لماذا يمرّ البشر بالمواقف ذاتها تقريباً، بينما تختلف ردود أفعالهم إلى حدّ صادم؟ لماذا ينهار أحدهم من ضربة بسيطة، فيما يقف آخر ثابتاً أمام كارثة تهدّ الجبال؟ ولماذا يبدو الآخرون أكثر قدرة على التحمل منّا؟
هذا السؤال ليس بسيطاً كما يبدو، ولا تُجاب عليه بعبارات تحفيزية سطحية أو بترديد جمل عن الطاقة الإيجابية.
إنه سؤال يمسّ العمق النفسي، والاختلافات الجوهرية في الشخصية، والمسار الروحي للإنسان، والخبرة المتراكمة التي لا يراها أحد.
لماذا يبدو الآخرون أكثر تحملاً منّا؟ ليس مجرد سؤال عابر، بل نافذة على أحد أكثر التحيزات الإدراكية إثارة للعزلة النفسية.
الفجوة الحقيقية ليست في قدرة التحمل، بل في زاوية الرؤية نحن نعيش ظاهرة الانزياح الإدراكي النفسي؛ حيث نرى حياتنا من الداخل بكل تفاصيلها الهشة، بينما نرى حياة الآخرين من الخارج عبر سلوكياتهم المصفّاة.
على الرغم من أن مصطلح “الانزياح الإدراكي” هو مصطلح تقني فيزيائي في الأساس، إلا أن المبدأ الكامن وراءه، وهو “اختلاف المنظر”، له وجود عميق ومهم في علم النفس الإدراكي، خاصة في مجالات الإدراك الحسي والمعرفي
وإذا ما استعرنا مصطلح الانزياح الإدراكي (بمعناه المجازي) وربطناه ببعض أنواع التشوهات المعرفية التي تدرس في علم النفس المعرفي والسلوكي، فكما أن الانزياح الإدراكي التقني ينتج قراءة خاطئة بسبب زاوية الرؤية، فإن التشوه المعرفي ينتج استنتاجاً خاطئاً أو عاطفة سلبية بسبب “زاوية رؤية” ذهنية غير صحيحة أو منحازة (مثل التفكير الكلي أو الجزئي، أو القفز إلى الاستنتاجات). فنحن ننظر إلى حياتنا من الداخل (المنظور الذاتي)، وننظر إلى حياة الآخرين من الخارج (المنظور الاجتماعي الظاهر). هذا الاختلاف في زاوية الرؤية يخلق تحيزاً إدراكياً يجعلنا نعتقد خطأً أن الآخرين يعيشون حياة أسهل، وأنهم يتحملون أكثر منا، أو أن معاناتهم أقل عمقاً.
ولكن لماذا نقع في هذا الفخ الإدراكي؟ لأننا نصل إلى كامل البيانات العاطفية لأنفسنا (المشاعر الأولية، الأفكار الجانبية، الذكريات المؤلمة، والحوار الداخلي)، بينما نصل فقط إلى البيانات الظاهرة اجتماعياً من الآخرين (السلوك الظاهر، الكلمات المختارة، التعابير المُتحكَّم بها) نحن نقارن إذن بين الخام والمُصَنَّع، بين المادة الأولية والمنتج النهائي.
نقارن ما لا يقارَن؛ مشاعرنا الخام بتصرفاتهم المهذبة، انهيارنا الداخلي بابتسامتهم الخارجية، ضعفنا الحقيقي بصورة قوتهم الظاهرة، هذه المقارنة المجحفة تنشأ لأننا نرى جانباً واحداً فقط من حياة الآخرين، بينما نعيش جميع جوانب حياتنا، وجعك يملأ داخلك ولا يراه أحد، بينما وجع الآخرين قد يكون أعمق لكنه لا يظهر في سلوكهم.
هذا التحيز لا يبقى مجرد خطأ في الملاحظة، بل له تبعات عميقة، مثل:
تعزيز الشعور بالعزلة؛ “أنا وحدي من يشعر بهذا القدر من الألم”، وتقليل التعاطف مع الذات: “الآخرون يتعاملون بشكل أفضل، إذن أنا ضعيف”، إضعاف التواصل العاطف؛ عدم مشاركة المعاناة خوفاً من أنها “تافهة” مقارنة بما يبدو أن الآخرين يتحملونه، تضخيم المعاناة الذاتية؛ لأنها تُرى على خلفية من الكمال الظاهري للآخرين.
ومع كل هذا، فإن الاختلاف في ردود الأفعال ليس معجزة، بل جزءٌ من الفروق الفردية التي درسها علم النفس بعمق؛ فالذي يحمل مستوى عالياً من الاتزان العاطفي يختلف تماماً عن الذي ترتفع لديه العصابية (الميل إلى تجربة المشاعر السلبية كالقلق والغضب والحزن)، والذي يمتلك انفتاحاً للحياة ولمنعطفاتها، يساعد الفرد على رؤية المنعطفات الصعبة ليس ككوارث، بل كفرص محتملة للتعلم أو لإعادة توجيه المسار.
يبرز هنا تنوعٌ عميق في التعامل مع التجارب فهناك من يتعامل مع الألم بوصفه حدثاً، وهناك من يتعامل معه بوصفه تهديداً، وهناك من يراه انعكاساً لقيمته الذاتية. وهذا وحده كافٍ لصناعة ردود أفعال متباينة جذرياً، حتى لو كان الحدث واحداً. فالاختلاف هنا ليس في قوة التحمل فقط، بل في طريقة تفسير الموقف، في الحوارات الداخلية، في الذاكرة العاطفية، وفي التجارب السابقة التي صقلت الشخصية.
كما أن أحد الأسباب العميقة التي تجعل الآخرين يبدون أكثر احتمالاً منا هو خبراتهم السابقة؛ فالإنسان الذي واجه العاصفة مرة، لن يراها بالطريقة نفسها في المرة الثانية، ومن عرف طعم الانكسار، يصبح حساساً لكنّه أيضاً واعٍ بمكامن الخطر، ومن نجا من سقوطٍ قاسٍ، أدرك أن الأرض ليست نهاية العالم، بل بداية جديدة.
هذه الخبرات هي المصدر الأقوى لفعالية الذات (أي الإيمان بقدرتك الشخصية على النجاح، إنها التجارب الناجحة الملموسة التي تبني الثقة والكفاءة من خلال تخطي التحديات).
وهنا يظهر شيء مهم أنت ترى الشخص في اللحظة التي يقف فيها، لكنّك لم ترَ لحظة سقوطه الأولى، ولا الألم الذي جرّبه مراراً حتى صار احتمال الموقف جزءاً من تركيبته.
فالآخرون قد يكونون أكثر احتمالاً ليس لأنهم أقوى، بل لأنهم جربوا السقوط أكثر منا، ربما تعافوا من محنة قديمة، وربما مروا بنار صهرت الكثير من خوفهم. ونحن لا نعرف خلفيات الآخرين، ولا معاركهم القديمة، ولا عدد الليالي التي سالت فيها دموعهم قبل أن يكتسبوا هذه القدرة على الوقوف.
هذا ويعتقد الكثيرون أن التحمل مسألة قوة، وأن الإنسان القادر على الصمود هو ببساطة أقوى من غيره لكن علم النفس الحديث يقدّم رؤية مختلفة تماماً، فالقدرة على الاحتمال النفسي ليست قوة عضلية للروح، بل هي قدرة عميقة تنبع من وجود معنى، هدف، غاية، شيء يستحق أن نتحمل من أجله.
هذا ما أشار إليه “فيكتور فرانكل” في العلاج بالمعنى، حين لاحظ (أن الإنسان يستطيع احتمال أيِّ كيف إذا وجد لأجله لماذا”.. أي أن وجود معنى أو هدف أعلى يجعل المعاناة محتملة) لهذا يبدو بعض الناس أكثر احتمالاً؛ ليس لأنهم لا يشعرون بالألم، بل لأنهم يعرفون أن داخل هذا الألم بذرة معنى، فالفرد الذي يربط محنته بمعنى (كحماية عائلته، أو الدفاع عن مبدأ يؤمن به، أو تحقيق نمو شخصي، أو خدمة قضية أكبر) يجد قوة تحمل تفوق بكثير من يرى المحنة كعقوبة عشوائية أو كَشرٍّ محض، المعنى يعمل كمُعدِّل قوي للألم النفسي.
أضف إلى ذلك أن الصلابة النفسية، تجعل الإنسان يرى الضغوط لا كتهديد، بل كجزء من مسار النمو، إنه لا يفهم الألم بوصفه عقوبة، بل تحدياً يعيد ترتيب الداخل، وبفضله يتقوّى البناء.
وهذه الأبعاد النفسية لا تظهر للعين، فقد ترى شخصاً يبدو ثابتاً، لكنك لا ترى الرحلة الطويلة التي صنعت هذا الثبات، ولا الصراع الذي انتقل من سطح روحه إلى عمقها حتى صار جزءاً من نسيجه.
ولو نظرنا للموضوع من منظور ديني، نجد أن الإنسان لا يُختبر بما لا يحتمل.. هذه ليست جملة تواسي، بل قانون روحي دقيق لو بدا لك أن غيرك يتحمل ما لا تتحمله أنت، فهذه ليست مقارنة عادلة؛ لأن وسعك يختلف عن وسع الآخرين، ورزقك الروحي يختلف عن رزقهم، وقدر احتمالك قد يكون أعظم مما تظن، لكن في مجالات مختلفة، قد يُبتلى أحدهم بفقد فتحمله روحه، وقد تُبتلى بشيء آخر يراه الناس بسيطاً بينما هو يجتاح داخلك.
والله وحده يعرف من أين يدخل الابتلاء، وأين تكون المنفذ الذي يسمح بالنور، هذا البعد يمنح المعاناة معنى، والمعنى يمنح الإنسان قوة احتمال عميقة لا تُرى لكنها تتجذّر في الروح.
وهذا يؤكد أن الاختلاف في قدرة التحمل ليس وهمياً بالكامل، فهو حقيقي وله أسس نفسية راسخة، هذه القدرة ليست سمة ثابتة، بل هي نتاج تفاعل ديناميكي لعوامل متعددة، وإن فهم هذه العوامل لا يكتمل إلا بترجمته إلى خطوات عملية تدفعنا نحو الأمام، بعيداً عن دوامات المقارنة المجحفة وجلد الذات.
الخطوة الأولى تكمن في التوقف عن المقارنة غير العادلة بتذكير النفس باستمرار أننا نرى من الآخرين فقط القشرة الخارجية المصقولة، بينما نعيش نحن أعماقنا الهشة كاملة. استبدل سؤال “لماذا أنا أضعف منهم؟” بسؤال أكثر إنتاجية: “ماذا يمكنني أن أتعلم من طريقة تعاملهم؟”، مع الإدراك الواعي أنك تجهل الثمن النفسي الذي دفعوه مسبقاً لاكتساب تلك الطريقة.
هذه النقلة تفتح الباب لـتطوير التعاطف مع الذات، حيث تتعامل مع نفسك بلطف ومساحة للضعف، كما تتعامل مع صديق عزيز يمر بأزمة، لأن قسوة النقد الذاتي تستنزف الطاقة ذاتها التي تحتاجها للتعافي. ولا يتحقق التعافي دون البناء المتعمد لخبرات الإتقان، من خلال تقسيم الأهداف الكبرى إلى خطوات صغيرة يمكن إنجازها، والاحتفال بتلك الإنجازات الصغيرة، وتحويل الفشل من دليل على العجز إلى فرصة للتعلم، وليكن دافعك هو البحث عن المعنى الشخصي خلف المحنة، بتوجيه أسئلة مثل: ماذا علمتني هذه التجربة؟ كيف يمكن أن تجعلني أكثر حكمة؟ وأي قيم تؤكدها في حياتي؟ ويدعم هذا كله تنمية الصلابة النفسية عبر الالتزام بالروتين الإيجابي، والتركيز على ما يمكنك التحكم به (كردود فعلك واختياراتك)، واعتبار التحدي فرصة لاختبار قدراتك.
وأخيراً، لا تستهين بقوة طلب الدعم، فمشاركة التجربة مع شخص موثوق تكسر وهم العزلة وتذكرك بأنك لست وحدك في هذه المعركة.
هذه الخطوات المتسلسلة تشكل خريطة عملية للانتقال من موقع المراقب الذي يحسد الآخرين على “قوتهم”، إلى موقع الباني الذي يصنع صلابته الخاصة، خطوة واقعية تلو الأخرى.
وعلى هذا النسق، فالحقيقة أن الإنسان لا يقارن نفسه بغيره إلا إذا فقد رؤية ذاته بوضوح، فالتحمل ليس سباقاً، ولا معياراً للتفوق، بل رحلة شخصية جداً، تتشكّل من المعنى، والخبرة، والروح، وطريقة تفسير المواقف. الآخرون لا يتحملون أكثر منا… هم يتحملون بطريقتهم، ونحن نتحمل بطريقتنا، وكل روح لها طريقها الذي لا يشبه أحداً، ولا يُقارن بأحد، ولا يُروى إلا من الداخل.
- – أ. مروة معتز زمر – أخصائية نفسيّة تربوية
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .