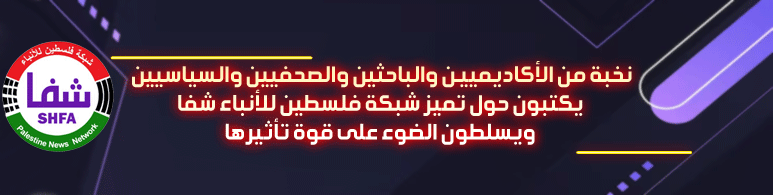قصة قصيرة من دروب الطفولة بعنوان: قافلة فاطمة إلى أبواب السماء ، بقلم : غدير حميدان الزبون
لم يكن الفجر في ذلك اليوم مثل سائر الأفجار، كان أشبه بحبر ذهبي يسكب نفسه على حجارة الجبال المحيطة، كأنّ الكون يكتب على صفحة الأفق اسمًا واحدًا هو اسم فاطمة.
يومها أيقظتنا أمي صبيحة الجمعة قبل أن تكتمل الشمس، قالت بصوتٍ يخلط بين الأمر والرجاء:
“اليوم سنذهب إلى القدس، لا أحد يتأخر، ولا أحد ينسى قلبه في البيت”.
كنت في العاشرة، أتوسّط إخوتي وأحمل ضفائري رايتين صغيرتين تلوّحان للريح، وفي صدري أسئلة أكبر من عمري.
كانت أمي آنذاك في ربيع حياتها، لكنّ ملامحها بدت وكأنها تعرف سرّ رحيلها القادم، فحملت في خطواتها استعجالًا لم أفهمه إلاّ حين غابت.
وصلنا باب الخليل، ودخلنا في حكاية قديمة حُبكت من خيوط ذهبية ودموعٍ ياقوتية. الأزقة ضيّقة، لكنني كنت أشعر أنّ جدرانها تتنفس معنا، وبدت قباب المدينة كأجراسٍ مقلوبة، تدقّ بصمتٍ في قلب السماء.
تسلّلت رائحة الكعك بالسمسم من الأفران الحجرية معانقة أنفاسي مثل دعوة سرية، فأمسكت أمي بيدي وقالت:
“هيا، سنشتري كعكًا، فالقدس لا تُزار على معدة فارغة”.
اشترت لنا أرغفة كعك دافئة، ووزّعتها كما توزّع الأمهات الحلوى في الأعراس. قالت وهي تبتسم بمكر:
“من يأكل أولًا تفتح له الملائكة بابًا في السماء”.
فضحك إخوتي، وأخذوا يلتهمون الكعك كما لو أنّ كل قضمة وعدٌ بدخول الجنة.
أكلنا وأكلت معنا طيور المدينة تلك الحمائم التي كانت تحلّق وادعة فوق قباب القدس، وتنقر السمسم من أيدينا البريئة الصغيرة بثقة واطمئنان رغم شقاوة الأطفال كأنّها تعرف أننا أبناء هذا المكان فهبطت وسكنت بسلام.
لم تكن الطيور يومها تعرف الجوع، كانت تتقاسم معنا فتات الخبز وهي تضحك بلغتها الخفية، تطير وتعود، تحطّ على شبابيك الحجر العتيق، وتغني للريح أغنية لم تنقطع منذ ألف عام.
لكنّ الزمن استدار، وأصبح لتلك الطيور وجوه أخرى.
اليوم، صارت جائعة وخائفة، تنكمش في أعشاشها عند الفجر، وترتجف كلما دوّى في السماء صوت يشبه البرق لكنه ليس ببرق.
باتت تحمل على أجنحتها ذاكرة قباب القدس وتوابيت غزة، وتعرف أنّ جرح البحر في الجنوب هو جرحها هي أيضًا، فصارت تهاجر مبكرًا، لكنّها تلتفت نحو الجنوب في كلّ طيران، تريد أنْ تحرس بأجنحتها بيوتًا بلا سقوف، وأنْ تحلّق فوق البحر هناك حتى يعود الصغار الذين كانوا يطعمونها كسرة خبز، قبل أن يبتلعهم الغبار.
في باحات الأقصى، كانت أمي تصلي، وكنت أراقب يديها المرفوعتين ترتجفان قليلاً كما ترتجف أوراق الزيتون حين تمرّ بها نسمة من بحر يافا البعيد.
الأذان والتراتيل النصرانية امتزجتا في الهواء، فصارت القدس كلها كنيسة وجامعًا في آن.
اقتربت من أمي وهمست:
“مع من تتحدثين يا أمي؟”
فابتسمت وهي لا تزال في سجودها وقالت:
“مع الله، ومع القدس أيضًا”.
اشترينا الحلوى الملوّنة، وكنت أضعها في جيبي فتبدو مثل قطع من قوس قزح أردت أنْ أخبئه من الغيم، لكننا أنفقنا آخر ما في الجيب، ونظرنا إلى بعضنا في حرج، فضحكت أمي وقالت:
“إذن نعود كما عاد أجدادنا سائرين على أقدامنا، والريح تتبعنا”.
خرجنا من باب النبي داوود، والقدس خلفنا تلوّح بثوبها الموشّى بالذهب والحجارة العتيقة. عبرنا حي الأرمن، حيث الجدران العتيقة تحرس حكايات الرهبان، وأجراس الكنائس ما زالت تدقّ للغائبين.
ثم انحدرنا نحو حي النبي داوود، هناك شعرت أنّ الهواء يزداد ثِقلاً، كأنّه يحمل على كتفيه تاريخًا لا يشيخ.
سرنا بمحاذاة حي أبو طور ببيوته البيضاء المطلّة على وادي قدرون الصامت مثل راهب متنسّك يطيل الصلاة، وواصلنا المسير حتى بلغنا دير مار إلياس، كان يجثم شامخًا على تلة من الزيتون يحاكي حارسًا حجريًا يراقب القوافل منذ قرون، وقد مدّ ظله ليظلل خطانا.
وفي الطريق، مررنا بــ بيت صفافا بشرفاتها التي تعانق الغيم، ونسوتها اللواتي لا زلن يخبزن على الصاج، ويرسلن لنا روائح الخبز الساخن كأنها رسائل محبة من دفء خفي يحيط بالشتاء.
ومن هناك وصلنا إلى شرفات القرية الصغيرة الوادعة التي بدت كأنها زهرة برية نبتت على كتف الطريق، يحيط بها الزعتر والمريمية كإكليل دائم الخضرة.
وأخيرًا عند انحناءة الطريق ظهر قبر راحيل في الأفق مغتسلا بضياء الغروب الأرجواني، كأنّ الشمس وضعت يدها على الحجر لتواسيه.
توقفت أمي عند مدخل مدينة بيت لحم، وأسندت جسدها إلى سور المقبرة الإسلامية التي احتضنتها بعد أعوام، شعرت بأنّها كانت تودّع مكانًا تعرف أنه سيكون مثواها الأخير. مرّرت كفها على السور برفق كأنّها تربّت على كتف صديق قديم، ثم همست بصوتٍ يشبه البكاء المكبوت:
“هنا تنتظر القدس أبناءها، وأخشى أنها ستظل تنتظر”.
كان صدى كلماتها يتشابك مع أنفاس الريح، فتتردد في الحجارة التي تحت أقدامنا تلك الحجارة التي تغني أغنية قديمة، ربما رددها الكنعانيون حين كانوا يعبرون هذا الدرب إلى معابدهم حاملين قرابينهم من القمح والزيت والندى، وفي تلك اللحظة شعرت أنّ الطريق نفسه ينحني احترامًا لها، وأنّ المقبرة رغم صمتها تفتح أبوابها لتستقبل من سارت على درب النور حتى النهاية.
للحظة تبدّل التعب إلى مرح، وراح إخوتي يتسابقون، وأحدهم يقلد صوت حمار صادفناه في الطريق الوعرة يحمل أسفارا أثقلت ظهره، فما كان من الحمار إلّا أنْ عبّر عن غضبه معترضا بالنهيق المستمر دون توقف.
يستمر أخي بتقليد الصوت دون توقف، والحمار يقلّده مجدّدا فتنفجر الضحكات منّا في أرجاء المكان، وأنا أتعثر في حجارة الطريق إلى يومنا هذا، ولا تزال أمي تشدّني من يدي وهي تضحك حتى تدمع عيناها.
كانت فاطمتي تمزج الحزم بالفكاهة، وكأنها تعرف أنّ الرحلة لا تكتمل إلا بالضحك الذي يخفف عن الأرجل ما يثقلها حتى بلغنا مشارف بيت لحم والمساء يضع عباءته الأرجوانية على التلال. في تلك الليلة حين وصلنا بيتنا ظننت أنّ الرحلة انتهت؛ لكنني اليوم وبعد أن غابت أمي أدرك أنّ تلك الرحلة لم تكن إلى القدس وحدها، لقد كانت إلى أعماق قلبي، إلى جذور الأرض التي أنجبتني، وإلى أسطورة أبدية كانت أمي بطلتها التي تسير على درب النور، ونحن خلفها كقافلة صغيرة تحرسها ملائكة الأرض والسماء.
نعم، أقولها الآن وبكل ثقة وأنا في الأربعين، لقد كانت تلك الرحلة إلى قلب الأسطورة، إلى دربٍ لا يزال مضيئًا بنور أمي، حيث تمشي أمامنا دائمًا، وفوقنا طيور الحجل، وخلفنا ريح مريم، وإلى جانبنا قريتي المالحة، حتى نصل جميعًا إلى الوطن الذي لا يرحل.
لم أدرك إلاّ بعد سنين أنّ تلك الرحلة لم تكن إلى القدس، بل كانت رحلة في القلب عبر بوابات التاريخ، تسير فيها أمي فاطمة على درب النور، ونحن خلفها كقافلة صغيرة تحرسها أساطير الأرض.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .