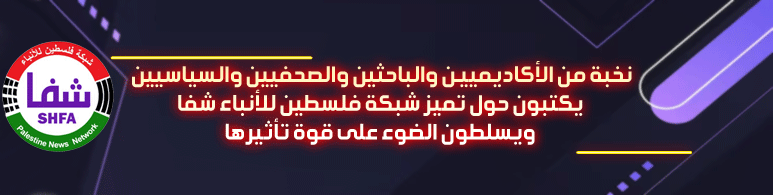الدكتور نبيل طنوس… حين يُترجم القلب إلى لغةٍ أخرى ، بقلم: رانية مرجية
في زمنٍ تتكاثر فيه الكلمات وتقلّ فيه المعاني، يظهر فجأة صوتٌ استثنائي، لا يُشبه سوى ذاته، لا يصرخ، لا يستعرض، بل يترجم.
نعم، يترجم، ولكن ليس كما يترجم الآخرون.
لأن الدكتور نبيل طنوس لا ينقل الكلمات، بل ينقل الأرواح.
لا يترجم جُمَلًا، بل يكتب جسورًا من الحبر والنبض.
منذ متى أصبحت الترجمة فعلًا مقاومًا؟
منذ متى أصبح المترجمُ هو الشاهد الذي لا يكذب، الذي لا يخون النص ولا يخون روحه؟
منذ أن بدأ نبيل طنوس يترجم.
أدبنا الفلسطيني، بشعره ونثره وهمّه وحنينه، وجد فيه صديقًا حقيقيًا، لا يُجمله ولا يُخفي عيوبه، بل يُقدّمه كما هو: حقيقيًّا، حيًّا، عاريًا أحيانًا، ولكن دائمًا نبيلًا.
حين تُترجم قصيدة من العربية إلى العبرية، نرتجف.
هل ستبقى فلسطين فيها؟
هل سيبقى وجعنا، ياسميننا، مساجدنا وكنائسنا، رائحة خبز أمهاتنا؟
لكننا حين نقرأ اسم نبيل طنوس، نطمئن.
لأنه يعرف، ببصيرته قبل بصره، كيف يُحافظ على الوطن داخل السطر.
في زمن التنميط والتسطيح، اختار نبيل طنوس أن يُترجم الجمال المقموع، أن يُقدّم للقارئ العبري أدبنا كما لم يعرفه من قبل.
لا كبطاقة هوية رمادية، بل كغابة مشاعر، كشتاء طويل، كأغنية لم تُترجم أبدًا حتى أتى هو وجعلها قابلة للفهم… وللحب.
ترجم أعمالًا لشعراء وكتّاب من الصفوف الخلفية، لا لأنهم أقلّ، بل لأنهم حقيقيّون.
لم يتهافت وراء أسماء السوق، بل بحث عن جوهر النص، عن وجعه، عن نوره، ثم أعاده للحياة بلغة أخرى دون أن يمسّ قلبه.
أن تترجم يعني أن تُصدّق النص.
أن تحترمه.
أن تتواضع أمامه.
وهذا ما يفعله نبيل طنوس بلا ادّعاء.
يكتب بلغة ليست لغته الأم، لكنه يزرع فيها أمهاتنا، قُرانا، ولهجة جدّاتنا… كأنها كانت لغته منذ البدء.
في زمن باهت،
نحتاج إلى أن نشكر من يحفظ لنا أرواحنا حيّة بين الكلمات.
والدكتور نبيل طنوس، بأمانته، بصدقه، بموهبته التي لا تُشبه أحدًا،
هو أحد هؤلاء القلائل.
فلنقلها ببساطة:
لو كانت الترجمة ديانة، لكان نبيل طنوس أحد أنبيائها.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .