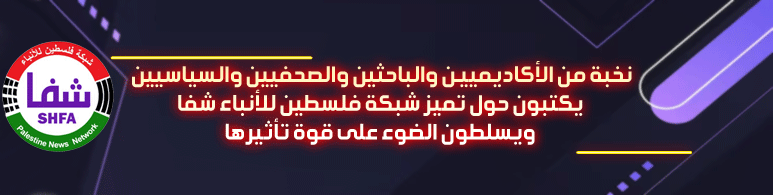قراءة في مرثية إياد شماسنة ، “مات أبي ، وماتت القصيدة قبل أن تولد” بقلم: رانية مرجية
ليس كل من كتب عن موت الأب، قد عاش الفقد كما كتبه إياد شماسنة.
هذه ليست مرثية بالمعنى التقليدي، بل زلزال هائل في اللغة والمشاعر والكينونة، يخرج من حنجرة مبحوحة تحت الأنقاض، حيث لا عزاء إلا في الكتابة، ولا خلاص إلا بالحبر، إن لم يكن قد جفّ.
منذ السطر الأول، نحن لسنا أمام قصيدة عن الأب، بل أمام انهيار صامت للذات:
“لم يكن أبي ملاكًا،
كان يكذب أحيانًا
كي لا يُفزعنا من هذه البلاد.”
يا لهذا الاعتراف البريء، النقي، الذي يمسّ عمق إنسانيتنا!
هنا يكسر إياد شماسنة الصورة النمطية للآباء الملائكيين، ويقدّم أبًا واقعيًا، يخبئ الحقيقة لا لأنه خائف، بل لأنه كان درعًا بين أطفاله والعالم.
إنه يكذب كي لا نفزع، يضحك كي لا نغرق، يحمل الألم على ظهره كمن يحمل صليبه، ويخفي “دين الدكان” خلف ضحكة نصفها قلق ونصفها رجاء.
الغياب ليس موتًا فقط… بل انكسار في قوانين الحياة
“حين مات،
سقطت شجرةٌ في داخلي
لم يسمعها أحد.”
ليست مجرّد شجرة، بل جذر الوجود ذاته.
إنه سقوط لا يراه أحد، لكنه يخلّف فوضى داخلية عارمة.
يصبح كل شيء بعده “ناقصًا”، حتى الاسم، حتى الهواء، حتى الضوء.
لقد تغيّرت في موته قوانين الطبيعة:
الهواء صار بطعم الإسمنت،
الضوء تغيّر زاويته،
الجدران صارت تملك عيونًا ترصد الألم.
هذا ليس حزنًا عابرًا، بل تفكك داخليّ كامل، انهيار تركيبيّ في البناء النفسي والعاطفي للمكلوم.
الأب… بيت لا تراه، وسقف لا تشعر بوجوده إلا حين يسقط
في واحدة من أقسى صور الفقد وأكثرها صفاءً:
“أبي،
الذي ما انحنى
إلا ليربط حذائي،
ها أنا أنحني،
ولا أحد يعيد لي قامتي.”
أي سكينٍ هذه التي يزرعها الشاعر في صدر القارئ دون دم؟
أي انكسارٍ يتحدث عنه، حين تصبح الرجولة محاولة مستميتة للتماسك، لا للبقاء؟
لقد رحل الرجل الوحيد الذي كان يربط التفاصيل الصغيرة، ويشدّ خيوط الحياة الهشة.
“أبي،
كان بيتًا بلا جدران،
كلّما ضاقت الدنيا
اتّسعتْ في صدره.”
كم نحن أبناء بيوتٍ لا جدران لها، نحتمي من برد العالم بدفء نظرة، وطمأنينة صوت، وسعة حضن.
لكن حين يرحل الأب، تُغلق الحياة علينا من كل الجهات، وتتحوّل مفاتيح الطفولة إلى خردة داخل قبر، وتُدفن القصيدة في ذات الحفرة مع جسده.
رجولة هشّة تتدرّب على الصمود
“كان صوته
مثل حطبٍ يشتعل في الشتاء،
يقول لي:
“كن رجلًا،
ولا تبكِ”،
ثم يبكي سرًّا
كي لا أرى ضعفه.”
إنها واحدة من أجمل لحظات القصيدة وأكثرها إنسانية.
الأب الذي يربّي على الرجولة، لا يفعلها عن قسوة، بل عن حب.
يبكي في السرّ لأن الأب يجب أن يكون الجبل، حتى لو تفتّتت روحه من الداخل.
لكن بعد موته، كل شيء يُترك للابن:
“أبي،
الذي حمل العالم
فوق كتفيه،
رحل،
وترك العالم على صدري أنا.”
ما أثقل هذا الإرث، وما أتعس هذا الانتقال الجبري للعبء، من كتفٍ أنهكه التعب إلى صدرٍ لا يزال يرتجف تحت وطأة الذكرى.
النهاية: القصيدة التي لم تولد
“مات أبي،
فماتت إحدى أسماء الحب،
وماتت يدي التي أكتب بها،
وماتت القصيدة قبل أن تولد.”
إنها نهاية تختصر كل شيء.
الفقد هنا لا يُنهي فقط الأب، بل يُنهي اللغة نفسها، الإبداع، الكتابة، الذاكرة، كل ما يجعلنا بشرًا.
يموت الحب، وتتيتّم اليد، وتتعطّل القصيدة، لأن مَن كان ملهمها قد غاب.
“وها أنا،
أحاول أن أكون ظلّك،
فأصير رجلاً ممزّقًا
بمقاسك تمامًا.”
هكذا تنتهي المرثية كما بدأت: باعتراف الهشاشة.
الابن لم يتحوّل إلى الأب، بل صار ظلّه المشوّه، صورةً باهتة من قوة لم تعد، وحبٍّ لم يُشفَ من فُقدانه.
في الختام
لا تكتب القصائد الكبرى فقط بالحبر، بل بالدم والدموع والفقد العميق.
وما كتبه إياد شماسنة في هذه المرثية، هو أبعد من حزن على أبٍ رحل،
هو لحظة فناء وولادة، لحظة تحوّل الإنسان من ابنٍ محمي إلى رجلٍ يحمل العالم وحده.
هذا النصّ لا يُقرأ، بل يُبكَى، ثم يُحتضن كطفل يتيم في جنازة من الذكريات.
بقلم: رانية مرجية
25 تموز 2025
الرملة – فلسطين – من رحم الغياب
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .