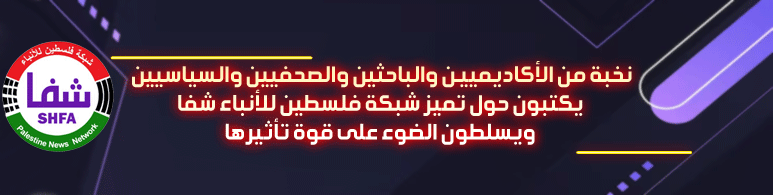“من خلف الزجاج: تأملات في وجوه الشهداء” ، بقلم : سمر فرحات
في ظهيرةِ أربعاءٍ مثقل،
حيثُ الغبارُ يفيضُ على الموتِ في بلادٍ اعتادت أن تفقدَ أكثرَ مما تُحصي،
ارتمت حافلةُ بلدتي ببتا، عندَ الجدارِ الإسمنتيِّ الأبيض.
جدارٌ خُصِّصَ لصورِ الشهداءِ وأسمائهم،
ينتصبُ في خاصرةِ البلدةِ كندبةٍ أبدية.
يحفظهُ الناسُ كأنَّه من نَسَبِ العائلة،
وينطوي على حزنٍ أجوف.
لم يكن حياديًا كما يبدو،
بل تحوّل إلى محرابٍ للوجوه،
قبل أن يصبح مرقدًا للأجساد.
جدارٌ لم يَعُد فاصلًا بين أرضين،
بل بين بُعدين:
من عبروا إلى ضوءٍ لا نبلغُه،
ومن ظلّوا على الضفةِ الأخرى،
ينقبونَ في الصورِ كمن ينبشُ وجعًا قديمًا لا يُشفى منه.
من مقعدي الأخير،
ومن وراءِ زجاجٍ لوّثته أناملُ طفلةٍ لوّحت للشهداءِ من قبلي،
أطلُّ على وجوهٍ تصطفُّ في خشوعٍ مهيب.
كأنها بنيانٌ مرصوص،
تؤازرُ بعضها بنظراتٍ تتقاطعُ في صمتٍ جليل.
وأكاد أُقسم أن جميعَهم يتقاسمون ذاتَ العين،
ذاتَ الابتسامة.
ينظرونَ في عينيكَ مباشرة، باتساقٍ مريب.
أحاولُ التحديق،
لكنَّ الزجاجَ معطوب،
تتّسخُ منه الرؤيةُ فلا تتّضح.
أتنقلُ بثقلٍ من الملامحِ إلى الأسماء،
ومن الأسماءِ إلى الأعمار،
ومن الأعمارِ إلى تواريخِ الغياب.
وأتساءل:
لو لم يُختطفوا من الحياةِ على عجل،
أيَّ الطُرقِ سلكوا؟
وأيَّ المصائرِ نحتتهم؟
ربما نال أحدُهم شهادةً جامعية،
وربما ذاك عانقَ فرحًا وأصبح أبًا،
وآخرُ الآن يحتسي الشايَ بالنعنعِ مع والدته،
وآخرُ لا يزالُ يداعبُ قطةَ الحيّ تحت شجرةِ التوتِ التي لم تُقتل بعد.
تترنّحُ عيناي،
أُحاولُ الفرارَ من طوفانِ الفكرة،
لكنها تطبقُ عليّ،
كأني أُستدرجُ إلى واجبٍ لم يُؤدَّ،
أو دينٍ لم يُسدَّد.
ثم تقعُ عيني على صورةِ فتى لم يزل غضًّا،
وُلدَ للحياة، فابتلعتْهُ الشهادة.
كتبوا تحتَ صورته:
“على هذه الأرض ما يستحق الحياة.”
فأتمتمُ بعتاب:
أكان الثمنُ باهظًا إلى هذا الحدِّ يا درويش؟
كم من الحياةِ وجب أن ندفع،
حتى نمنح الحياةَ حقَّها في البقاء؟
أمدُّ يدي المرتبكة نحوَ النافذة،
أحاولُ مجددًا إزالةَ الضباب،
لكنه يأبى الانقشاع.
فنحنُ – يا درويش – لا نُبصرُ العالمَ إلا من خلالِ تشقُّقاتِ الزجاج،
فالرؤيةُ الحقيقية،
ليست لأولئك الذين يُساقون في حافلاتٍ واهنة،
ولا لمن يركنون سياراتِهم على عجل،
ولا لأولئك الذين اعتادوا المرورَ بجوارِ الموتِ دون أن يُحرّكَ فيهم ساكنًا.
الرؤية..
هي حكرٌ على من عبروا الزجاجَ نحوَ الضوء،
ولم يعودوا.
لمن يقرأونَ السماءَ من الجهةِ الأخرى من الضباب.
يتحرّكُ الباصُ مجددًا،
وأنا أتركُ خلفي وجوهًا تزدادُ وضوحًا كلما ابتعدتُ،
كأنما الموتُ وحدهُ يمنحُهم حياةً لا تنتهي.
تتكدرُ في حلقي شوكةٌ تُفتّت أنفاسي، وأتساءل:
لماذا نستطيعُ رؤيتهم بهذا الوضوحِ فقط حين يصيرونَ صورًا؟
لماذا تتحوّل ابتساماتُهم إلى ذنبٍ يحزُّ أعناقنا؟
لماذا تصبح نظراتُهم بريئةً وطاهرة؟
يا الله..
كيف صار الشهداءُ يشبهونَ الوطنَ أكثرَ منّا؟
وكيف صرنا نحن أشبهَ بالغبار..
نعبرُ فوق جراحِ الأرضِ ولا نلوي على شيء.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .