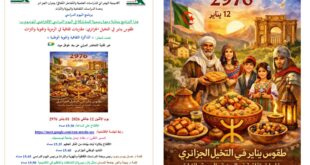قراءة أدبية في نص “أسطورة الطيور المأسورة” للأديبة رانية مرجية ، بقلم : الناقد عادل جودة
أسطورة الطيور المأسورة: حين يغنّي الأسرى أقوى من الحديد
بقلم: رانية مرجية
مقدمة
ليست الحكاية هنا عن أقفاص وسجّانين فقط، بل عن الحرية التي تأبى الانكسار، وعن أرواح تحوّلت إلى رموز كونية للكرامة الإنسانية. في هذه القصة الرمزية، تتحول معاناة الأسرى الفلسطينيين إلى أسطورة تُروى، وتصبح أغانيهم جرسًا يوقظ الضمير البشري أينما كان.
النص
تحكي الأرض، وهي الجدة العتيقة التي لا تهرم، أن في قلبها واديًا عجيبًا اسمه وادي الصدى.
هناك، أقام الغزاة أقفاصًا من حديد أسود، ظانّين أن بإمكانهم أن يُسكتوا الطيور التي غنّت منذ أول فجرٍ عن الحرية.
لكن تلك الطيور لم تكن عادية؛ كانت أبناء الزيتون والبرتقال، ريشها مطرز بنداءات الأمهات، وعيونها تحمل وهج الشهداء.
كلما ضاق القفص، اتسعت صدورهم، وكلما سُلبت الأجنحة، ارتفعت الأغاني.
سأل الحراس بازدراء:
– ما فائدة الغناء خلف القضبان؟
فأجاب الجبل عنهم بصدى مدوٍّ:
– إن الأغاني تتحول إلى أنهار، والأنهار تذيب الحديد.
وفي الليل، حين يظن السجّان أن النوم قد أطفأ الأحلام، كانت الطيور ترسم بأظافرها نقوش العودة على الجدران: خريطة للديار، ومفاتيح للأبواب، وجملة واحدة لا تزول:
“الحرية قدر.”
تعاقبت الأجيال، وتكسرت أقفاص كثيرة، لكن الطيور ظلّت تغنّي. وحين سُئل الجبل:
– متى تنتهي الحكاية؟
أجاب:
– حين يفهم آخر طفل أن هذه الطيور ليست سجينة، بل حارسة للنور.
ومنذ ذلك اليوم، يروي الناس أن كل قفص في وادي الصدى لم يكن مقبرة، بل منارة،
وأن أصوات الأسرى لم تكن مجرد أناشيد، بل جرس الحرية الذي لا يخفت،
بل يوقظ القرى، ويعيد للسماء لونها الأول.
١- البنية الرمزية وعمق الدلالة:
يحوّل النص معاناة الأسرى الفلسطينيين إلى أسطورة كونية عبر شبكة من الرموز المتقنة:
- الطيور:
تجسيد للأسرى الذين يحملون في هويتهم جذور الأرض (أبناء الزيتون والبرتقال) ويرفضون الاستسلام رغم القمع.
– القفص الحديدي:
ليس مجرد سجن مادي، بل رمز لمحاولات طمس الهوية وكسر الإرادة لكنه يفشل أمام “اتساع الصدور” و”ارتفاع الأغاني”.
– وادي الصدى:
مكان أسطوري يحوّل المعاناة إلى صدىً دائم، كأن الأرض نفسها تروي القصة وتضخّم صوت المظلوم.
– الجبال والأنهار:
قوى طبيعية تتدخل كحلفاء للطيور، مؤكدة أن القوة الناعمة (الغناء) قادرة على تآكل أعتى السجون.
٢-اللغة الشعرية وتكثيف المشهد:
تستخدم الكاتبة لغةً مجازيةً غنيةً تُحيط القارئ بالصور الحسية:
- التناقض الدرامي:
”كلما ضاق القفص، اتسعت صدورهم” – يُظهر انتصار الروح على المادة.
- التجسيد: الجبل الذي يُجيب، والأغاني التي تتحول إلى أنهار، مما يخلق عالمًا سحريًا يُضفي شرعيةً على المقاومة.
- التكرار الرمزي: جملة “الحرية قدر” المنحوتة على الجدران تُذكّر بثبات الحق رغم الزمن.
٣-البعد الفلسفي والأسئلة الوجودية:
النص يطرح أسئلةً جوهريةً عبر حوارات مختزلة لكنها عميقة:
- سؤال الحرّاس:
“ما فائدة الغناء؟” يعكس منطق القوة الذي لا يفهم أن الفن مقاومة.
- إجابة الجبل:
“الأنهار تذيب الحديد” تُجسّد فكرة أن الزمن لصالح المضطهدين حين يحوّلون آلامهم إلى إبداع.
- نهاية الأسطورة تُعلن أن الطيور “حارسة للنور” أي أن نضالهم ليس دفاعًا عن أنفسهم فحسب، بل عن إنسانية العالم كله.
٤- الإيقاع والسرد الأسطوري:
يُبنى النص على إيقاعٍ يشبه الترانيم القديمة عبر جمل قصيرة مُفعمة بالرمز (مثل: “الحرية قدر” “الطيور حارسة النور”).
هذا يمنحه طابعًا تأمليًا أقرب إلى النصوص المقدسة أو الملاحم الشعبية مما يعمّق تأثيره ويجعله قابلاً للتداول كـ”شهادة أدبية” خالدة.
٥- الخاتمة:
تحويل المأساة إلى منارة
الانزياح الأبرز في النص هو تحويل دلالة السجن من مكان للقهر إلى “منارة” – أي مصدر إشعاع.
هنا تكمن قوة الأدب في قلب المعادلات:
فالأغاني ليست تعويضًا عن الحرية بل سلاحًا يُحرر الآخرين عبر إيقاظ الضمير (يعيد للسماء لونها الأول).
يستحق هذا النص النشر؟
- لأنه يُترجم المعاناة الفلسطينية إلى لغة عالمية (الأسطورة) تتخطى السياسي المباشر لتصل إلى الإنساني الكوني.
- لأنه يمنح الألم معنىً جماليًا يُضاهي قصص المقاومة الخالدة (كأسطورة بروميثيوس أو سيزيف).
- لأنه يذكّرنا أن الأدب حين يكون شاهدًا يصير فعل مقاومةٍ بحد ذاته.
إنه نصٌ يُعيد تعريف القوة: فالأغاني هنا “أقوى من الحديد” لأنها تُخلّد ما يحاول السجّان محوه.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .